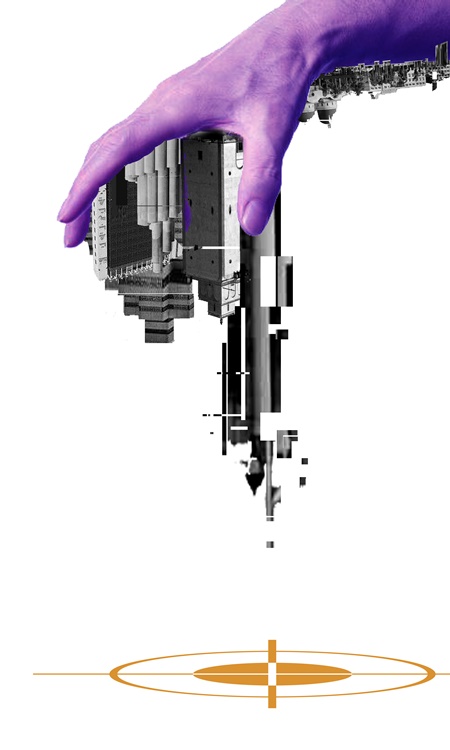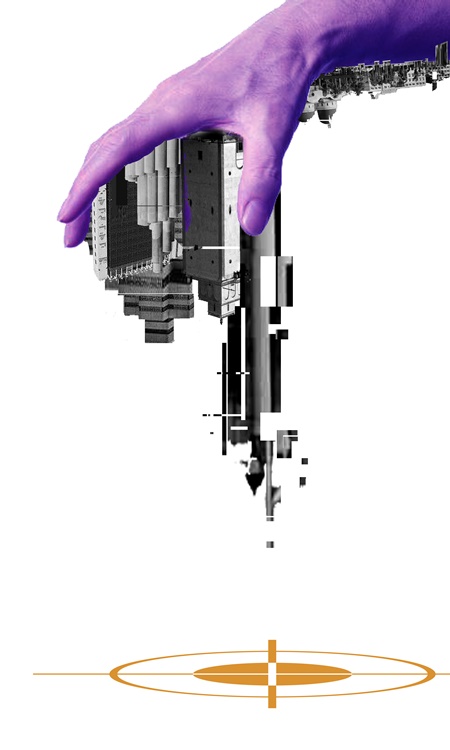
أدرت خريف 1992 أمسية شعرية حال إرجاعي بعد إقامة ستة أشهر متوترة من ألمانيا. تواقت ذلك مع تأسيس جمعية الثقافة والبيئة فاحتفلت في مدينة صبراتة الأثرية على ساحل المتوسط التي أرفقت إشهارها بالاحتفاء بأوبة الشاعر الراحل جيلاني طريبشان بعد طول اغتراب في منافٍ عربية وأوروبية. قبيل سفري يناير 1992 كنت قد قرأت بالصدفة قصائد للشاعر عمرالكدِّي على عدّ أصابع اليّد شدّتني منها قصيدة مرثية النفط المنشورة ـ أبريل 1991 ـ في مجلة الفصول الأربعة.
فكانت التابعة التي أرفقها الشاعر بي فخبأتها في حقيبة ترحالي المُنتوى لدراسة الفلسفة في ألمانيا. فكان الكدّي وأصوله تعود إلى بلدة في جبل غريان كصغيّر قبيلة العجيلات الذي قطع تابعة نثر النفط ليكتب في متنه نَصّ الشعر .
افترضت المرثية أن تكون التابعة تلحق أربعينية الموت، وقصدها ذكر محاسن الميّت. والذي يموت في القصيدة هو النفط بمحاسنه ومساوئه، ثروة مفاجئة تغيرنمط المعاش البشري من الكفاف الأدنى إلى الاستهلاك الأقصى، والنموذج الذي استثنيت منه ليبيا هو بلدان الخليج العربي.
واعتمدت في ذلك مصدراً طبيعيا، مهما طال عمره، هو في جوهره طفرة سائرة حتماً إلى نضوب. السؤال كيف نضيّق من فجوة مانوية هذه القضية: ونعني طفرة النفط، ونضوبه، بل تلاشيه، التي يتداخل فيها الاقتصادي، أو بالأحرى المعاشي، بالمجتمعي وتعبيره السياسي سياق يشتغل فيه الشعر ليس فقط كما بيّن “الشكلانيون” صورياً بالإيحاءات، والرمزيات، والكنايات، والاستعارات، وليس كما بين “البنيويون” بالإزاحات والتناصّات، والخروقات؛ بل، وهو مايهمنا هنا، في إعادة ترتيب العلامات التي يُظهرها مبتدأ القصيدة: “فاجأنا النفط في منتصف القرن / وكان القارُ دواء الجرب”.
وختامها… “لعلنا غذاً حين نمر بالآبار وقد نفد نفطها/ سنقف وننشد :في ذكرى حبيب ومنزل/ بينما تمر الإبل خلفنا، ولا من يُزيل جربها”. فنظهر العلامة بعد إزاحة التناص الوحيد مع مفتتح قصيدة الجاهلي إمرئ القيس”قفا نبكِ”، ونترصد بالعلامية ـ السميائية في قصيدة “مرثية النفط”، علامة مغايرة للعلامة التي ترصدناها في مقالتنا السابقة المنشورة في مكان آخر “تحذير إلى القارئ” في درس شعر الكدِّي عبر نصوصه كـ “رحلة سمك السلمون” أو “أن تكون شاعرا” أو”أرى مالا ترون”. بالإضافة إلى صيغها العروضية، وتشطير أبياتها تقدم القصيدة نفسها بقرائن قليلة تدل على إمكانية انطوائها على قصيدة تفعيلة.
وإن توخت في مقطعين تفعيلة واحدة تتعمّل التكرار عدة مرات بين الأشطر، يمكن تسميتها بالحافّة، ولكنها لاتعيق تدفق القصيدة أن تصبح أقرب إلى تقرير وصفي، مستعجل لتغطية تاريخية لمسار أحداث مرّت متعاقبة : “سيودعنا النفط مثلما فاجأنا، وكأنه مطرٌ على الصحراء مر/ فأنخنا به ثم استرحنا / ونعود للرمال نشكو لها الظمأ”. ولم يُختتم المقطع الأخير، بكلمة جُرعة جرياً على القافية التائية التي ختم أو قفل بها المقاطع السابقة بكلمات كـ: نجمة، أزقة، شرطة، نكتة، ووصوف كـ: حلوة، هرمة، مجمّدة، مستجدّة، مُكتظة،ومُزدحمة. كما تنتهي القصيدة بتجاوزاتها القواعدية “الكلمات المضمرة، والجمل اللاهثة” أن تكون أقرب إلى قصيدة النثر .وحتى يتم بشكل ما التفكُّر بصوتٍ عالٍ في مرثية النفط، تنأى القصيدة بنفسها عن الانحرافات الواضحة التخطيط على النحو الذي تتبينه البنيويات الشعرية، بأن يستعمل الشاعر بين حين وآخر لغة غنية بصور الاستعارات والكنايات، حتى يبتعد قليلاً عن النثر. غير أن القصيدة تخلو، لحسن الحظ، من الاستعارة والتشبيه، وتستمد شاعريتها من سردية أنظمة تعاقبيها: الدلالي، والتداولي.
يساعدنا أن نتعقب المسارين الدلالي، والتداولي في نص مرثية النفط،لأننا عشنا سرديته. فلانتلّقاه بكسل، فنستهلكة كانطباع غامض، بل نشارك مشاركة فعّالة في إنشاء معناه وتوضيح نظام تشفيره علاماتياً أو سيميائيا. فحتى منتصف القرن /كان القارُ دواء الجرب. وبعد منتصف القرن لم يعُد النفطُ قاراً خاماً، بل صار إسفلتا تُرصف به شوارع المدينة: بالنفط نحن من غلّف شوارعها المُتربة/ ونحن من مسح التُراب كل صباح عن أسفلتها.
والجمل الذي كنا نداوي جربه بالقار، وربما على جلده نكوي به سمته، فنعلّمه بعلامة العشيرة أو القبيلة، صار مدحلة وسيارة بعلامات الدولة وأرقامها نسوّي ونرصف بها الشوارع، ومن خزّانها نرّش القطران فنصيّره إسفلتاً.. نحن من كُنا رعاة: “وانحدرنا.. حفاة كسيل الشتاء، نحو المدن المُكتظة/ نحاصرها بالصفيح ونشٌقّها بالأزقة/ نغازل خبزها الحافي جنوداً وعمالاً وشرطة/ ونمضي نحو المواني لنفرغ عاهاتها المستجدّة …”.

يتجاوز النقد المجتمعي في “مرثية النفط”المَسخري comic” وهو تحويل الكائن أو الواقع موضوعاً للسخرية، عبر التَهَكُّمِيّ ironique أو السخري اللوذعي، وينتهي إلى “الهجوي satiric ” أو القدحى، الذي يُضمر شحنة فكرية زائدة عنهما. وهو جائز لكونه أقل ارتباطا في الذهن بـ التنكير وهو ما تشترطه جديّة النقد. ونقرأ في المقاطع التقليلية أو التنقيصية في سردية من انحدر بهم النفط .. “حفاة كسيل الشتاء، نحو المدن المُكتظة” استمرار تدفّق الجمل الواصفة: وفي مساء حاناتها الساخنة،، نُبادل بآخر العرق،، جُرعة خمرٍ ونكتة/ وفي الليل نحرسها منها ومنا،، ولفحولتنا الريفية ،، نتحايل بقروش الأعياد على مباغيها المُزدحمة/ وحين نرجع إلى حيث الحقول،،عارية ومُسهدة،مُحملين بالعلب،،المملّحة والحلوة/ نتبختر فوق ضحك السهول،، بالسراويل الضيّقة/ . في المقطع التالي تتبدّل القافية فينقطع تواصل الهجاء بتقريريته السردية. الانقطاع يحدث بدخول استعارة مركّبة يسميها البنيويون إزاحة على الشطر/ فاجأنا النفط،، فانحدرنا وتجاوزنا الروابي/ بـ/ نمضغ كعك المُدن بلعاب البوادي/ .
المنزع التنقيصي أو التقليلي في سردية “مرثية النفط” شمل أساساً تعاطي الدولة والمجتمع مع طفرة النفط ، وهو يومئ إلى الظاهرة الاجتماعية التي سادت ليبيا منتصف الستينيات من القرن الـ 20 أي اقتلاع اليّد العاملة الريفية وتوّجهها إلى المدينة، واندراجها في وظائف وأعمال خدمية، غذت هامشية اقتصاد الخدمات على حساب اقتصاد الإنتاج بما يُفاقم النزوع المجتمعي إلى الاستهلاك. إلا أن قصيدة “مرثية النفط” تتجاوز حنين الذاكرة وترصد تحولاً في توّجه النظام السياسي، الذي استعمل البداوة في خطابه الراديكالي الموّجه ضد المدينية والحضرية في الداخل ابتداءً من المحاولة الانقلابية المفشّلة أغسطس 1975التي قادها ضباط من التنظيم جُلّهم حضريون، وضد مأطلق عليها الهجمة الإمبريالية الغربية من الخارج وهو خطاب أبهظ ليبيا لعشرية كاملة بالمتاعب والإرهاقات حتى الغارة الأمريكية أبريل 1986على مقرّ القيادة السياسية بثكنة باب العزيزية بالعاصمة طرابلس. تراجع الخطاب وركونه للتهدئة يرصده هذا المقطع : /هانحن كبرنا الآن،، وغادرنا المضارب / لكن القبائل التي أنجبتنا،، ظلت تطاردنا وتمنحنا المناصب / لنبني مجدها الجاهلي، ونرتق عزها الحجري، بأصابع الوطن/
بيّنت القراءة التي قمنا بها هنا أن هذه القصيدة الانطباعية بوضوح تحتوي على درجة قصوى ما يستدعيه ريفاتير تعبيراً من المعمارية التاريخية الموصوفة بـ “الفخامة والأبهة والضخامة monumentality “، وهو يعني ضرورة انتقاء كلمات القصيدة ونظمها نظماً محسوباً لإعطائها ديمومة ضرورة تربط النص الشعري والشفرات التي يتطلّبها تأويله في شبكة اتصالية معقّدة. تخاطب العظمة التاريخية، التي يدشّنها المقطع الافتتاحي: وكنا قد اخترنا للبلاد علما،،أحمر كدماء الأجداد،، كشقائق النُعمان ولون الشفق/ أخضر كطفولة الربيع،، وآخر الأحلام ولون السحب/ وسواداً هوى فيه من السماء،، هلالٌ ونجمةُ / وكتبنا نشيد البلاد،، يبدأ بالمليك،، وينتهي بالمُفدى/.
أذكر أني عندما جاء دور الشاعر عمر الكدّي لأقدّمه للحضور في أمسية جمعية الثقافة والبيئة بصبراتة. وصفته بشاعر مرثية النفط ، وأنه يفكر في الشعر إذ يكتب فيه قصيدته. أتمنى أن يكون مقالي قد أشبع تقديمي المقتضب عام 1992بتحليل علاميات النفط في الشعر .