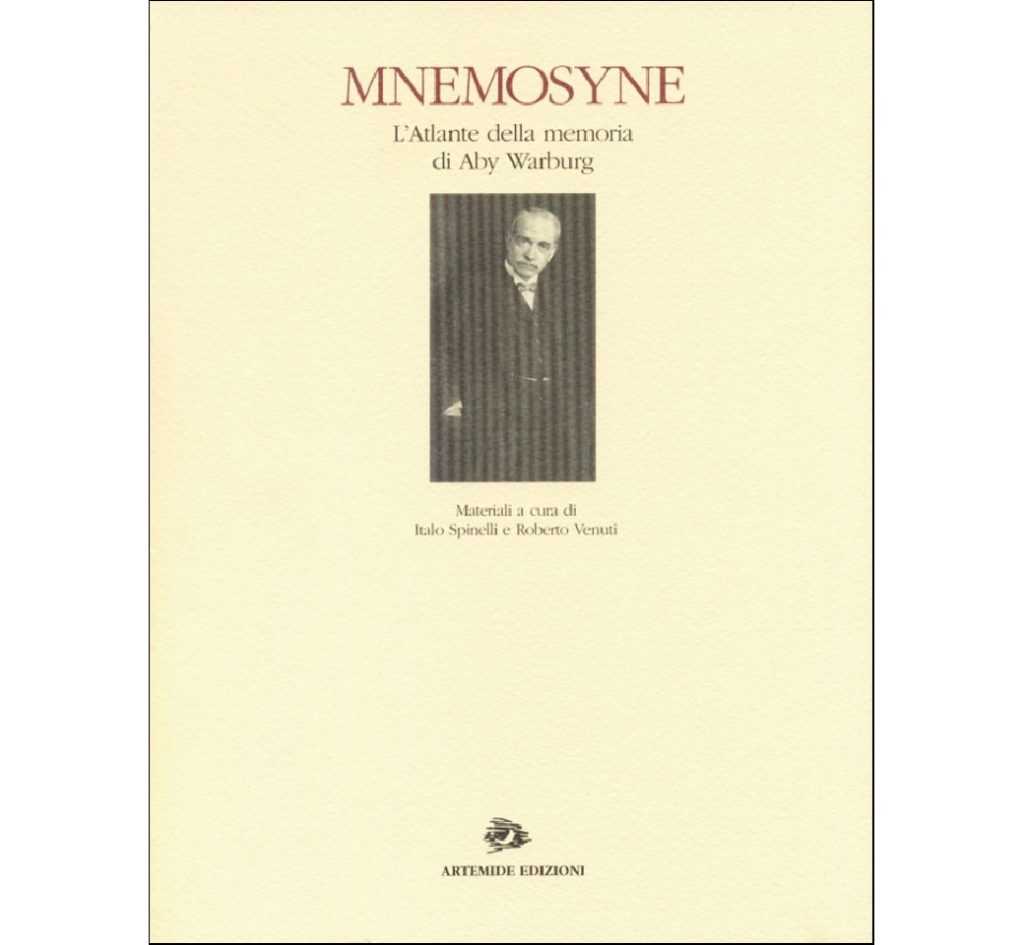فرنشيسكو كوريّجا * | ترجمة: أحمد الغماري
بالرغم من أنها صامتة على الدوام، إلا أن الصورة تبدو إنها تقول أشياء كثيرة تدور في هذا العالم، كما لو أنها كائن تم استدعاءه من كوكب آخر للمساعدة. ففي النقاشات الفلسفية حول الفن ذو النزعة التحليلية عادة ما تسمى بـ iconic turn أي (الانعطاف الإيقوني لتمييزها عن الانعطاف اللغوي linguistic turn) وهي نظرية تسعى لتطوير منهج جديد لمقاربة الصورة. وفي هذا السياق، فإن تأويل الصورة يكمن في ربطها باستمرار مع غيرها من الصور. فحسب ما كتبه غوتفريد بوهم1 في كتابه (عودة الصورة) فإن الانعطاف الإيقوني لا يتطور بالشكل الذي تتطور به اللسانيات عامة، إنما بشكل توافقي، لتفكير تأويلي يتصدى للنواحي النظرية والتاريخية أو الأنثروبولوجية للصورة. أما بالنسبة للانعطاف الإيقوني على مختلف الصُعد فإن بوهم يرى أنه حدث منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما تم دمجُ الصورة والكلمة معاً في ذات النموذج التوضيحي. بالطبع فإن الأمر يتعلق بمنظور جديد، خلافاً لذلك التقليدي، الذي كان ينظر من خلاله إلى الصورة باعتبارها شيء خادع ووضيع، من قبل أصحاب المعرفة الرصينة والجادة.
تحوز هذه النظريات الآن على مساحة من التقصي الذي لا يتوافق فقط مع التوجه الفلسفي للوغوس الذي رفض – ومنذ أمدٍ بعيد – إعطاء الصورة، الاهتمام ذاته الذي أعطاه للسانيات، إنما مع قدرتها “الاستعارية التي لا يمكن اغفالها” والتي قدمت تغييراً في النموذج للنظم جلها التي لديها علاقة بعملية النظر ونحوها من دراسات للثقافة البصرية (visual culture studies)، هكذا كما سميت على خطى الدراسات الثقافية الأنجلوساكسونية، التي كان همّها منصباً على دراسة الثقافة البصرية، لتصبح بعدئذ حجر الزاوية لفهم الفن وأبعاده. وكان أول من استخدم هذا المصطلح هي سفيتلانا البرس2 سنة 1972، لتشير إلى مقاربة لتحليلِ الأعمال الفنية، ليست فقط بمعناها الشكلي ومن وجهة نظر الظروف التاريخية التي أثرت فيها، إنما أيضاً بالنظر إلى الثقافة التي كانت تحيط بها.
إذن لكي نتحدث عن الثقافة البصرية ينبغي أن نترك النظرة الوضعية للتاريخ، وللإدراك البصري وللجماليات باعتبارها علوم تتعلق بما هو حسي وجمالي، وأن نأخذ في التفكير في النظر باعتباره ممارسة واقعيّة للتأويل، الذي تعدُ الصورة، سواء أكانت (لوحة أو فوتوغرافاً) هي فقط جزءاً من مكوناته المتعددة.
بالرغم من أن الانعطاف الإيقوني العارفِ بالصورة في منظوره التحقيبي، يبدو بسيطاً، إلا أنه يظهر غنياً بالمفاجآت على مستوى استراتيجية التأويل التي تصل إلى الرؤية وإلى تمييز المواضيع النقدية أيضاً، وتَحَمُلِ أعباء مسؤولية جديدة فيما يتعلق ببعض الانحرافات وسيطرة الرؤية ذاتها، نظراً لسطوتها في المجتمع المعاصر. ومن المفترض أيضاً معرفة إلى أي مدى يمكن للدراسات الثقافية البصرية اليوم أن تكون قادرة على خلق روابط ذات معانٍ، أي ما وراء النص ليتقاطع مع نظم أخرى كفلسفة الجمال، وفلسفة العقل والعلوم المعرفية وتاريخ الفن والسيمايئية. فالسيميائية لولا هذه الدراسات ما كان لها أبداً أن تنبثق من تحت الرماد.
فمقاربة الدراسات البصرية لأبعاد الفن ليست بالجديدة، سيما عندما يقوم بها مؤرخون للفن، مشهود لهم وبدراساتهم لفنون القرون الوسطى وتقاليدها، يكفي أن نذكر هنا أطلس الصور لصاحبه أبي واربورغ3، الذي صدر سنة 1929 تحت عنوان (Mnemosyne). يتكون ذلك الأطلس من مجموعة لوحات، تم تركيبها بواسطة مونتاج فوتوغرافي يتضمن نسخ من أعمال مختلفة، هي شواهد تعود – في المقام الأول – إلى عصر النهضة لـ(أعمال فنية وصفحات من مخطوطات، وألعاب ورقية) وصور للقُى أثرية من الشرق القديم، الإغريقي والروماني، وأخرى شاهدة على ثقافة القرن العشرين لـ(قصاصات من جرائد ومطويات دعائية وطوابع بريدية). فواربورغ يرى أن تتبع تاريخ صورة وإعادة صياغتها يعني – في المقام الأول – إدراكاً للتتابع الزمني، الذي يقصد به التحقيب الزمني. فالصورة كانت دائماً ما تستدعي الماضي إلى الحاضر، أي بمعنى آخر كالشيء الذي يُجَذّرُ لماضيه لحظة ظهوره (الصورة الديالكتيكية لوالتر بنيامين4).
ليس من المستغرب أن هذه الدراسات قد احتوت على صور مختلفة دون أن تكتفي بصور لأعمال فنية فقط. فمنذ فترة ليست بالقصيرة والفنانون المحدثون يستخدمون صور لأشياء ذات علاقة بأخبارٍ للأحداث محليّة وغيرها دعائيّة، على أسطح أعمالهم الفنية، في عملية إدماجٍ تامٍ لها مع وسائط الرسم التقليدية (يكفي أن نشير إلى التكعيبيين والدادائيين). فجميع المواد ذات الاستخدام اليومي، التي ظهرت – بشكل ما – كـ(جمليات مبتذلة) جديدة، كانت قد جُرّدت من محتواها الأصلي لتصبح جزءاً من أعمال فنية، أو في أحياناً كثيرة، لكي تتحول إلى أعمال فنية قائمة بذاتها. قد تم تضمين الممارسات اليومية إلى أعمال فنية في عملية دمجٍ تام، ليس فقط مع الممارسات اليومية، لكن أيضاً مع كل الأشياء. ففي تيار فلوكسس5، على سبيل المثال، فإن الفن والممارسات اليومية في الحياة، ليست فقط قد اندمجتا معاُ، بل إنهما قد استبدلا كيانهما بالصورة. ويبقى في جوهر هذه الأعمال أنها قد حافظت على تميز الفن الأصيل؛ أي من فنٍ ينظر إلى العالم إلى فنٍ يصفه ويحلله ويثير حوله التساؤلات، دون أن يستغنى عن الكلمة.
ومع ذلك فإن الانعطاف الايقوني بالنظر إلى المنطق التحديثي للأثر الإبداعي يبدو أنه لا يخلو من عواقب، لاسيما فيما يتعلق بنظرية الدلالة التي لا تستبعد الصدق في جوانبها – تحديداً – الأخلاقية والانطولوجية، ناهيك عن المعرفية. ويبدو أن أهمية الصورة اليوم تأتي في المقام الأول بالنظر إلى الثقافة العليا للفن أو لقوة تمثيلها للثقافة النبيلة، كما أكدنا على هذا الأمر في السابق، ويبدو لي أنه قد بات أمراً راسخاً. حقاً فإن المقاربة السيميائية لنظرية موحدة قادرة أن ترى الأشياء المتعلقة بالفن من زاويا، العلامة والايقونة وما وراء النص، سوف تمثل في عقد السبعينيات فرصة ومحاولة للخروج من جفاف ومن هيمنة ثقافة قوية، موسومة باللسانيات وبثقافة بصرية خانعة للكلمة وللتعبير.
حتى ولو أنه لا يبدو لي أن الدراسات الأخيرة حول الثقافة البصرية (وهنا نُذَكْرُ بما كتب دبليو ميتشيل6 في كتابه الانعطاف التصويري، مقالات حول الثقافة البصرية) تستطيع بطريقة قاطعة أن تستغني عن اللغة وعن الحوار وعن تبعات التصرف الأخلاقي، ما يعني أن الأمر يستحق أن نفهم الأهمية التي يأخذها هذا الانعطاف على عاتقه، فيما يتعلق، سواء بالعلوم المعرفية والدراسات حول المخيلة أو سواء فيما يتعلق بفهم الفن المعاصر بكل أشكاله وحدوده الانثروبولوجية والنقدية.
أما الانعطاف التصويري بالنسبة لميشيل ليس هو فقط الانعطاف الايقوني بالنظر إلى النظريات التي تعول على اللسانيات لتأويل العلامات الشفاهية أو حتى البصرية. بالنسبة لميشيل فإن الصورة هي التي يمكن فصلها عن هيئتها الأصلية، ونقلها إلى سطح آخر، وبواسطة وسيلة أخرى. هي نوعاً من الملكية الفكرية. لأن الصورة ما هي إلا نتاج لقاء بين الهيئة والسطح، إنها تمظهر لهيئة غير مادية على وسيطٍ مادي. لذا كتب ميشيل يقول “نستطيع التحدث حول الصور المعمارية أو النحتية أو السينمائية والنصية أو حتى الذهنية دون أن ننسى إن تلك الصور التي التقطت لها أو كانت حول هذه المواضيع لم تكن في الأساس هي التي قد أنشأتها.”
يبدو إن بحث ميشيل هذا يلتقي مع مقترح كيندال والتون8 الذي يتمحور عمله حول كشف العلاقة بين قضايا الفن النظرية والدراسات الفلسفية للعقل والميتافيزيقيا ولفلسفة اللغة. فهو يكتب فيما يخص المتفحص الذي ينظر في لوحةٍ كما لو أنها لعبة المحاكاة. فوالتون يسميها ألعاب المتخيلة، التخيل لـ…، التخيل لفعلُ شيء ما، أو لتمني شيء ما. بمعنى آخر من ينظر في لوحة فإنه يشارك بصرياً ولفظياً في لعبة المحاكاة التي تعمل فيها التشبيهات عمل الدعائم. باختصار فإن الدعائم، هي ما يسميه ميشيل بالصورة، أي الشيء الذي بحكم مبادئ التوالد، تصف التخيلات. لذا فإن العمل الفني التشبيهي ليس سوى نوعٍ من الواقع الوهمي، كما لو أنه عالمٍ للاعب، يتخيل من خلاله المشاهد، ويتمعن أيضاً في الواقع وفيما يقصده الفنان.
تؤدي الدراسات الحالية حول الثقافة البصرية دوراً – كان في الماضي مستحيلاً – فيما يتصل بعملية قراءة الأعمال الفنية. فالأمر يتعلق بالتصدي لمسألة تمثيل الواقع، ليس فقط من داخل منهجية مكرسة للتأريخ أو لأنطولوجيا الفن، إنما أيضاً ضمن آليات تدرك عملية إنتاج الصورة في حدِ ذاتها، وصولاً إلى الأدوات والتقنيات التي تستند إليها والتي تفضل تطبيقاتها. ومن هنا يصبح فن الرسم والتصوير جزءاً من مضمونٍ أوسع، لخارطة تجدُ فيها تلك الأدوات والتقنيات مكاناً، وتؤدي الموارد الثقافية بمختلف أنواعها والممارسات البصرية المتجسدة في (صور فوتوغرافية أو سينما أو فيديو وإلخ) دورها. حينئذ تصبح اللوحة في الثقافة البصرية غرضٍ يتداول داخل اقتصاد ينشأ عن مفاصل نظام العرض، من صور مؤثرة ومواضيع تنتجها الصور ذاتها.
ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن الصورة سواء كانت في المجال الوظيفي مثل (الرياضة أو العلم أو في الممارسات الدينية) أو في مجال الفن بمختلف مشاربه، ليست نسخة من الواقع، إنما هي كائن حي قائم بذاته يحظى بإمكانات بلاغية ودلالية. تحديداً فيما يتعلق بوظيفة تنسيبها للأشياء، فهي قادرة على ممارسة وساطة في التفاعل الاجتماعي، عاملة كبنى للعلائق التي تنظم التبادل واللقاءات بين البشر، وبهذا المعنى فهي قادرة على التفسير وعلى إعادة وصف العالم الذي نعيش فيه.
في رأينا فإنه ينبغي إيجاد تحالف جديد، لفظي – ايقوني (هنا نشير إلى ما كتبه والتر. جي. أونغ9 في كتابه الشفهية والكتابة) هذا التحالف يستطيع أن يربط بطريقة جدلية تاريخ الإنسانية في تطوره من الشفاهية إلى التدوين، بعلم الأنساب من خلال ثقافة الصورة. ينبغي التصدي لهذا المنظور في إطار ضوابط التمثيل الذي يتضمن أيضاً مشروعاً عاماً للعلامات (في جوهر نظرية السيميائية للعواطف) القادرة على تطوير مقاربات نقدية وتحليلية وبالتالي شفاهية حول المسائل البصرية لتسليط الضوء على الطريقة التي تستمر بها الصورة في توصيف حياتنا – بخيرها وشرها – وطريقتنا في تخيل العالم.
لا يتعلق الأمر هنا بقراءة الصورة بمقاييس قراءة النصوص الشفاهية، على العكس من ذلك تماماً، بل إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن كلاهما: الصورة واللغة، البصر والتلفظ، هما حاملان لمعانٍ ولدلالات، ولهذه الأسباب فإنهما تستطيعان أن تتلاءما مع أنساق الدلالات لمقاربات نقدية وتحليلية. فاللوحة لم تعد تصويراً فقط، ولكنها أضحت نظاماً نصياً، وفي هذا السياق، باتت موضوعاً ثقافياً، محكوماً بآليات بصرية محددة. إنها البصرية التي تطرح عندئذ كفعل يحول المادة التشكيلية إلى ممارسة ذات دلالة، داخل عملية لا نهاية لها أبداً.
يمكن للصورة أن تقرأ بشكل جيد كما لو أنها نص إيقوني ينتمي إلى نوعٍ خاص من العلامات التي تشير إلى مضامين وعوالم من المعاني، التي لديها مع الأفعال اللغوية10 ولاسيما مع السيميائية علاقة، بشكل أو بآخر. في نهاية الأمر فعقب رؤية صورة من الصور، سيكون من المفترض أن يتم الحديث حولها دائماً، أو عندما يتم شرحها، يقال، ينبغي دائماً الإشارة إلى صور أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن المفترض أن نعرف كيف نميز المكانة – سواء بالنسبة للصورة أو للكلمة – التي تنتظر عملهما، كمرآة لتعدد الرؤية والألفاظ وحتى الرغبات. فكلاهما يدعيان بضمهما ليس فقط للتاريخ أو للحقيقة ولكن أيضاً للايروسية؛ مشيران إلى أشياء ينبغي أن تُقال وأن تُرى وأن تُسمع وأن تُرغب وأن تتخيل، لربما لأنهما يكونان في مسيرة نحو شيء آخر، يخفيان الواقع، وأشياء لم يتم الإفصاح عنها، ربما لأنهما يقفان على ما هو غائب، ويكونان وراء ما يريدان إظهاره.
في الختام تبقى الصورة، بل سوف تتعدد، وسوف تتكاثر، ليس فقط على هيئة ألفاظ ولكن على وجه التحديد كأجساد للحياة، داعمة لعملية التخيل، الذي يجعلنا نفكر. منتظرة من الفن أن يجد شكلاً يجسد – بنهج تفاوضي – فضل الصورة إزاء الواقع.
نشر هذا المقال في صحيفة لاستامبا الإيطالية وأيضاً في موقعها الإلكتروني بتاريخ 30 يوليو 2012. وهذا الرابط للمقال باللغة الإيطالية: https://www.lastampa.it/blogs/2012/07/30/news/il-debito-delle-immagini-1.37171793/
* فرنشيسكو كوريّجا، مواليد 1950، وهو منظّر وفنان وأستاذاً لمادة الديكور، ولمادة مشكلات التعبير المعاصرة والكتابة الإبداعية في أكاديمية بريرا للفنون الجميلة بميلانو. من بين مؤلفاته كتاب: (فن المنفى، 1993 و اللوحة بالرغم من كل شيء، 2005، ومرة أخرى المعنى، 2007).
هوامش
(1)- غوتفريد بوهم، فيلسوف ومؤرخ للفن ألماني، ولد في 19 سبتمبر 1942.
(2)- سفيتلانا البرس، من مواليد 10 فبراير 1936، هي ناقدة ومؤرخة للفن أمريكية.
(3)- أبي موريتز واربورغ ويعرف بـ أبي واربورغ (13 يوليو 1866 – 26 أكتوبر 1929) هو مؤرخ فني ومنظر ثقافي ألماني. كانت جُل أبحاثة ومنشوراته تدور حول إرث العالم الكلاسيكي.(ويكيبيديا)
(4)- “الصورة الديالكتيكية” هو مصطلح جاء في دراسة للفيلسوف الألماني والتر بنيامين وعنونها بـ(العمل الفني في مرحلة اعادة انتاجه التقني)، يتطرق فيها لمسألة ظهور آلة، كـ(الكاميرا) والراديو والسينما، باعتبارها جعلت العمل الفني ينتشر ويتكاثر عن العمل الأصلي، ما أدى إلى الحديث عن تفرده ضرباً من العبث. وباتت”الهالة” التي يحدثها حوله مطفأة نظراً لاستنساخه. وبذا يرى بنيامين أن ما كان وما سيكون هو متكئاً على فكرة أساسية ثالثة هي “الصورة الديالكتيكية”، التي تستولد من الموضوع نقيضه، إذ سقوط الهالة فعل ديموقراطي يجمع بين البشر والمواضيع بلا حواجز، وإذ الفعل الديموقراطي مدخل الى “أزمة الفن الحديث”، حيث معايير السلعة تزيح معايير التحرر والفن جانباً. (المترجم)
(5)- فلوكسس – Fluxus، حركة فنية ضمت مجموعة من الفنانين والملحنين والمصممين المعروفين من عدة دول غربية أواسط القن العشرون. يخلط جميع من ضمتهم هذه الحركة الوسائط والتخصصات الفنية المختلفة من: فن الأداء إلى Neo-Dada والضوضاء مروراً بالفنون البصرية والتخطيط الحضري والهندسة المعمارية، صولاً إلى التصميم والأدب.
(6)- دبليو. جاي تي ميتشيل، مؤرخ لتاريخ الفن وأستاذ جامعي أمريكي، ولد في 24 مارس 1942.
(7)- كيندال لويس والتون (من مواليد 1939) فيلسوف أمريكي وأستاذ الفلسفة الفخري في جامعة ميشيغان. له كتاب بعنوان: Mimesis As Make Believe: On The Foundations of Prismation Arts يتمحور حول الأسئلة النظرية في الفنون وقضايا فلسفة العقل والميتافيزيقا وفلسفة اللغة، وفي كتابه هذا يطور نظرية التخيل ويستخدمها لفهم طبيعة وأنواع التمثيل في الفنون. (ويكيبيديا)
(8)- والتر. جي. أونغ. هو والتر جاكسون أونج (1912-2003) كان عالماً دينياً وأنثروبولوجياً أمريكياً وفيلسوفاً ومدرساً ومؤرخاً للثقافات والأديان.
(9) – الأفعال اللغوية هو مصطلح يستعمل في حقل اللسانيّات وفقه اللّغة. ويعود استعماله في العصر الحديث إلى الفيلسوف جون لانجشو أوستن، الّذي قدّم للنّظريّة من خلال بحوثه في الأفعال الأدائيّة، خصوصاً ما أورده من أن لكل فعل لغوي ثلاث خصائص هي (فعل دال، لفظي) و (فعل إنجازي، وظيفي) و (فعل تأثيري). (ويكيبيديا)