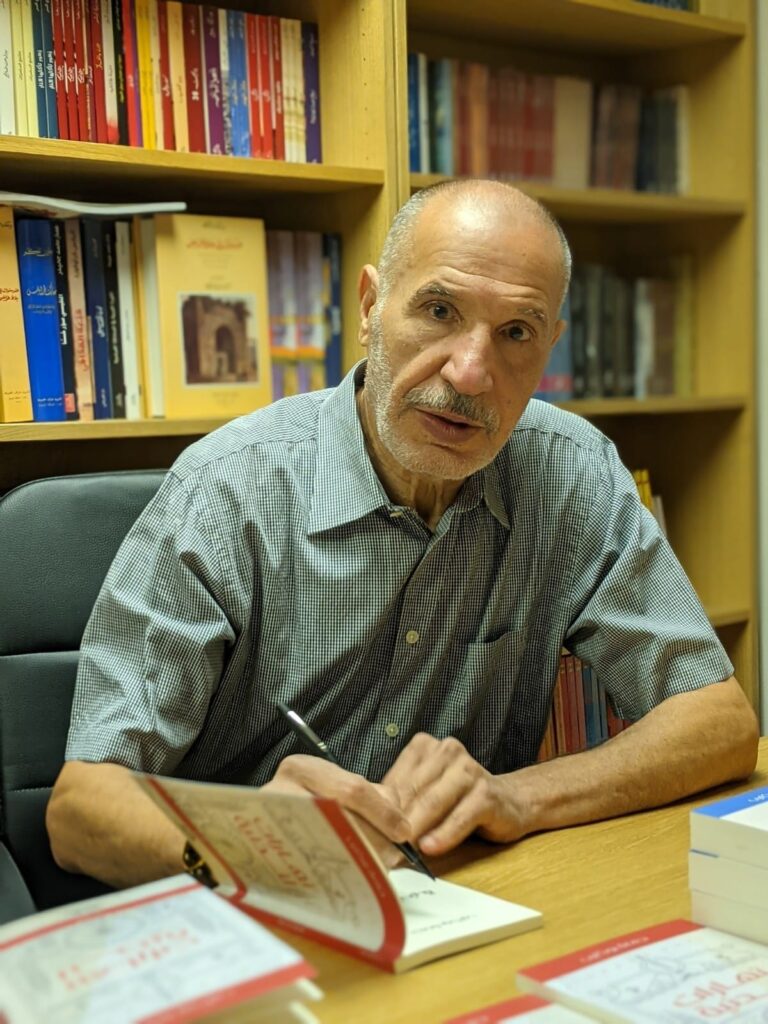حين أكملتُ رواية نهارات لندنية لجمعة بوكليب، مرت ببالي عمتي فاطمة بنت غنيوة، التي يوم سمعت أن عثمونه دياب عاد في إجازة دراسية من بريطانيا. جاءته مسرعة تسأله عن ولدها عبد السلام الذي يدرس في أميركا، كانت رحمها الله ورحمهم جميعاً، تتصور بريطانيا هي نفسها أميركا، وأن الذي يفصل عبد السلام عن عثمونه كا الذي يفصل سمنو عن الزيغن وتمنهنت، فقال لعمته: أن بيني وبين عبدالسلام؛ المحيط الأطلسي.
هي حتماً لا تعرف المحيط الأطلسي، غير أنها تصورته كما لو أنه الدهر، إلى حد ما راودتني خواطر مشابهة وشخوص الرواية يبرزون أمامي من داخل النهارات اللندنية وأنا أطوي صفحات الكتاب الشيق، صفحة بعد أخرى، وأقول في نفسي أنه عما قريب سيبرز أمامي عبد السلام عمارة وسالم الهمالي والسنوسي الطاهر وعثمونه دياب، الذين تزامن وجودهم طلبة يدرسون هناك، إلا أنني سرعان ما كنتُ أتذكر أن أحداث هذه الرواية بدأت بعد خروج السجناء في ليبيا 1988م، في وقت لم يبق من هؤلاء سوى سالم الهمالي.
غير أن اللافت في الرواية، أنه ثمة رواية أخرى متخيلة لم تبدأ بعد، وقد لا تبدأ أصلاً، وهنا الجديد حين يُفكر صاحبنا جدياً في كتابة رواية يضع لها تصوراً ومكاناً وزماناً، لنعيش معه ونتخيل شكل الفكرة التي صارت تتخلق في ذهنه. إثناء ذلك تبرز أسماء رائعة جداً كصديقته “حسيبة”، المرأة الجزائرية التي اعتقد من أول لقاء معها أنها ستكون زوجته في المستقبل، وحين عرف أنها متزوجة تصورها خليلته، ثم صديقته ثم أخته ثم أمه التي لا تخون أبداً، وبالنهاية قال عنها أن كل شيء اجتمع في شخصية “حسيبة” وسطوتها التي لا تقاوم، وتجلت تلك السطوة يوم أبقت زوجها الإنجليزي خارج المنزل ثلاثة أيام عقاباً له. إذ ذاك وهو مشدودٌ إلى حسيبة، وجد “سالي” التي لا يعرفها ولم يرها أبداً، حين استيقظ ذات صباح واكتشفها معه في شقته في لندن، سمع صوت شخص معه في الشقة، فنهض من فراشه ليجد حقيبة نسائية ملقاة قريباً منه في الغرفة، ورائحة قهوة تأتي من المطبخ، ووقع أقدام تتحرك في المكان، حاول أن يتذكر كيف ومن اين دخلت صاحبة هذه الحقيبة، طالعها من باب الغرفة الموارب تبدو بأوصاف كذا وكذا وهي تعطيه ظهرها وتقف تُعد قهوتها، دق رأسه بقبضة يده لعله يتذكر شيئاً عن ليلة البارحة، ولكن عبثًا كان يحاول.
أيضاً “فاطمة” البرتغالية المسيحية التي صادفها مع خطيبها “سعيد” في لندن، وكانت تدرس في مانشستر، سألها عن اسمها كيف جاء ولماذا أسموها فاطمة وهي مسيحية، فعرف أن أكبر كنيسة في شمال البرتغال اسمها كنيسة فاطمة، وأن فاطمة التي سموا عليها الكنيسة هي سيدة وقديسة فاضلة في التاريخ البرتغالي. إثناء ذلك وأنا أتوقف عند تلك القديسة التي أسمها فاطمة، حضرت ببالي عمتي فاطمة بنت غنيوة التي كانت تجلس في صدر الميعاد كما لو أنها شيخ قبيلة.
وكذا تتوالى أحداث نهارات لندنية بين يدي على الصفحات ،حين شدني وفاء وإخلاص سعيد في الراوية، كان له صديق في ليبيا اختفت زوجته وفرَّت بولديها من هناك وجاءت إلى بريطانيا، فتلقى سعيد مكالمة من صديقه يطالبه بالبحث عنها ومساعدته في استعادة ولديه منها. وعلى نحو شيق وأكثر مما أعرضه حين تبرز شخصيات وتختفي أخرى كانت فكرة الرواية المتخيلة ما زالت تتخلق في خلده، وكنتُ أنا أنتظر وأتوقع في كل صفحة بروز شخصية سالم الهمالي الذي صار طبيباً وجراحاً ماهراً في بريطانيا، وكنتُ أنتظر أن يمرض أحد شخوص رواية نهارات لندنية، فيجد نفسه ممدداً على سرير وفوقه سالم الهمالي بمشارطه، لكن ذلك للأسف لم يحدث لتمضي الأحداث، حين نتعرف على شخص نبيل أسمه “مجيد” ليبي، شخصية رائعة جداً، تعرَّف عليه صاحبنا في أول يوم وصل لندن وفي المطار، وتحديداً في مقصورة المدخنين، حين طلب منه ولاعة، وبسرعة تفاعلت كيمياء العلاقة بينهما، وأحس مجيد الشخص النبيل بواجب وطني يُشعِره أن هذا الليبي القادم من سجون ليبيا بحاجة إلى مساعدة، فأخذه معه في سيارته وأبقاه أسبوعاً في شقته ريثما يجد سكناً مناسباً، وفي هذا الأسبوع عرفنا الكثير عن مجيد، من بين ما عرفناه أنه كان عسكرياً في الجيش الليبي، وكان ذات مرة في الكتيبة التي تلقت أمراً باقتحام أسوار جامعة طرابلس وقمع التمرد الذي حصل داخلها، وما صار يُعرف بعدها بأحداث أبريل 1976م، ليكتشف سعيد أن اثنين من أقاربه كانوا على الجهة المقابلة له، ومع جملة الطلبة المناوئين للنظام.
وكذا تدور النهارات اللندنية في احدث شيقة تشدك وحتماً ستجعلك تتوقع مثلي أقارب وأصدقاء تعرفهم تزامن وجودهم في لندن وقد يفاجئونك بين الحين والآخر…