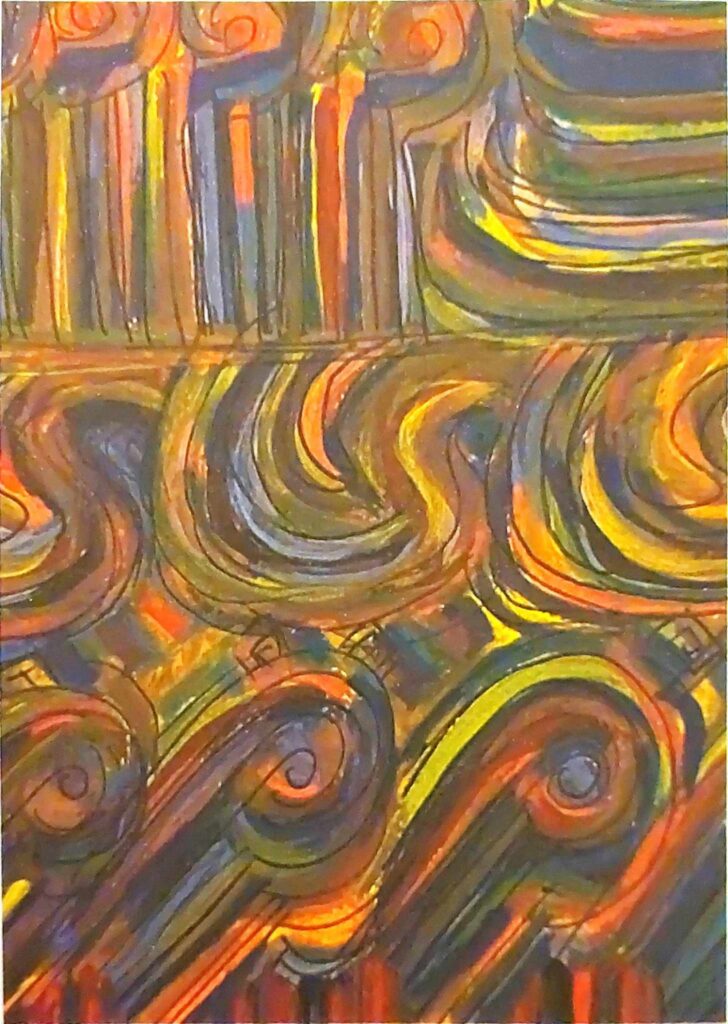الذكرى الثامنة لرحيل الكاتب والأديب الليبي كامل عراب
بقلم: كامل عراب
حتى وقت قريب ظل الأدباء والمثقفون والنقاد العرب لا يعرفون من شعراء تونس سوى أبي القاسم الشابي الذي أخذت شهرته تجوب الآفاق فتتردد قصائده على الألسنة وخاصة قصيدتيه (إرادة الحياة) و(صلوات في هيكل الحب) وقليلون فطنوا إلى محاضرته القيمة (الخيال الشعري عند العرب) فزاد ولعهم به وتقدیرهم له.
وحتى وقت قريب ايضاً ظل الأدباء والنقاد والمثقفون في تونس نفسها يتبرمون بهذا الموقف ويقبلونه على مضض على الرغم من اعتزازهم الكبير بالشابي الذي لا سبيل إلى نكران عبقريته أو جحود فضل ريادته للتجديد في الشعر في شمال افريقيا، ذلك لأنهم يرون أن ظل الشابي الذي يغطي مساحات واسعة حجب عن أنظار الناس كثيراً من الشعراء الموهوبين حتى كاد الأمر يصل إلى حد اتهام تونس بالعقم مع أن الحقيقة ليست كذلك.
وتحت تأثير هذه الظروف فقد اجتهد المثقفون في تونس الشقيقة في إزالة هذا اللبس وعملوا بدأب وحماس على تصحيح هذا الغموض بما قدموه من تآليف تعرف بالشعر في تونس وبمشاركاتهم الفعالة في محافل الأدب ومناسباته التي تقام بين الحين والآخر في شتى أنحاء الوطن العربي الكبير، ولقد أصابوا في هذا الاتجاه كثيراً من التوفيق والنجاح.
ولعل هذا الاحساس بالتبرم من ناحية أخرى ان يكون عاملا من عوامل الاجتهاد في تأكيد المواهب والنبوغ لدى أجيال الشعراء التي عاصرت الشابي وعاشت بعده أو تلك التي وفدت إلى ساحة الشعر عقب وفاته، وكثيراً ما تكون روح التحدي وسيطرتها على بعض المواهب عاملا من عوامل التألق والابداع واستيقاظ العبقرية.
ولعل هذا أن يكون هو السبب الأساسي – وليس الوحيد – الذي جعل أوساط المثقفين والأدباء تحتفي احتفاء بالغاً بكتاب الناقد المعروف الأستاذ أمين مازن (الشعر شهادة)(1)، إذ ها هو صوت من خارج تونس يتقدم للتعريف بالشعر في ذلك القطر العربي ويتوقف أمام عدد من الأصوات التي بلغت شأوا لا يستهان به في عالم الشعر متخطية تلك الحدود الاقليمية الضيقة ومرتبطة بحركة الأدب والفن في بقية أقطار الوطن الكبير ومتأثرة بواقع الأمة بكل ما فيه من انجابيات وسلبيات، وقد كانت تلك الأصوات (صورة أخرى للنموذج الثوري وفي الاتجاه القومي الذي يظل برغم كل صنوف الرفض التي يلقاها أينما حل به المقام فإنه لا يفقد تلك الهوية القومية، لأنه يراها باستمرار طوق النجاة الذي يمكن أن يلجأ إليه كلما هبت رياح الخماسين)(2).
قلنا قبل قليل بأن المهمة التي نهض بها هذا الكتاب في التعريف بالشعر العربي في تونس كانت سبباً أساسياً في الاحتفاء به كل هذه الحفاوة، ونضيف بأن هناك بالطبع أسباباً أخرى كثيرة حققت لهذا الكتاب مكانة بارزة في تيار النقد الحديث في منطقتنا العربية ومن أهمها ذلك المنهج الواقعي الواضح الذي يستخدمه الناقد في دراسته للتجربة الشعرية في تونس، ذلك المنهج الذي يؤسس على مدى ارتباط الشعر والشعراء والمبدعين بقضايا أوطانهم وما-ى تجاوبهم وانفعالهم بواقع الناس والحياة، وهو منهج يعول على المضمون الاجتماعي للأدب ولكنه بالرغم من ذلك منهج لا ينغلق داخل مقاييسه الخاصة فيهلل لكل ما يتفق معها ويعرض إذا صادف ما يخالف ذلك، وتلخص هذا الموقف تلك العبارة التي قالها الناقد وهو يتحدث عن شعر أحمد اللغماني: (ولكن إمكانية الشاعر أدت به إلى هذا الموقف، كما أن مفهوم المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها لا يمكنها أن تنتهي به إلا إلى هذا المطاف، ومن هنا فإن الخلاف معه لا يمنع من الإشادة بما تحقق له من النجاح)(3).
وأمين مازن هنا يتفق مع رواد النقد العربي المعاصر الذين يقولون بضرورة دراسة النص من داخله وتقييمه حسب شروط المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها المبدع لا المدرسة التي ينتمي إليها الناقد. وهذا الاتجاه لا يجرد الناقد من موقفه الخاص ولكنه يجعل أحكامه أكثر موضوعية ومرونة ويهيئ له في نفس الوقت ان يقول الرأي الذي يريد في مواضع أخرى.
وإذا قلنا فيما سبق بأن المنهج الذي ينتمي إليه الناقد هو منهج واقعي يعول على المضمون الاجتماعي للأدب فإننا نضيف إلى ذلك أن هذا المنهج لا يفصل الشكل عن المضمون بل يرى بأن المضمون الجيد يقتضي أيضاً شكلاً إبداعياً جيداً وأن سمو الفكرة في جميع الأحوال لا يبرر شكلا رئثً مهلهلاً يسيء إلى الظاهرة الشعرية ويصمها بالهبوط.
کیف یقدم الناقد نفسه منهجیاً؟ (ورغم أن النظرة النقدية التي انطلقت منها تقيم وزناً كبيراً لموقف الشاعر من حركة المجتمع إلا أن هذا الموقف قد وقع البحث عنه من خلال ما يقدم الشعر لا ما عرف عن الشاعر أو قبل عنه .. كما أن موقف الشاعر من حركة المجتمع وانتصاره للقوى الخيرة فيه لا يمكن أن تضيق به – فيما أرى – قطعة شعرية تتغنى بالجمال أو تقف لحظة من لحظات العمر الخاصة)(4).
ويقول الناقد في مكان آخر وهو بسبيل تقييم أحد شعراء الستينات في تونس (إن الطيب الشريف كما يظهر في هذا اللون من الشعر متأثر بتلك الدعوات، بل معاد لأولئك الذين يستغلون قوة عمل غيرهم وفي إطار البساطة وعدم التكلف، وهو كذلك خصم للنظرات المتكاسلة والقانعة وغير الطموحة، والتي ترى أن الركون إلى الراحة يمكن أن يجلب كل الخير، بل ان الخير وفقاً لهذا المفهوم قد يطرق باب الناس دون أن يسعوا إليه، وتلك أشياء حسنة حين يأخذ بها الشريف، ولكن وفق أي معيار فني؟ ذلك هو السؤال والجواب فيما نعتقد أن الطيب ‘ الشريف لم يحفل بأسلوبه على الاطلاق، ولم يحاول أن يصنع لنفسه شكلا شعرياً متميزاً بل ولا حتى دالاً على شخصيته)(5).
وبالرغم من هذه الحقيقة فإن الناقد انصرف في الغالب من صفحات كتابه وفي جل النماذج التي تناولها إلى نقد المضمون وتأمله بعناية وإحاطة واقتدار بيد أنه أمام الشكل لم يفعل الكثير، بل اكتفى بإصدار أحكام عامة ولم يدخل في صميم مكونات القصيدة وخضوعها لقواعد الشعر الحر وفي التزامها بشروطه، فلا يعرف القارئ مبرر هذا الموقف وإن كنت شخصياً أميل إلى النماس العذر له إذ أن شروط القصيدة الحديثة ومعيار النقد إزاءها وقواعد وقوانين الشعر الحديث وقياساته مسألة غير ميسورة بالقدر الكافي، لأن أحداً من المفكرين العرب نقاد أو مبدعين ودارسين لم يتمكن بعد من وضع قياسات ومعايير وشروطا دقيقة محددة للشعر الحديث.
لقد كان الشاعر العربي القديم يبدع القصيدة معتمدا على تذوقه وحسه الفطري فيبني معماراً شعرياً سليماً لا عوج فيه، وظل الأمر كذلك معتمداً على السليقة إلى أن جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي فاستنبط من حصيلة الشعر الذي شاع بين العرب شروط القصيدة العربية التقليدية وحدد لا أصولاً وقواعد، وصنع من كل ذلك علماً متكاملا للشعر اعتمد عليه النقاد والمبدعون والتزموا به على حد سواء فيما بعد إلى هذه الساعة، أما الشعر الحر فإنه منذ أن نشأ في الوطن العربي في منتصف الأربعينات على يدي نازك الملائكة وبدر شاكر السياب، وعلى أحمد باكثير لم تتبلور له شروط محددة، أو قواعد ثابتة فيما عدا ما يشار إليه في العموميات من موسيقى القصيدة والوحدة العضوية ووحدة التفعيلة الخ، وليس هناك فيما أعلم أنا شخصياً على الأقل معايير علمية يمكن الركون إليها حال تقييم القصيدة الحديثة، ولعل المحاولة الوحيدة في هذا الصدد والمتداولة الآن بين يدي النقد هي تلك المقاييس والشروط التي حاولت أن تضعها نازك الملائكة في كتابها القيم (قضايا الشعر المعاصر) وهي وحدها غير كافية لإِرشاد النقد، ولهذا فإن أغلب النقاد انصرفوا إلى معالجة المضامين التي ينطوي عليها الشعر الحديث واكتفوا بإيماءات وغمغمات خافتة حول اللغة الشعرية والصورة الشعرية من منطلق التذوق الشخصي ليس أكثر.
وعلى سبيل المثال لماذا لم يقل لنا الناقد لماذا يتنقل المنصف الوهايبي في قصيدته (سورة النخل) من بحر من بحور الشعر إلى بحر آخر وما هي الضرورة التي ألجأته إلى ذلك؟ هل هي درجة الانفعال ومستوى الايقاع حين يريد التعبير عن معنى من المعاني فيختار له البحر المناسب وهل تبيح شروط القصيدة الحديثة هذا القفز بين البحور؟ ولماذا يستخدم الشاعر النخلة كرمز باستمرار؟ هل لأن النخلة نظل على الدوام محتفظة بهامتها منتصبة في وجه الرياح والعواصف؟ هل لأنها تظل محتفظة باخضرار سعفها برغم شح الأرض وتقلب الفصول؟
ولكم كنت أتمنى من الناقد الاستاذ مازن أن لو توقف عندما وصل إلى (معبر إلى شعر الشباب) أن يتوقف أمام قضية هامة تخالج الشعراء الشبان وتصيب إنتاج بعضهم بالاضطراب وهي قضية الفرق بين قصيدة النثر والقصيدة الملتزمة بالتفعيلة والايقاع الموسيقي، ذلك لأن سيلا عرماً من النثر وإهمال شروط القصيدة الحديثة يطغى على محاولات الشعراء الشبان ويبعدهم عن ساحة الشعر، وهم إذ يقعون في براثن النثرية يصرون على أن ما يبدعونه شعراً ويكابرون أكثر مما يجب بادعاء الثورة على تقاليد الشعر الحر الذي أبدعته الأجيال التي سبقتهم.
والناقد أمين مازن تجاوز هذه الوقفة لأن الشعراء الشبان في تونس وخاصة (المنجميين) منهم لا يقعون في هذا الخطأ الفادح الذي يقع فيه غيرهم. فهم يبدعون شعراً يثور على التقاليد القديمة في مضامينه وأسلوبه وجرأته وتمرده ولكنهم يلتزمون بشروط الشعر من وحدة عضوية وتفعيلة وموسيقى داخلية للقصيدة، ولكن لأن القراء مشغوفون بأن يسمعوا رأياً جادًا يساهم في حسم هذه القضية، قضية الخلط بين الشعر والنثر لدى الشعراء الشبان وقضية الانحراف بالقصيدة إلى متاهات غامضة. لقد كنا نتمنى لو توقف الناقد قليلا عندها وهو يصل إلى الفصل الأخير في كتابه (معبر إلى شعر الشباب) وهو الفصل الهام والمثير والذي سيبقى له الفضل في أنه عرفنا على فيف زاخر من العطاء المتدفق لدى جيل الغضب والتمرد من أناء الشقيقة تونس.
وتبقى عدة قضايا هامة يثيرها هذا الكتاب الجيد (الشعر شهادة)، وفي مقدمة هذه القضايا مناقشته لتلك النزعة التي يرددها بعض الانعزاليين والتي تقول بوجود خصوصية تونسية، فلا يرى الناقد أي مبرر لوجود هذه النزعة في أي قطر من أقطار الوطن العربي، وإذا كان ثمة خصوصية طفيفة في الواقع الاجتماعي وفي الأسباب الخاصة التي أوجدها الاستعمار الفرنسي الذي جثم على صدر تونس سنين عديدة فإن هذه الخصوصية لا مجال للأخذ بها لدى الحديث عن قضايا الأدب والثقافة والفكر (إن الذي لا مراء فيه ان هذه الفكرة، فكرة الخصوصية التونسية لا مجال للقول بها في القضايا الأدبية على وجه التحديد، ذلك لأن رحلة الأدب العربي تعتبر في الحقيقة رحلة واحدة، رحلة كتب لها في معظم الأحيان أن تكون لها ريادة واضحة وتأثيرات جلية وتأثر لا مجال للمكابرة فيه والسعي إلى إنكاره)(6).
كما أن بعض الآراء والأحكام التي يصل اليها الكتاب تستحق التقدير وتفتح باب الجدل وصولاً إلى الاغتناء والإثراء (إن مسيرة الشعر فيما أرى لا يمكن التأريخ لها بالأحداث السياسية، بقدر ما يؤرخ لها بظهور التيارات الفكرية والتطورات الأدبية، نعم ان الأحداث السياسية تؤثر في النشاط الفكري ما في ذلك شك ولا ريب، ولكن التطورات الأدبية كثيراً ما تسبق الأحداث الكبيرة وقد تتأخر عنها كما يعلم الجميع وبعد، فإن هذه الكلمة هي مجرد تحية لهذا العمل الجيد الذي جاء نتيجة اجتهاد مشكور في متابعة الحركة الشعرية في القطر الشقيق تونس، وأنا أعلم أنه كان من الممكن أن تكون هذه التحية أكثر غنى وخصوبة لو أن النماذج التي تحدث عنها الناقد موجودة بين يدينا، ونكرر له التحية مرة أخرى لأنه نبهنا إلى هذه التيارات الشعرية الواعدة مما سيحمل الكثيرين على السعي في الحصول عليها ومتابعة عطاء أعلامها.
الناشر العربي | العدد: 6، 1 يناير 1986م
هوامش:
(1) الشعر شهادة، دراسات نقدية – امين مازن، سلسلة كتاب الشعب العدد 76 مارس 1984 المنشأة العامة للنشر.
(2) الشعر شهادة صفحة 101
(3) الشعر شهادة صفحة 17
(4) الشعر شهادة صفحة 7
(5) الشعر شهادة صفحة 45.
(6) الشعر شهادة صفحة 29
(7) الشعر شهادة صفحة 12