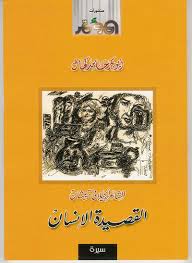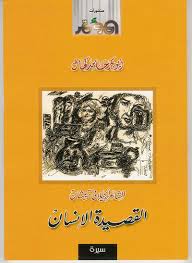مقدمة كتاب (الشاعر الجيلاني طريبشان ..القصيدة والإنسان) للروائي الأريتري “أبوبكر حامد كهال”
رمضان سليم
ماذا يمكن أن نسمي الكتاب الذي أصدره أخيرا الكاتب الصديق أبوبكر حامد ؟ نعم إن عنوان الكتاب هو “الجيلاني طريبشان، القصيدة والانسان” وهو عنوان يوحي لنا بدراسة نقدية للوهلة الأولى لكن الأمر ليس كذلك فعليا، وبالتالي علينا أن نتساءل عن نوعية هذا الإصدار.. هل هو كتاب نقدي؟ أم هو كتاب في السيرة؟ وهل هو كتاب يدرس حالة إبداعية؟ أم أنه كتاب أقرب إلى الرسائل الأخوية المعروفة بين الأصدقاء بطابعها الذاتي والاجتماعي والحقيقة إن الكتاب يجمع كل ذلك، ويغمس كل الاشياء في بعضها بدون تحديد المعايير أو الجري وراء المقاصد والانواع.
لقد أصدر ابوبكر حامد سابقا رواية بعنوان “رائحة السلاح” وهي عن الحرب الأريترية ولقد كان نصا مفتوحا يتداخل مع السيرة الذاتية ورواية الحرب والرواية الحوارية، وهو أمر نراه يتكرر في ها الكتاب الذي ينفتح على مقاربات كثيرة يسيطر عليها الجانب الذاتي الشخصي والتحرر من القالب الفني من أجل الاقتراب من الشخصية التي يتعامل معها الكتاب وهي شخصية الشاعر “الجيلاني طريبشان”
الكاتب والشاعر
لماذا الحديث عن النوع؟ لأن الكتاب كاد أن يقترب من الرواية لو أراد له صاحبه ذلك ، لكن فضل هذا القالب المفتوح الذي جاء فيه الكتاب ، عبارة عن تفاصيل واختيارات وقصاصات من مساحة زمنية قضاها الكاتب مع الشاعر.
يمكن لنا أن نقبل الكتاب على علاته باجتهاد واضح من الكاتب الذي ترك القلم يعبر ببساطة عن مشاعره تجاه شاعر متميز من شعراء ليبيا المجددين ، لكن الناقد الأدبي يعتبر الكتاب مدخلا مهما لقراءة قصائد الشاعر طريبشان ، فنحن في النهاية نضع الانتاج الشعري في المقام الأول وما يأتي بعد ذلك لابد أن يكون في خدمة هذا الهدف.
إنه كتاب من الحجم الصغير صدر عن مجلة المؤتمر التي تصدر عن المركز العالمي لابحاث ودراسات الكتاب الأخضر، وضمن سلسلة من الإصدارات التي تستحق التنويه لأنها شملت أنواعا عدة من الكتب وقدمت أسماء مختلفة أكثرها أصدر كتابه الأول للمرة الأولى.
يهدي الكاتب كتابه إلى بعض الأصدقاء وهم عامل مشترك بينه وبين الشاعر والاصدقاء في الحقيقة كثر، لكن وقع الختيار على من هم أقرب للرحلة التي التقى فيها الكاتب بالشاعر.
الكاتب والشاعر ، إنها محطة تجمع شخصين في رحلة واحدة.. يقول مؤلف الكتاب: “هنا لابد من القول إنني لا أهدف عبر هذه الأسطر أن أخط كتابة نقدية عن تجربة الجيلاني، فهذه مهمة ليست بالسهلة ولا أراني قادرا عليها – الآن – على الأقل ، وكل ما وددت أن أدونه عزيزي القارئ ، كما ستلمس ، هي مشهديات بسيطة عن ذكريات وعن شعرية فقيد الفن والابداع الذي رحل عن دنيانا.”.
من الواضح هنا أن رحيل الشاعر الجيلاني طريبشان في الثاني من شهر يوليو من العام 2001 كان سببا رئيسيا لتأليف هذا الكتاب ولذلك جاء في شكل ذكريات مشهدية، سيطر عليها مبدأ الواجب الأخوي والشعور الوجداني ، حتى وإن كانت تشير إلى توجهات أدبية نقدية.
وقفة خاصة
لذلك كله سوف نجد أن بداية الكتاب قد كانت مع وقفة بعنوان “اليوم الأخير” ويعني به أمسية برابطة الأدباء والكتاب ضمت الكاتب الشاعر ومعه بعض الأصدقاء وعلى رأسهم الناقد أحمد الفيتوري الذي بدا وكأنه يلخص مسيرة الشاعر الجيلاني عبر تجربته في صحيفة الأسبوع الثقافي في السبعينيات وهو الناقد القادر على ذلك.
يقول مؤلف الكتاب: “كانت تلك الجلسة غريبة ، كأنها تلخص مشوار الجيلاني وحياته الابداعية وتضع فاصلة في آخر سطر من حياته! وكان الجيلاني يعبر عن رضاه لما تطرق إيه الفيتوري في هذا الاستعراض التلخيصي وعبر عن رضاه الكامل عن تجربته وعن سيرته ومنجزاته.”.
يبدأ الكاتب فعليا من محطة اسمها اللقاء الأول، وهذا مدخل طبيعي للكاتب .. ففي عام 1989 تعرف الكاتب على الشاعر بمقهى باب البحر مع عدد من الاصدقاء الأدباء الذين يرد ذكرهم أكثر من مرة داخل الكتاب، والأهم أن الكاتب أبوبكر حامد قد عرف الجيلاني عن قرب عندما توثقت العلاقة بينهما وتوطدت وخصوصا عندما سكنا معا في خان السراي، وهو مبيت جماعي في المدينة القديمة بطرابلس يضم عددا من الغرف المنفصلة.
أما السبب المباشر في استمرار العلاقة ، فقد كانت أساسها دعوة طريبشان للكاتب بأن يسكن معه في غرفته، ولاسيما بعد أن عرف بمشاكل السكن التي يصادفها بشكل يومي.
أمكنة تذكر
إن المكان هو مبرر العلاقة ، وهو يبرز كأهم معلم في هذا الكتاب، حيث يتكرر ذكر الأمكنة، المقاهي والمطاعم والفنادق الصغيرة ومقرات معينة وشوارع وازقة، وكأن المكان هو الذي يجمع هذين الغريبين، ليس عن بعضها ، لكنها غربة العابر الذي يبحث دائما عن مأوى ولا يكاد يجده.
إذا أضفنا غلى ذلك أن الكاتب من أريتريا، غادرها للاستقرار والعمل في طرابلس ، والشاعرمن مدينة الرجبان البعيدة نسبيا عن طرابلس، ارتحل من أجل العمل الصحفي والثقافي وبحثا عن آفاق مناسبة تهيئها المدينة بدرجة معينة، فقد علمنا إذن مقدار حاجة الكاتب للشاعر والشاعر للكاتب، فقد توحدت فيهما صفة العابر الراحل، الباحث عن الدفء، اللاهث الذي يجري وراء غايات لا يكاد يدركها.
منذ الصغر كان الجيلاني يتحرك ومثلما يراه كل شخص من النادر أن تجده جالسا أو واقفا ، إذ ليس لديه وقت للجلوس والوقوف، فهو لا يجيد كثرة الحديث ، إنما هي كلمات يقولها لا يدري سامعها هل يعنيها فعلا أم أنه يعني غيرها من المعاني.
ولقد جاء في متن الكتاب ما يشير إلى ذلك ، فقد سكن الجيلاني صغيرا في أكثر من منزل، المدينة القديمة، أبو الخير، زاوية الدهماني، وقبل ذلك وبعد ذلك الرجبان، فضلا عن أمكنة العمل والسكن الفردي المبعثر والمقاهي والخانات التي لا بديل لها.
يمكننا أن نضيف إلى ذلك سفر الجيلاني إلى العراق وبقاءه هناك لسنوات، ثم سفره الى دبلن والعودة إلى ليبيا، وفي جميع الأحال هو ذلك الشخص البسيط الذي يقترب من الأرض حجما ويرتفع عنها مقاما، وهو المحتاج دائما إلى أبسط ضروريات الحياة.
أما الكاتب أبوبكر حامد فهو من نفس النوع، بل يتفوق عليه في المكابرة ، والغريب أن كليهما باحثان عن ملاذ ومأوى يهرب منهما دائما رغم الالحاح بالوصول إليه.
محطات وتفاصيل
لا يخرج الكاتب في كتابه على التسلسل التاريخي لتطور علاقته مع الشاعر الجيلاني طريبشان، بل يقفز في تصوير والتقاط بعض الذكريات ، ولعل أفقر المحطات ما يورده منها من الخارج، أي تلك النحطات التي سمعها وعرفها عن بعد ولم يكن شريكا فيها، لكنه وهو يعد كتابا حول هذه التجربة لابد للكاتب أن يورد بعض التفاصيل التي تشير إلى الشاعر وعلاقاته وانطباعاته ولو كانت من الخارج.
أما أكثر المناطق متعة فهي تلك اللحظات التي يقتنيها الكاتب مباشرة مع شخصية الشاعر، في مقهى أو غرفة أو في حوار جانبي.. من ذلك على سبيل المثال فقرات مثل “مسرات ومسرات الزواج – السكن” ، لكن الأهم تلك الفقرة التي أسمها “ليلة الحزن” والتي برز فيها ذلك المشهد الذي اصطاده الكاتب رغم ظلمة الغرفة الحزينة، ويكشف المشهد عن ذلك الحزن الذي يكمن في أعماق الجيلاني ، فهو ساخر أحيانا في كلماته، لكنه من الداخل يحركه حزن دفين، وأحسب أن هذا الحزن الكامن فيه يكاد يمنعه من الحديث العفوي المنطلق، والمسألة هنا ليست ذاتية، بقدر ما تعود إلى ثقة كبيرة في النفس لا تتناسب والمستوى الاجتماعي والمادي الذي عليه الشاعر، وهي مسألة لها طابع نفسي اساسها تقدير الشاعر لنفسه، ومعايشته للنصوص الشعرية وعالم الأدب الرفيع ، الذي يجنح صاحبه نحو العزلة .
إن الجيلاني شاعر من جيل السبعينيات وهو من الشعراء الذين وصفهم الناقد منصور أبو شناف بأنهم “الجيل الجسر” حسب وصف الكتاب، لكنه الجيلاني ، يختلف كثيرا فهو لا يعرف كيف يتملق وكيف يقترب، وكيف يجامل، وما نقله الكاتب في كتابه صورة كاشفة لذلك، وسوف يصطدم بعض ممن لا يعرفون الجيلاني ، إلا شاعرا من خلال النص ، بكل ما جاء في الكتاب ، من مرارة وقسوة ، حتى إننا سوف نعيد في الذاكرة ما حدث لبعض الشعراء من تجارب متشابهة ، أمثال السياب وقبله الشابي وبعده أمل دنقل ونجيب سرور وغيرهم.
المشكلة هنا أن القسوة الحياتية قد هزمت الشاعر ، فلم يعد يهتم ينصوصه، فهي تضيع منه غالبا ، ويذكر مؤلف الكتاب شواجهد على ذلك، ربما تساعدنا على الاقتراب من شعر الشاعر.
ولكن السؤال الذي يمكن طرحه على ضفاف الكتاب ، هل ينبغي أن تكون هناك علاقة بين حياة الشاعر وشعره؟ أو بالأصح هل يجب أن تقودنا حياة الشاعر إلى شعره؟
إن الإجابة تظل مفتوحة لتسير بنا بعض سطور الكتاب إلى ملامح من كل ما ذكرنا، لكن وبسبب قلة الابيات المذكورة في الكتاب، فنحن لا نستطيع أن نربط ربطا مباشرا بين مكابدات طريبشان وقصائده المتناثرة القليلة والتي يصر على أن تكون قليلة.
مساحة القصيدة
من الزوايا التي يذكرها الكاتب، مساحة يخصصها لكيفية كتابة الجيلاني للقصيدة، والمكان بالطبع هو مقهى بفندق الأطلسي ، حيث يمسك الكاتب بلحظة ولادة القصيدة، ويصف حالات ذلك من طريقة مسك القلم إلى طريقة الكتابة وانعكاس ذلك الوجه واللسان ، بل هناك لحظة يصعب التقاطها إلا لمن كان مقربا للشاعر، عندما تسقط العبرات من العينين وينتشي القلب من الفرح وتغمر الجسد لذة الابداع.
لا أريد أن أكرر النصوص الدالة ، فهي قليلة ، لكنها كافية، والكتاب يختصر الكثير من اللقطات، مثلما يقتصد الشاعر في اختيار كلماته ولا تخرج عنه ، بعد أن تضغط عليه، إلا في أقصر وأوجز حالاتها.. وهذا الملمح تشير إليه صفحات الكتاب عندما تتكرر عبارة مفادها أن القصيدة تبقى في جيب الجيلاني مدة طويلة وهي بهذا إما أن ترى النور أو أنها تضيع!!
هناك بعض اللحظات الحاسمة التي مر عليها الكاتب، وهي تدلنا على أن ما بداخل الشاعر هو اشد توهجا مما يظهر في الخارج، وخصوصا عندما تطرق الكاتب إلى اقتراب الجيلاني من لحظة الانتحار، أو سيطرة هذه الفكرة عليه لفترة طويلة، وأرجح أن الارتحال من مكان إلى آخر كان سببا في ذوبان هذا الانتحاري مع مرور الأيام، ومن بعد ذلك دخول الشاعر في تجربة زواج سريعة فرضت عليه اجتماعيا، وانتقاله إلى حياة أخرى مختلفة تتضمن الكثير من المسؤولية والتي حاول الجيلاني طريبشان أن يبتعد عنها طوال حياته.
الداخل والخارج
كان الكاتب خارجيا إلى حد ما بالنسبة لتطرقه إلى حياة الجيلاني الاسرية ومجيئ الأولاد بعد ذلك، وإن كان قد تلمس أبعادها من انفعالات الشاعر ومحاولاته اليائسة للحصول على مسكن في طرابلس وقبل ذلك مشكلة العمل، وغيرها من المشاكل التي تفيد بأن الشاعر لم يستطع التأقلم مع الفضاء الذي يعيش فيه، وأنه كان يحمل غربته بين يديه، ولقد أجاد الكاتب أبوبكر حامد في نقل بعض المشاهد على ذلك، وهي شواهد مختارة من أحداث ووقائع فعلية، صاغها الكاتب بطريقته الوجدانية ذات الحساسية العالية.
إن كثرة الانتكاسات فسرها الكتاب بأنها لعنة تطارد الشاعر ، فهو الذي يصنع قصائده باستمرار ومن ذلك ما ضاع في خان السراي، ثم المجموعة القصصية التي سلمت لأحد الأشخاص وفقدت بعد ذلك ولا توجد أية أخبار عنها.
أما ما ارتكبه الجيلاني بحق نفسه فأكثر من ذلك، ذلك أنه أتلف كتاباته عندما رماها في نهر الليفي بأيرلندا لكي تكون قربانا من أجل ما هو مجهول، وكأن النصوص تبقى أكثر خلودا عندما تذوب في الماء.
وما ينبغي ملاحظته أن الشاعر يسير في أكثر من خط، فهو حينا يستعدي عذابه، وفي أحيان أخرى يضحي بما عنده من أجل أن يبقى ويعيش ويستمر في حياته.
لم يتطرق الكاتب كثيرا إلى علاقة الجيلاني بالمرأة عدا شذرات بسيطة عن فتاة من أيرلندا “إيزابيلا” ومراسلته للكاتبة نورا من الجزائر وزواجه السريع ولا تبدو المرأة قاسما مشتركا للحوار بين الصديقين إلا في حالات نادرة.
هناك علاقات شخصية تبعث الشاعر مع بعض الأصدقاء ، ولد تم ذكرهم في أكثر من مكان ومن ذلك علاقته بالكاتب كامل المقهور وعبد السلام الغرياني ومحيي الدين المحجوب وأحمد بللو وحسين المزداوي وغيرهم، لكن تبقى تلك الصداقة التي جمعته مع أبناء جيله هي الأهم، هي تببرز من خلال ثنايا الكتاب واضحة، ولاسيما علاقته مع صديقه رضوان أبو شويشة الذي يعرف الجيلاني طريبشان عن قرب ويتداخل مع حياته معايشا ومفسرا لتصرفات الشاعر ومتغيرات الأقدار من حولها بنكهة فلسفية.
المسؤولية والجدية
يوحي لنا الكاتب بأن الجيلاني طريبشان على مشارف إدراكه لقرب يوم وفاته وهذا ما نجده دائما يتردد ، عند الشاعر أو عند غيره، ومن ذلك استخدامه لمصطلح “حامل التوابيت” الذي رآه وهو يحمل نعشه ويعود به من فنزويلا التي ينوي الجيلاني الرحيل إليها ليعمل في العمل الثقافي الخارجي، والمقصود طبعا هو الروائي إبراهيم الكوني الذي احضر معه جثمان الكاتب الصادق النيهوم من سويسرا، لكن الكاتب عن الشاعر عرف هذه المرحلة الأخيرة ، جعل الحديث عن الموت خفيفا.
لم يكن الشاعر الجيلانس طريبشان عابثا، بل كان شخصا جادا ، لكنه كان يخشى المسؤولية ويخاف منها، وربما كان السبب في ذلك طبيعة عمله المتواضع والذي جعله يعيش عيشة الكفاف رغم محاولة كل الاصدقاء مساعدته.
لم يأت الكاتب بالكثير من كتابات الشاعر المقصود ، وربما لم تبق معه إلا بعض القصاصات التي أوردها في آخر الكتاب وهي مراسلات بين الشاعر والكاتبة الجزائرية ، أما باقي الأوراق فهي إما ضائعة أو تنتظر النشر ، ومن ذلك رواية لسنا ندري ماذا حل بها!!
لقد كتب الجيلاني طريبشان الكثير من الشعر، أودع بعضه في ديوان صدر مبكرا بعنوان “رؤيا في ممر 75″، والثاني “ابتهال إلى السيدة ن” والباقي شبه ضائع أو شبه مفقود، الاضافة إلى رسومات وتخطيطات كان يرسمها الجيلاني منذ سنوات طويلة، واعتقد أن أصدقاءه وهم كثر عليهم واجب جمع كل ما كتبه في لحظة مهمة يحتاجها هذا المبدع، لأن ما كتبه هو أكثر وأغزر مما نشره، وربما أهم .