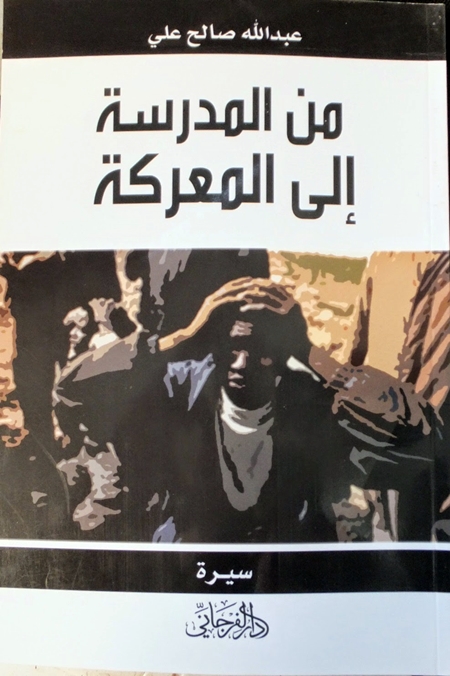بوابة الوسط
«من المدرسة إلى المعركة» كتاب صادر عن دار الفرجاني لمؤلفه عبد الله صالح علي، تحت تصنيف «سيرة»، يروي حكاية طالب ليبي من بلدة مرزق انتقل فجأة من فصله الدراسي إلى الخطوط الأمامية لحرب ضروس في عمق الأراضي التشادية، يقول في مقدمته: «أنا من ضمن الطلبة الليبيين الضحايا الذين أُجبروا على الالتحاق بصفوف الجيش الليبي في حرب تشاد (1987 ـ 1988)، ووقعت في الأسر في معركة وادي الدوم وتمكنت من الهروب بعد اثني عشر شهراً».
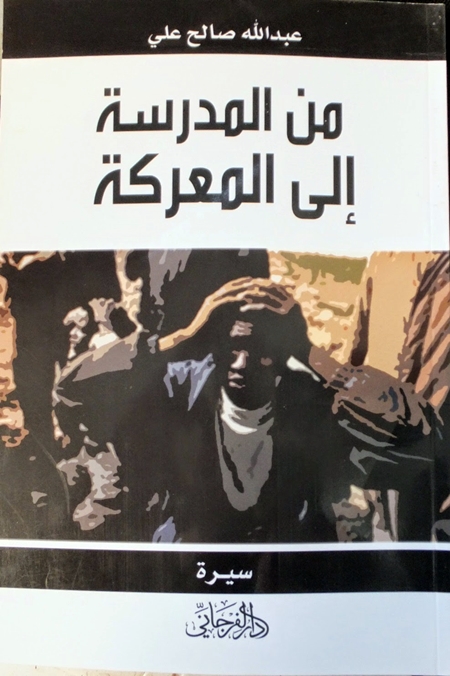
تروي السيرة تجربته الشخصية، منذ اُقتلع من مقعد الدراسة إلى أتون الحرب مباشرة، اختزنها طازجة في ذاكرته لمدة ربع قرن، حيث لم يستطع أن يرويها لأقرب الناس إليه بسبب تحذيره من ذكرها بعد إطلاقه من السجن الانفرادي الذي أُودع به بعد عودته إلى الوطن، وكان أشد قسوة من سجنه في تشاد كأسير: «كنت لا أجرؤ أن أحكي قصتي ولو باختصار أثناء حكم القذافي حتى لأقرب أقاربي لكي لا يصل ذلك إلى الاستخبارات الليبية وينتهي الأمر بي في غياهب سجون الأمن الداخلي». وهذا الصمت الإجباري الطويل جزء من بنية مثل هذه الأنظمة الفاشية التي لا تكتفي بأن تضعك في قلب الجحيم والعذاب، لكنها تمنعك حتى من البوح بحكاية هذا العذاب لأقرب الناس إليك.
تلك الحكاية التي مكثت ربع قرن في داخله كندبة في الروح لم تفقد طزاجتها لأنها من الواضح كانت جرحه النازف نهاراً وكابوسه المرعب ليلاً. كتبها بعفوية مثلما حكاها لأولاد عمه حين أطلق سراح الحكاية بعد انتفاضة 17 فبراير مباشرة، وإن كانت طرق السرد تستجيب تلقائياً لحالاته العاطفية خلال كل هذه الأحداث، فهو يمر بسرعة على المشاهد القاسية وبأقل كلمات، وكأنه لا يريد لها أن تثبت في ذاكرته أو في سيرته، أما المشاهد الجميلة أو المواقف الإنسانية فكان يمكث عندها ويبطئ من إيقاع سردها، ويحاول الاستمتاع بتذكرها ما وسعه ذلك، وكانت لغته تكتسب نوعاً من الشعرية التي ترقى بمستوى تلك المقاطع لأن تكون عملاً أدبياً، بل إن ذاك السرد الأفقي للوقائع بوتيرته التناوبية بين السرعة والبطء سيتحول إلى سرد روائي متكامل بمجرد أن تدخل تلك الفتاة من قرية (زوار) بجبال تيبيستي حياته حين طلب منها حبلاً لربط حزمة الحطب التي كان يجمعها من الوادي، ليدخل الحب ثنايا هذه الحكاية ويحقنها بحس شعري خافت يوقظ فيها ملمح النص الأدبي المكتوب بفطرة.
كنت لا أجرؤ أن أحكي قصتي أثناء حكم القذافي، لكي لا يصل ذلك إلى الاستخبارات وينتهي الأمر بي في غياهب سجون
زينب، التي حولت في نظره «القرية البائسة إلى مدينة جميلة ذات حدائق بهيجة» والتي ظهرت من قلب الجحيم لتصبح، كما يقول، بمثابة «الشحنة التي أمدتني بالطاقة التي يعمل بها محرك الحياة بعد أن كادت شحنة الأمل التي أتيت بها من (فايا) تنفد» وشحنة الأمل تلك التي امتلأ بها في (فايا) مصدرها موقف إنساني تمخضت عنه صداقته مع رجل من قبيلة التبو، اسمه محمد، كان في النهاية السبب المباشر لنجاته من الأسر.
لكن سيظل الألم المضاعف الذي عاناه عند رجوعه فرِحا إلى الوطن أهم خطابات هذا الكتاب، وأهم أسئلته حول الفارق بين ألم العذاب في الغربة والأسر، وبين ألم العذاب في الوطن، في تلك الزنزانة الانفرادية التي أطبقت عليه في سجن بوسليم: «بدأت أنظر حولي فلا أرى سوى جدران الغرفة، ولا أسمع سوى فتح وغلق أبواب السجن. ولم أكن أتصور أن ينتهي بي الأمر إلى سجن انفرادي عندما أصل إلى بلدي، وتوقعت بأنهم سيقابلونني كبطل حرب ويقلدونني وسام الشجاعة ولكن هيهات.. هيهات!».
حكى الراوي قصته بكل الألم فيها، وما تخلله من لحظات مرح يعكر صفوها الحنين إلى بيته ومدرسته ووطنه، حكاها لتصبح ماضياً يلهم مستقبل الوطن العبرة والدرس، وما يجب أن يكون عليه حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي: «أود أن تكون هذه القصة عبرة للشعب الليبي لكي يبني دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتكفل للمواطن الحرية والعدالة والمساواة وتحترم حقوق الأقليات ويسود فيها حكم القانون والمحاكمة العادلة من أجل أن نضمن للأجيال القادمة أن تعيش في أمن وأمان ورخاء».
لذلك، هذا الشاب الذي نُقل من خلف مقعد الدرس إلى جبهة القتال الأمامية في حرب عبثية، يدرك مع آلاف من التلاميذ مثله ومن الشبان الذين جازف نظام مخبول بمستقبلهم، أهمية انتفاضة فبراير التي أسقطت نظاماً بهذه الوحشية، كان يزداد توحشاً مع زمن تسلطه على شعب جرده من كل آليات الدفاع عن نفسه، ويدرك أهمية بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها، مثلما الملايين الذين عاشوا تحت خط الفقر في إحدى أغني الدول فوق الكوكب يدركون ذلك، والذين كانوا لا يجدون حقنة في المستشفيات فيستدينون ويبيعون ما يملكون ليذهبوا إلى دول أخرى فقيرة لتلقي العلاج، ويدرك الطلاب الذين زُجُّوا في السجون، ومنعوا من إكمال دراستهم، والذين رأوا رفاقهم مشنوقين في الميادين العامة بينما الطاغية يراقب أجسادهم المتدلية من نافذة في فندق مجاور ومطربه الشعبي، العزومي، يغني بجانب المشانق، ويدرك سجناء الرأي من الكتاب والمثقفين الذين قضوا زهرة شبابهم في زنازين رثة يعذبون فيها كل يوم، تنفيذاً لثورة الطاغية الثقافية التي أعلنها في نقاطه الخمس المشؤومة، ويدرك من رأوا الفساد الممنهج ينخر جسد المجتمع عبر من وصلوا للمناصب في فوضى السلطة الشعبية التي أسست لثقافة الفساد والانتهازية وجعلت من المرتشي والمختلس يرقَّى في المناصب، ومن الكفاءات النزيهة طوابير على المصارف كي تحصل على مبلغ يسد رمقها (على الأحمر)، وتدرك الأمهات الثكالى، والأيتام الذين دخل آباؤهم سراديب النظام المعتمة أو اختفوا في مغامرات عسكرية من أجل مجده الشخصي ولم يعودوا أبداً، أن الثورة على النظام وإسقاطه كانت ضرورة من أجل الحياة قبل الحرية، ومن يشككون في عظمة 17 فبراير، فإنه ويوم الاستقلال 24 ديسمبر من أهم أيام ليبيا على مدى تاريخها، ومن يمنعون الاحتفال به بحجة أنها مؤامرة مصيرهم مثل الطاغية الذي منعنا لأربعة عقود من الاحتفال بيوم الاستقلال الذي اعتبره مؤامرة، ثم عاد شعاراً لانتفاضتنا التاريخية، وذكرى مجيدة ستظل الأجيال تحتفل بها. أما المشككون فهم من انخرطوا في جنون هذا النظام وفساده، واستفادوا من فوضاه وأدوات طغيانه، وتمنوا أن لا يزول، فتحولت فبراير إلى كابوسهم الشخصي.
أهم خطابات هذا الكتاب، وأهم أسئلته حول الفارق بين ألم العذاب في الغربة والأسر.. وبين ألم العذاب في الوطن
ندرك أيضاً عواقب مثل هذه الثورات الشعبية التي تجتث نظماً شمولية من جذورها، مثل المضاعفات التي تعقب استئصال ورم سرطاني خبيث، لكن الخوف من العواقب لم يمنعنا من المجازفة والتوق الغريزي إلى الخلاص، ولن يمنعنا من أن ننظر إلى المستقبل بعين متفائلة وأن نحب الحياة كما يجب، وأن نتعلق بالحرية مهما كان ثمنها.
ففي داخل كل ليبي حكاية مثل حكاية عبد الله صالح علي عليه أن يحكيها، وفي روح كل ليبي حب يحيل «القرية البائسة إلى مدينة جميلة ذات حدائق بهيجة».
“من المدرسة إلى المعركة” كتاب صادر عن دار الفرجاني لمؤلفه عبد الله صالح علي، تحت تصنيف سيرة. يروي حكاية طالب ليبي من بلدة مرزق انتقل فجأة من فصله الدراسي إلى الخطوط الأمامية لحرب ضروس في عمق الأراضي التشادية، يقول في مقدمته: “أنا من ضمن الطلبة الليبيين الضحايا الذين أجبروا على الالتحاق بصفوف الجيش الليبي في حرب تشاد (1987 ـ 1988)، ووقعت في الأسر في معركة وادي الدوم وتمكنت من الهروب بعد اثني عشر شهرا.”.
تروي السيرة تجربته الشخصية، منذ اقتُلِع من مقعد الدراسة إلى أتون الحرب مباشرة، اختزنها طازجة في ذاكرته لمدة ربع قرن، حيث لم يستطع أن يرويها لأقرب الناس إليه بسبب تحذيره من ذكرها بعد إطلاق سراحه من السجن الانفرادي الذي أُودع به بعد عودته إلى الوطن، وكان أشد قسوة من سجنه في تشاد كأسير: “كنت لا أجرؤ أن أحكي قصتي ولو باختصار أثناء حكم القذافي حتى لأقرب أقاربي لكي لا يصل ذلك إلى الاستخبارات الليبية وينتهي الأمر بي في غياهب سجون الأمن الداخلي.”. وهذا الصمت الإجباري الطويل جزء من بنية مثل هذه الأنظمة الفاشية التي لا تكتفي بأن تضعك في قلب الجحيم والعذاب لكنها تمنعك حتى من البوح بحكاية هذا العذاب لأقرب الناس إليك.
تلك الحكاية التي مكثت ربع قرن في داخله كندبة في الروح لم تفقد طزاجتها لأنها من الواضح كانت جرحه النازف نهارا وكابوسه المرعب ليلاً. كتبها بعفوية مثلما حكاها لأولاد عمه حين أُطلق سراح الحكاية بعد انتفاضة 17 فبراير مباشرة، وإن كانت طرق السرد تستجيب تلقائياً لحالاته العاطفية خلال كل هذه الأحداث، فهو يمر بسرعة على المشاهد القاسية وبأقل كلمات، وكأنه لا يريد لها أن تثبت في ذاكرته أو في سيرته، أما المشاهد الجميلة أو المواقف الإنسانية فكان يمكث عندها ويبطئ من إيقاع سردها، ويحاول الاستمتاع بتذكرها ما وسعه ذلك، وكانت لغته تكتسب نوعا من الشعرية التي ترقى بمستوى تلك المقاطع لأن تكون عملا أدبيا، بل أن ذاك السرد الأفقي للوقائع بوتيرته التناوبية بين السرعة والبطء سيتحول إلى سرد روائي متكامل بمجرد أن تدخل تلك الفتاة من قرية (زوار) بجبال تيبيستي حياته حين طلب منها حبلا لربط حزمة الحطب التي كان يجمعها من الوادي، ليدخل الحب ثنايا هذه الحكاية ويحقنها بحس شعري خافت يوقظ فيها ملمح النص الأدبي المكتوب بفطرة، زينب، التي حولت في نظره “القرية البائسة إلى مدينة جميلة ذات حدائق بهيجة” والتي ظهرت من قلب الجحيم لتصبح، كما يقول، بمثابة “الشحنة التي أمدتني بالطاقة التي يعمل بها محرك الحياة بعد أن كادت شحنة الأمل التي أتيت بها من ((فايا)) تنفد.” وشحنة الأمل تلك التي امتلأ بها في (فايا) مصدرها موقف إنساني تمخضت عنه صداقته مع رجل من قبيلة التبو، اسمه محمد، كان في النهاية السبب المباشر لنجاته من الأسر.
لكن سيظل الألم المضاعف الذي عاناه عند رجوعه فَرِحا إلى الوطن أهم خطابات هذا الكتاب، وأهم أسئلته حول الفارق بين ألم العذاب في الغربة والأسر وبين ألم العذاب في الوطن، في تلك الزنزانة الانفرادية التي أطبقت عليه في سجن بوسليم: “بدأت أنظر حولي فلا أرى سوى جدران الغرفة ولا أسمع سوى فتح وغلق أبواب السجن. ولم أكن أتصور أن ينتهي بي الأمر إلى سجن انفرادي عندما أصل إلى بلدي وتوقعت بأنهم سيقابلونني كبطل حرب ويقلدوني وسام الشجاعة ولكن هيهات.. هيهات.”
حكي الراوي قصته بكل الألم فيها وما تخلله من لحظات مرح يعكر صفوها الحنين إلى بيته ومدرسته ووطنه، حكاها لتصبح ماضيا يلهم مستقبل الوطن العبرة والدرس، وما يجب أن يكون عليه حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي: “أود أن تكون هذه القصة عبرة للشعب الليبي لكي يبني دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتكفل للمواطن الحرية والعدالة والمساواة وتحترم حقوق الأقليات ويسود فيها حكم القانون والمحاكمة العادلة من أجل أن نضمن للأجيال القادمة أن تعيش في أمن وأمان ورخاء.”.
لذلك، هذا الشاب الذي نُقل من خلف مقعد الدرس إلى جبهة القتال الأمامية في حرب عبثية، يدرك مع آلاف من التلاميذ مثله ومن الشبان الذين جازف نظام مخبول بمستقبلهم، أهمية انتفاضة فبراير التي أسقطت نظاما بهذه الوحشية، كان يزداد توحشا مع زمن تسلطه على شعب جرده من كل آليات الدفاع عن نفسه، ويدرك أهمية بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها، مثلما الملايين الذين عاشوا تحت خط الفقر في إحدى أغني الدول فوق الكوكب يدركون ذلك، والذين كانوا لا يجدون حقنة في المستشفيات فيستدينون ويبيعون ما يملكون ليذهبوا إلى دول أخرى فقيرة لتلقي العلاج، ويدرك الطلاب الذين زُجُّوا في السجون و، منعوا من إكمال دراستهم، والذين رأوا رفاقهم مشنوقين في الميادين العامة بينما الطاغية يراقب أجسادهم المتدلية من نافذة في فندق مجاور ومطربه الشعبي، العزومي، يغني بجانب المشانق، ويدرك سجناء الرأي من الكتاب والمثقفين الذين قضوا زهرة شبابهم في زنازين رثة يعذبون فيها كل يوم، تنفيذا لثورة الطاغية الثقافية التي أعلنها في نقاطه الخمس المشؤومة، ويدرك من رأوا الفساد الممنهج ينخر جسد المجتمع عبر من وصلوا للمناصب في فوضى السلطة الشعبية التي أسست لثقافة الفساد والانتهازية وجعلت من المرتشي والمختلس يُرقَّى في المناصب، ومن الكفاءات النزيهة طوابير على المصارف كي تحصل على مبلغ يسد رمقها (على الأحمر)، وتدرك الأمهات الثكالى، والأيتام الذين دخل آباؤهم سراديب النظام المعتمة أو اختفوا في مغامرات عسكرية من أجل مجده الشخصي ولم يعودوا أبدا، أن الثورة على النظام وإسقاطه كانت ضرورة من أجل الحياة قبل الحرية، ومن يشككون في عظمة 17 فبراير، فإنه ويوم الاستقلال 24 ديسمبر من أهم أيام ليبيا على مدى تاريخها، ومن يمنعون الاحتفال به بحجة أنها مؤامرة مصيرهم مثل الطاغية الذي منعنا لأربعة عقود من الاحتفال بيوم الاستقلال الذي اعتبره مؤامرة، ثم عاد شعارا لانتفاضتنا التاريخية، وذكرى مجيدة ستظل الأجيال تحتفل بها. أما المشككون فهم من انخرطوا في جنون هذا النظام وفساده، واستفادوا من فوضاه وأدوات طغيانه، وتمنوا أن لا يزول، فتحولت فبراير إلى كابوسهم الشخصي.
ندرك أيضا عواقب مثل هذه الثورات الشعبية التي تجتث نظما شمولية من جذورها، مثل المضاعفات التي تعقب استئصال ورم سرطاني خبيث، لكن الخوف من العواقب لم يمنعنا من المجازفة والتوق الغريزي إلى الخلاص، ولن يمنعنا من أن ننظر إلى المستقبل بعين متفائلة وأن نحب الحياة كما يجب، وأن نتعلق بالحرية مهما كان ثمنها.