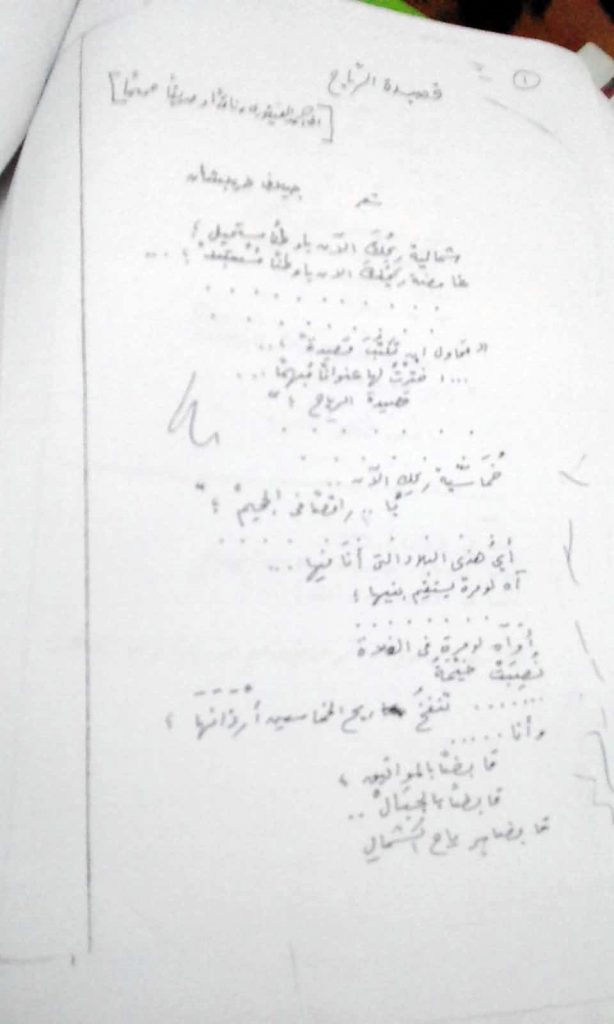يوم استقبلنا العقيد
أظن أني مازلت بالسنة الثالثة معهد معلمات، أي العام الذي عدت فيه للدراسة بعد انقطاع عام دراسي بسبب إدخال مادة العسكرية للمنهج وتحويل المعهد إلى ثكنة ومجيء الضباط والجنود، وخصامي مع أحد الجنود الذي جعلني أقرر الانقطاع عن الدراسة رعبا من (الايامات السود) التي وعدنا بها ذاك الجندي.
عام من الانقطاع جعل زميلاتي يسبقنني بعام دراسي، وتلحق بي زميلات أخريات أصغر مني، ربما هذا أتاح لي تكوين تلك المجموعة (فايزة، نعيمة، هدى، نجمية).
دراسيا لم أكن جيدة جدا، ولكن كنت أجتهد وأحاول النجاح خاصة مع تحول المعهد إلى (ثكنة/ معسكر)، حيث جزء كبير هو للتدريب العسكري حصتين ربما كل يوم، ووووو تجربة هذا الشعور من الصداقة.

ثمة صديقة اسمها مثل اسمي، وجمالها لافت بشعرها الناعم المسترسل وتقاسيم وجه بعينين ضاحكتين، لا أدري سر تعلقها بي، فهي لا تحب القراءة ولا تهتم بأحاديثي الأدبية التي أذكر فيها أسماء شخصيات مثل: طه حسين، ولطيفة الزيات، ونجيب محفوظ، وحتى حين أجيء بمجلات مثل: صباح الخير، وروز اليوسف، والتي كان يجلبها أخي حين ذهابه لمصر عن طريق اليونان في ذاك الوقت 1982، لا تهتم إلا بصفحات الأزياء والأخبار الفنية. لكنها تتبعني وتلبي طلباتي إذا أردت شيئا، الذي ميزّ علاقتي بها هو تفهمي لتلك المشاعر التي فاضت من قلبها الندي فأحبت (ضابطا) وصارت لا تخفي ذلك بتصرفاتها التلقائية، حين تجلب له فنجان قهوة طلبها وتأخرت حين تتجه بجسمها كله حين تسمع صوته رغم أننا في (الكردوس)، تعلقت بي أكثر لأني كنت مثل أخت كبيرة تحكي لي مشاعرها ولا أنهرها لتصرفاتها التي تشي بمشاعرها، لم تطلب مشاعره ربما حتى لم تهتم أن يبادلها هذه المشاعر، كانت تعيش حالة الحب ببساطة آسرة، هذا الحب الذي أقرؤه في القصص والروايات، هذا الحب الذي أبكي مع بطلاته ويتشقق قلبي خوفا عليهن، مع (جين إيير)، هذه الرواية التي استحوذت عليَّ لسنوات، مع (كوزيت) في (البؤساء) هذه الرواية الأيقونة.
كانت هذه الصديقة بعفويتها تجعل قلبي يخفق وأنا أرى ذاك الحب فائضا، (هل كانت صداقتي معها في السنة التي سأنقطع فيها، لقد بقيت لشهرين قبل أو أكثر حتى أني تسلمت جدولا خاصا بالتدريب في مدرسة حيث كانت طرق التدريس العملي….) إذا هذه الصداقة كانت في العام الدراسي 81/82، فالرجاء مسامحتي (أكثر من خمس وثلاثين عاما قد مرت).
يوم طويل.. حين جئتِ انتهى
الحملة الافتتاحية عن الوقت.
الساعة الإن تقترب من الدقيقة 23 بعد الثامنة، إذا هي ليلة الأربعاء.
تركت تلك الكتابة عالقة!! كنت على موعد مع أستاذة الأدب في جامعة طرابلس “ناجية مولود”، هذه الصديقة التي ظلت تبحث عمن انجزت رسالة الماجستير عن الشاعر “جيلاني طريبشان”، والتي منحتها نسخة مصورة من مخطوط (مكابدات).
وهكذا حين التقيت بها في نشاط أدبي بعد أشهر من البحث، أخبرتها عن (رجائي) أن تكون المخطوطة وخاصة تلك النصوص التي لا أدري كيف طارت من بين دفتيّ الملف الذي احتفظت به كما سلمني إياه صديق الجيلاني “عبد السلام الغرياني”. وكان اللقاء بيوم الثلاثاء، حيث احتضنت أخيرا ملفا مُليء أوراقا وحظيت بصحبة “ناجية” لسويعة من الزمن في مقهى 24 (بزنقة المكتب)، والتي كانت لافتتها معلقة بحائط مدرسة (الفنون والصنائع)، ولا أدري من خطر ليده الآثمة أن تنزع هذه اللافتة.
يوم الثلاثاء، هذا الذي ودعتُ مغربهُ وأنا بمستشفى العيون بزاوية الدهماني، هي وعكة طارئة وبسيطة؛ الحمد لله، ولكنها أخذت انتظار الدور لأربع ساعات، كان الليل يرخي سدوله على طرابلس، وأصوات القذائف تسمع بعيدة نوعا ما، وهكذا وأنا في انتظار الدور، أنغمر في أوراق “جيلاني طريبشان”، خطه الأنيق أحيانا والمرتبك، بدايات نصوص وخربشات. لماذا مازلنا نقف عند عتبة العالم تملؤنا لوعة وينداح من قلوبنا الحنين؟ هكذا أتساءل في حضرة “الجيلاني” وفيوضه.
يا سنة ثالثة علمي
إذا هو عام دراسي وصديقات وتواطؤ الشغف، ولكن مالا أنساه هو موقف ظهر فيه تبجحي (ولم أسامح نفسي حتى هذه اللحظة ومازلت خجلة)، حين تعرفي علي الأستاذ “حمدي”، حين كنّا في ساحة الثكنة/ المعهد، وهو جالس يقرأ في مجلة العربي، وقطعت خلوة قراءته وووو حديث وتعارف وصديقاتي (نعيمة وفايزة ونجمية وووو)، يقتربن ويأتي ذكر (مقدمة ابن خلدون) حينذاك أقول: اسألهم يا أستاذ إذا أي واحدة قرت المقدمة؟!!
مازلت أتذكر احمرار وجوههن وارتباكهن، تلك الأيام بدأت قراءة المقدمة التي وجدتها بين كتب أخي الكبير، وحين عدت لبيتنا كانت على سريري فقذفت بها، ولم أكمل قراءتها ولم أستطع الاعتذار لهن.
ولكنه أي العام الدراسي ورغم حصص العسكرية البليدة والتدريبات والكلام المعسووول الذي يشنف أذاننا منذ الصباح، فقد كان عاما مفعما وضاجا.
ما أجمل ان تكوني بنتا في التاسعة عشر! ما أجملهن الصديقات وهن يبتكرن البهجة ويؤثثن الألفة.
وهكذا كانت زيارة (معمر القذافي) إلى كوريا، وذاك الاحتفاء الشعبي بزيارته وتلك البلاد الملونة التي نراها طوال وقت البث تقريبا، أخذتنا إلى أجواء مفعمة وحين أخذونا في (حافلات) لاستقباله أثناء عودته من تلك الزيارة، لم نمانع بل ركبنا الحافلات المكتظة، فليس هينا مجيء فرصة للخروج من أسوار الثكنة/ المعهد والذهاب عبر طرقات طرابلس إلى طريق المطار، لنصطف على الجانبين في انتظار مرور الموكب العائد من بلاد كل ما فيها ملون، بينما نحن بنات المعهد وبنات الثانوية وكل الثكنات/ المعاهد/ المدارس، ينتظمنا لون واحد هو لون (البدلة العسكرية) الأخضر، ولون (البوتيل العسكري) الأسود.