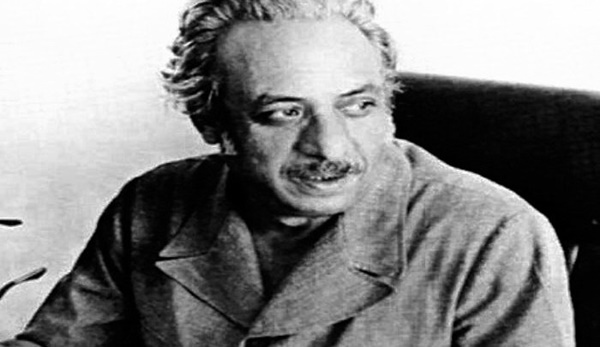د.عبدالبديع عبدالله
الشعر منذ بدأ نهضته الحديثة على أيدي: البارودي وشوقي وحافظ ومطران بدأ يحرك في الشعراء موجات جديدة تحاول النفاذ إلى سطح العبارة لتعبر عن أحاسيس مختلفة لم يألفها الشاعر العربي.
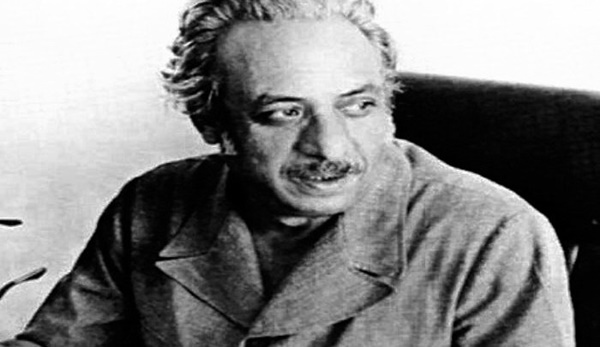
استمرت معركة قبول الشعر الحر كمرحلة في إطار التطور التاريخي للشعر العربي، وطالت أكثر مما توقعه الشعراء والقراء. واتخذ الدفاع عن قصيدة “التفعيلة” مسارات كثيرة؛ كالحديث عن الموسيقى الداخلية من ناحية، وعن أن من الموزون ما ليس شعرًا كقصيدة أبان اللاحقي في الفقه، و”ألفية بن مالك” في النحو، و”مثلثات قطرب”، ودخل المعركة كلام كثير عن الفرق بين النَظْم “بفتح النون وتسكين الظاء”، والشعر، وبينهما وبين النثر. وتحول الدفاع عن الشعر الحر أو الهجوم عليه لينصب على البناء الشكلي للقصيدة على اعتبار أن الشعر ضمير اللغة ووجدانها، والمساس ببنيته الشكلية يهدم قدسًا من أقداس اللغة وتاريخها.
وفي ظل ضجيج المعركة واشتدادا غبارها تحول أكثر الشعراء الذين بدأوا بالقصيدة العمودية إلى قصيدة
التفعيلة، بل إن بعضهم كان يطبع قصائدهم موزونة دون التزام بشطري البيت، ملتزمين بشيء آخر هو معنى الجملة؛ فجاءت نصوصهم متخلية عن الصورة القديمة للقصيدة واقتربت من الشعرية الجديدة.
وكما زادت المعركة حول الشكل الجديد للقصيدة سخونة استهدفت أيضًا صاحب الريادة لهذا الاتجاه دون اعتبار للدلالة التي يمكن استنباطها من طرح قضية ما، والحقيقة أن الفرق بين أول من بدأ هذا الجديد لا يتعدى شهورًا، وهي فروق طبيعية يقتضيها نشر قصيدة عراقية في بيروت وقصيدة عراقية في بغداد، وثالثة في القاهرة.
كانت أواخر الأربعينيات هي ميلاد هذا الجديد من الشعر، والذين بدأوا هذا الجديد لم يتفقوا عليه أو يقرروه في مجلس أو مؤتمر أو لجنة، وإنما كان طرحهم – في تقديري – تعبيرًا عن متغيرات مجتمعية وعناصر معرفية أضافت إلى ثقافتنا العربية وتطلبت هذا التغيير، ولنضرب مثالًا على ذلك ما حدث في الغرب في مطلع القرن العشرين؛ ثلاثة كتاب عاشوا في عصر واحد ولم يلتق أحدهم بزميليه ولكنهم أنتجوا أدبًا جديدًا متشابهًا في رؤيته وحرفيته وفنيته، ونخلص من هذا إلى أن هؤلاء الكتاب أنتجوا شيئًا جديدًا بفعل مؤثر جديد، قد يكون اجتماعيًا أو معرفيًا، هذا ما حدث مع أعظم رواد الرواية الحديثة في مطلع القرن العشرين: دوروثي ريتشاردسون ومارسيل بروست وجيمس جويس؛ صناع ما صار يعرف في النقد برواية تيار الوعي التي كانت نتيجة متغيرات كثيرة في المعرفة، منها اكتشافات فرويد في علم النفس ودارون في علم الأحياء وماكس بلانك مؤسس الفيزياء الحديثة، وتجلى ذلك في تحول كبير في سائر الفنون لا في الأدب وحده وأنتج مدارس جديدة في الفن.
فأي تفسير كان يجب أن نقف عنده أمام هذا الجديد – في حينه – في القصيدة الشعرية؟
في تقديري أن الشعر منذ بدأ نهضته الحديثة على أيدي: البارودي وشوقي وحافظ ومطران بدأ يحرك في الشعراء موجات جديدة تحاول النفاذ إلى سطح العبارة لتعبر عن أحاسيس مختلفة لم يألفها الشاعر العربي، وقد ظهر التململ بوضوح مع محاولات كبار الشعراء من الرواد ترجمة النصوص المسرحية الشعرية إلى العربية، هكذا حاول: مطران ومحمد فريد أبوحديد وعلي أحمد باكثير، فكل منهم أراد أن يترجم الشعر المسرحي الإنجليزي بالشعر العربي، لكن الميزان الشعري كان حائلًا بين المترجم وعمله لأنه يحول الدراما إلى غنائية القصيدة.
وفي محاولتهم البحث عن حل لإدخال الدراما إلى الشعر العربي ابتكر محمد فريد أبوحديد “الشعر المرسل” محاولة منه للانعتاق من قيد القافية مع المحافظة على الميزان الشعري. ثم خطا باكثير خطوة أبعد من ذلك حين اهتدى إلى ما يعرف في الشعر العربي بـ “البحور الصافية” أو البحور التي تكون على تفعيلة واحدة متكررة، كما في بحور: “الكامل” و”الوافر” و”الرجز” و”المتقارب” و”المتدارك”.
لكن ألزم باكثير نفسه بالتفعيلة، ولم يلتزم بعدد تفعيلات البيت، بل ترك الأمر للمعنى، قد يقل وقد يزيد عن العدد المعروف للبيت، وبنى من خلال هذه التجربة مسرحيته التاريخية “أخناتون ونفرتيتي”، ودعا الشعراء إلى الاجتهاد في البحث قائلًا: “اخترت البحر الكامل وعليكم إعمال الجهد للتوسع في هذا المجال”.
فالالتزام بالتفعيلة دون تقيد بعددها كان الخطوة التي مهدت لظهور الشعر الحر، فهو لم يخرج على الميزان لكنه النزم بالتغعيلة دون التقيد بعددها، وإن كان الشعراء قد توسعوا في التجربة بعيدًا عن البحور الصافية إلى بقية بحور الشعر.
أطلق باكثير على تجربته “الوزن المرسل المنطلق” Running Blank Verse، وقد فعل صلاح عبدالصبور مثل هذا في مسرحيته “مأساة الحلاج” بعد أكثر من عشرين عامًا على تجربة باكثير، فقد ذكر في تذييل المسرحية ما يأتي: “وقد واجهتني مشكلة الموسيقى، ولأهل الولع بالعروض أقول إني استعملت في مسرحيتي هذه أربعة ألوان من التفاعيل؛ أولاها تفعيلة الرجز (مستفعلن) بما يجوز أن يدخلها من التحويرات. ثانيًا تفعيلة الوافر (مفاعلتن) وقد كان العروضيون الأقدمون يجيزون فيها إسكان الخامس المتحرك فتصبح (مفاعيلن)، ولكنهم يستكرهون حذف السابع لتصبح (مفاعيلُ)، وإن كانوا لا يحرمونه.
وقد وجدت اللغة الممسرحية تحبه وترتاح إليه أحيانًا. ولعل هذا ما أريد أن ألفت النظر إليه وهو أن الكتابة للمسرح الشعري ستدخل على موسيقى العروض نوعًا من القوانين. وثالثها تفعيلة المتقارب (فعولن)، ورابعها تفعيلة المتدارك (فعلن) المحورة من (فاعلن). شاع استعمال هذه التفعيلة في شعرنا الحديث وهي أقرب إلى لهجة الحوار من (الرجز) وفيها موسيقية راقصة خاصة إذا تكونت من متحرك فساكن، ولكنها إن حركت آخر حروفها أحيانًا أصبحت ذات إيقاع جاد وانكسرت الحركة الراقصة لتحل محلها تناوبات موسيقية متماوجة، وتحريك الحرف الأخير يمارسه جميع من يكتبون الشعر الحديث رغم تحريم الأقدمين له.
وهذه هي المحاولة الأولى ولا شك أن المسرح الشعري سيطور عروضه”.
فالدور الذي قام به صلاح عبدالصبور في محاولة تطويع الميزان الشعري لمقتضيات المسرح، وحاوله من قبله باكثير وغيره، إنما يدل على حالة القلق الفني التي كان يشعر بها ذلك الجيل الجديد من الشعراء نحو ضرورة أن يتطور الشعر شكلًا ومعنى.
ومما يدل على إذكاء الجديد لحيوية الشعر وتطوره أن القصيدة اتجهت نحو الدرامية متخلية عن الغنائية المسرفة، مقتربة من روح العصر الحديث الذي يواجهه الإنسان بالسؤال المستمر وبطلب المعرفة والحيرة أمام جبروت الطبيعة وتحدي الإنسان، فصار الشعر في مجمله مشغولًا بإنسانية الإنسان ووجوده بعد أن كان مسخرًا لمدح أو استعطاف وتوسل أو حكمة وغزل.
وسرعان ما ركب الشعر مركبته الجديدة وسار بعيدًا في بحثه عن ذاته مع كوكبة من الشعراء الذين التقطوا هذا التحول وعبروا عنه ومن خلاله، فكانت نازك الملائكة والبياتي والسياب في العراق، وصلاح عبدالصبور في مصر، وآخرون.
انطلق صلاح عبدالصبور منذ صدور ديوانه الأول “الناس في بلادي الصادر عام 1957 عن “دار الآداب” في بيروت بقوة دفع صاروخية وحلَّق بعيدًا كالشهاب متخذًا مداره في سماء المدينة العربية المعاصرة، ساعده على ذلك التفوق، ثقافته العربية العميقة التي لم تتوقف عند كتب الأدب بل اتسعت لتشمل الفلسفة وعلوم النقد والبلاغة ومدارس الفقه وتغرب مع الفكر الغربي في أدبه الأوروبي وتشرق مع فكر الشرق القديم حتى تصل إلى جوهر حضارة الهند.
كان هذا التنوع الموسوعي بالإضافة إلى موهبته الفذة سر نبوغه وفرض شعره على ساحة الأدب العربي في مصر وخارجها ليصبح واحدًا من أقطاب الشعر الحر في العالم العربي.
كان صلاح عبدالصبور متأملًا مفكرًا، وكان يستخلص مواقفه الشعرية بعد تأملاته الطويلة لتخرج في سياق حركي درامي. خذ مثلًا قصيدته “الناس في بلادي” يقول فيها:
الناس في بلادي جارحون كالصقور
خطاهمو تريد أن تسوخ في التراب
ويقتلون، يسرقون، يشربون، يجشأون
لكنهم بشر
وطيبون حين يملكون قبضتي نقود
ومؤمنون بالقدر
فهذه السطور الشعرية ليست وصفًا لحال الناس ولكنها نفاذ إلى حقيقتهم بكل ما فيها من بؤس وصبر وقسوة وطيبة. هكذا يبدو صلاح عبدالصبور في تحليل أبناء قريته، فهم يجمعون الشيء ونقيضه بقدر ما تقتضيه الظروف، وبحسب ما يمرون به من حال، فهم أبناء الفطرة الذين يمثلون تربة الأرض وطينتها.
وتتجلى فلسفة صلاح عبدالصبور في دواوينه الشعرية المتتالية في موقف ثابت هو “الإنسان المتأمل المنكسر”، أما موضوعاته فمتغيرة تخاطب الإنسان البسيط في القرية والمدينة؛ فالفلاح بطله وفقراء المدينة رفاقه.
خذ مثلًا هذه الجملة:
“يا صاحبي إني حزين”
هذه الجملة صارت “مانيفستو” الشعر الحر وبخاصة تلك العبارة التي يقول فيها:
“وشربت شايًا في الطريق
ورتقت نعلي”
كان المتهكمون من هذا الجديد يرددون هذه العبارة للسخرية من هذا الشعر الجديد، فلم يألف الشعراء أن يعبروا هكذا عن انكساراتهم، ولعل هذا هو ما جعل المسافة تذوب بين الشاعر وجمهوره الجديد من القراء.
وفي ديوانه الثاني “أقول لكم” نحا نحو الفكر الغربي في أجلى تجاربه عند شعرائه الكبار من أمثال “ت. س. إليوت”، و”و. ب. ييتس”، وكانت قصيدة “الظل والصليب” هي التعبير عن هذا التحول.
وفي “أحلام الفارس القديم” اتجه إلى التجربة الصوفية واستلهمها قناعًا ينفذ منه إلى نقد الواقع الذي كان يستشعره بالرغم من موجات التفاؤل الزائف، فكانت قصيدته “مذكرات الصوفي بشر الحافي” أيقونة لعمل مسرحي سيخرج به صلاح عبدالصبور من خلال تجربته كأعمق وأعظم ما يكون الفن وهو يحول الواقع إلى رمز فني رفيع.
وكان ذلك في مسرحية “مأساة الحلاج”. كان “الحلاج” شخصية تاريخية من شخصيات القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع، وكانت للحلاج مقولاته في تحليل عصره، ولم يقبل زبانية العصر مقولاته فاتهموه بأنه مثير للفتنة؛ فكلامه له ظاهر وباطن محير، وهم يريدن للكلمة أن تكون عارية من أي مدلول.
يقول “الحلاج”:
يا شبلي
الشر استشرى في ملكوت الله
حدثني. كيف أغض العين على الدنيا؟
إلا أن يظلم قلبي
فمثل هذا الكلام عند زبانية الحاكم يعد تعريضًا بالحاكم ورجاله وتهييجًا للعامة على الخاصة وهي أمور لا يحمد عقباها، فلا بد من محاكمة الرجل المحكوم عليه سلفًا قبل بدء المحاكمة.
يقول القاضي أبو عمر:
يا حلاج.. أتدري لم جئت هنا؟
الحلاج: ليتم الله مشيئته يا سيد
أبو عمر: هذا حق
والله تبارك وتعالى
قد ثبت في كف خليفتنا الصالح – أبقاه الله – ميزان العدل وسيفه
الحلاج: لا يجتمعان بكف واحدة يا سيد
أبو عمر: مولانا لا يدفع عبدًا ممن ولي فيهم للسياف
إلا إن أحصى ما فرط من أمره
في ميزان الإنصاف
مولانا يدري من زمن أنك تبغي في الأرض فسادًا
تلقي بذر الفتنة
في أفئدة العامة
وعقول الدهماء
تتستر خلف الذقن الشهباء
أو أثواب المجذوبين الفقراء
قل لي ماذا تبغي بهذائك؟
هل تبغي أن يضع المسلم..
في عنق المسلم سيف الحقد؟
الحلاج: لا يا سيد
بل أبغي لو مد المسلم للمسلم كف الرحمة والود
هذا هو الأسلوب الذي استخدمه صلاح عبدالصبور للتمييز بين أهل الحكمة وأهل الحكم أو للتفكير في الأمور بالحكمة واستسهال البعض الآخر لمنطق السيطرة بالقوة. كانت مأساة الحلاج مأساة عالج فيها أزمة حكم عاجز عن استيعاب من يختلف أو يرى غير ما يراه، وقد عالج صلاح عبدالصبور هذه القضية بأقصى درجات الحذر والرمز وهذه قدرة الشعر الجديد على استيعاب المعاني والأساليب بكل ما فيها وبما تحتمله من تأويلات.
لقد نجح أصحاب الشعر الحر في أعادة الروح إلى القصيدة، وتخصيب الشعر العربي بأهم عناصر الشعر وهو الشعر المسرحي أو الدراما كما عرفها شعراء العالم قديمًا وحديثًا.