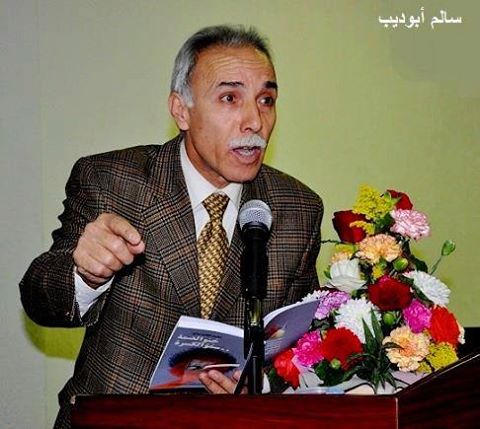لا أذكر أين التقيت، أول مرة، بالشاعر محمد الفقيه صالح، لكني مازلت أذكر الشعور الذي انتابني في ذلك اللقاء السريع. أحسست وكأن نسيماً مر من هنا، فهو كائن بخفة لا تحتمل، وشعره أو كتاباته النثرية، النقدية والفكرية، تتناغم إلى حد كبير مع شخصيته الحانية الهادئة، لكنه الهدوء العميق أو العمق الهاديء، شبيه بذلك الهدوء في أعماق البحر الذي يجعلنا نتمتع بنعومة المشاهد رغم التيارات المتدافعة في أعماقه.
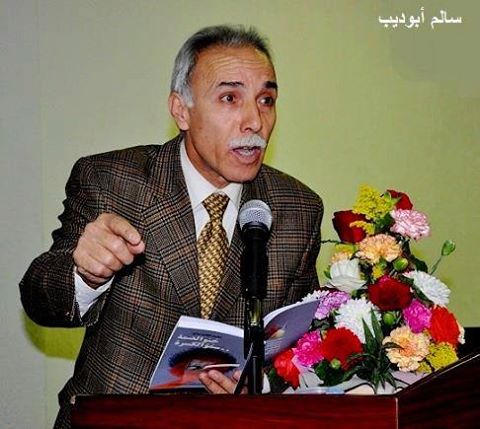
انشغل محمد الفقيه صالح بتقنيات الأسلوب في نثره وشعره، بدقة الصياغة وإحكام الجملة وبناء النص بشكل يقلص فرص الالتباس أو سوء الفهم إلى أبعد حد ممكن. الوقوف طويلا أمام المفردة المناسبة للسياق، ومن ثم الجملة المحكمة لبناء نص متماسك يحاط فيه بالفكرة أو مقصد المؤلف، شكل ظاهرة في النثر الليبي عبر أسماء مهمة، كان الأسلوب ودقة الصياغة أولوية بالنسبة لهم، حيث الأفكار مهما كانت عميقة لا تستقيم إلا في نسق لغوي متقن، يحرص على إنشاء حوار مضمر بينه وبين القاريء. أسماء مثل: عمر الككلي، رضوان بوشويشة، نجيب الحصادي، والمؤسس الكبير يوسف القويري.
ورغم اختلاف المشارب، إلا أن انشغالهم بما يمكن أن أسميه النسق في تقصي الأفكار المطروحة، هو ما يهب أساليبهم ذاك الدفق السلس الممتع، إضافة إلى الروح العلمية في بناء الفكرة ودقة الجملة وما يتبعها، حتى وإن كان النص أدبيا، والأهم من ذلك طرح الفكرة أو الرسالة بأسلوب هادئ، غير مستفز، حواري لا يسيطر عليه صوت واحد، نائين عن الضجيج والصوت العالي لصالح همس يفك براغي الأسئلة بهدوء دون الحاجة إلى الخبط واللبط وإحداث ضجيج الورش البدائية، لتشكل هذه الظاهرة في حياتنا الثقافية ما يمكن تسميته بكًتّاب الظل الذين يتلمسون أسئلة المكان ومحتواه الإنساني في عزلة (ليست مختارة) يفرضها واقع ولع المحيط بالإثارة والأصوات العالية وملاحقة بؤر الضوء التي تلاحق الجعجعة حتى وإن كانت دون طحين، حيث الجلوس على الشاطئ المريح، ومتابعة عروض راكبي الأمواج البهلوانية على السطح، أفضل من مغامرة متابعة أولئك الذين يغوصون في القاع أو يعكرون صفو اليقين وورع الاستسلام للأحكام المسبقة.
ويأتي الشاعر والناثر، محمد الفقيه صالح، كأحد هذه الأسماء التي اتخذت نثر (الاستنارة) مشروعها المتجه إلى تفكيك بِنى التخلف في هذا المحيط المعنيين به دون فصله عن طبقات أفقه الإنساني، سواء أكان هذا النثر فكرا أو سردا، أو كان شعرا مرسلا كما الفقيه صالح، الذي انشغل بتطوير القصيدة العربية في سياق نقلتها الأولى دون أن يتخلى عن تفعيلة الشعر العربي، لكن انشغاله الأساسي كان متعلقا بخطاب وجماليات هذه الحساسية الجديدة، وإثراء نصه بهاجسه التنويري دون أن تفقد القصيدة روحها الشعرية المتقدة، ودون أن يعلو صوتها، أو تكون أداة منبرية، أو سبيلاً لملاحقة بؤر الضوء والنجومية. وحين تكون كتابات الاستنارة في الظل لا يمكن إلا نفكر في مأزق التواصل والتأثير الحري بالاستنارة أن يكون ديدنها، غير أنه من جانب آخر ، من مزايا هذا الظل ما يتيحه من حرية حركة وتدبر لروح التقصي الموضوعي للأفكار المطروحة، دون التعرض لضغوط من قبيل ما تفرضه التنازلات تجاه الجمهور والتمتع بألعاب الركمجة فوق السطح.
الظل كان قدر مثل هذه المشاريع، وفي الوقت نفسه كان مصدر حيويتها وإخلاصها لأسئلتها الحارة، فالكتابة الرصينة تتوجه بطبيعتها إلى الماكثين عند منابعها وليس العابرين. يقول الشاعر محمد الفقيه صالح في قصيدة المفتتح لديوانه “قصائد الظل”:
“دعوني/ أيها العابرون/ قبل أن تدخلوا / ارتدي جبة الملك / وأضع التاج على رأسي / لأجلس / بما يلزم من مراسم / على عرش الظل.”
هذا الملك المكتفي بذاته، دون شعب من العابرين، يؤكد لنا ما يمكن تسميته بمراسم الظل، الذي يميز كتابة الأسماء المذكورة، تلك الأسماء التي تجلس على عرش النثر الليبي دون الحاجة إلى رعية أو هتاف أو أتباع. وتكمن لذتها في هذه الممارسة لفن الكتابة، وفي غزو المسلمات في عقر يقينها، وتقويض المعادلات المكررة، ليس ببراهين بديلة، ولكن بإضاءة زوايا رؤية أخرى خفية لكل مسألة.
هذا النوع من الكتابة الحوارية هي التي تتحسس روح الديمقراطية، ليس كهدف معلن أو غاية فقط، ولكن كممارسة تثبت ديمقراطيتها وهي تؤسس للفضاء الحواري الذي عبره يكون التواصل مع أولئك الماكثين جيدا، أو ما نسميهم بالقراء الأذكياء الذين يشكلون تلك “القلة الهائلة” التي يهدي إليها الشاعر الأسباني “خيمنيز” أحد دواوينه الشعرية.
على مر التاريخ مورست أفكار الاستنارة داخل هذه القلة الهائلة التي جعلتها تتفاعل داخل مختبر المعرفة قبل أن تتوجه عبر النخب التي تتبادل الأدوار صوب العقول الكسولة التي عادة ما تشكل غالب المجتمع. فالاستنارة شأن نخبوي، لكن إدارتها فيما بعد شأن إجرائي تتكفل به تلك النخب التكنوقراطية المثقفة التي تجعله من ضمن خطط المؤسسات المعنية بالتنمية البشرية، ومن هنا جاءت مشاريع الرؤى الاستشرافية كخطط مستقبلية للكيانات الاجتماعية، والتي غالبا ما يقوم بها مختصون في الفلسفة وعلوم الاجتماع والاقتصاد وهم ـ فضلا عن كونهم مختصين ـ مثقفون مطلعون ومهجوسون بالشأن العام.
عملتُ رفقة نجيب الحصادي ومحمد الفقيه صالح في قطاع الثقافة والعلوم، ضمن فريق مشروع «ليبيا 2025 رؤية استشرافية» الذي موله وأشرف عليه مجلس التخطيط الوطني برئاسة د. محمود جبريل نهايات العشرية الأولى من الألفية الثالثة.
وكنا وقتها أكثر انشغالا بالصياغة اللغوية النهائية لهذا المشروع، فحضرت بديهة الشاعر محمد الفقيه صالح المدربة بقوة لتبديد الالتباس في كل جملة، وكان غالبا ما يكون ملاذنا حين البحث عن أدق مفردة في أدق صياغة.
لم يكن معنا محمد حين تلقينا ورشة عمل، في دبي، حول آليات كتابة السيناريوهات المستقبلية للدول، يرأسها أحد أساتذة الفلسفة الكبار، والذي قال في مقدمة شرحه لجوهر الرؤى الاستشرافية وكتابة السيناريوهات المستقبلية، ما مفاده: أن الخيال ضرورة في مثل هذه المشاريع ومن المفترض أن يكون ضمن فريق التخطيط شعراء وفنانون.
وكان الشاعر محمد الفقيه صالح حاضرا بنفاذ بصيرته، وبخياله ودقة صياغاته، في قلب هذا المشروع الذي اعتبره، المدونة الأهم في تاريخ التخطيط الليبي المستقبلي.
______________