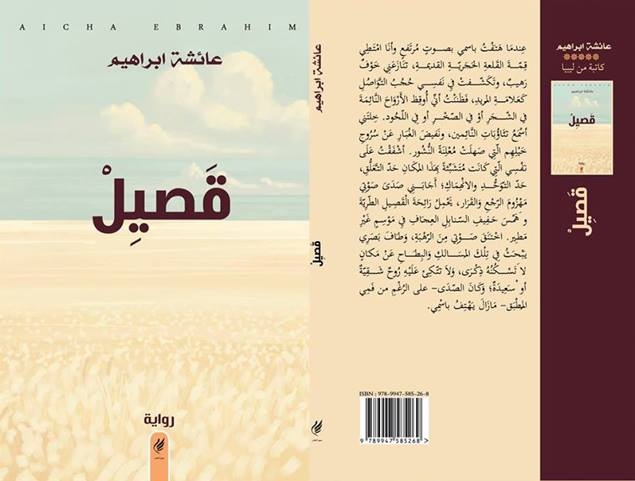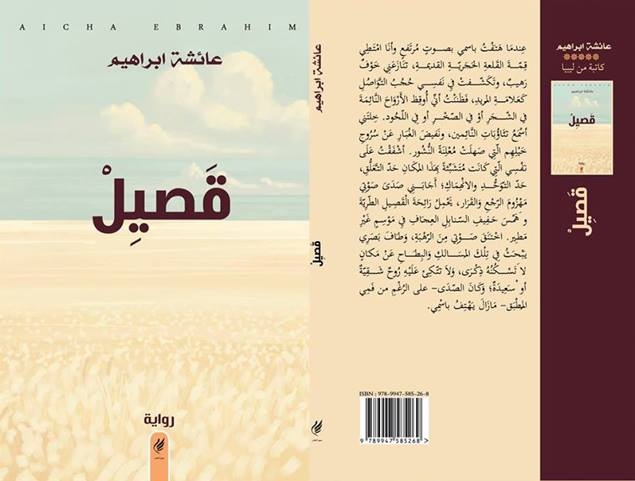وأنا أقدمُ مخطوط هذه الرواية على صفحتي في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بتاريخ 27 أغسطس 2016 قبل صدورها، كان لدي إحساس بأن المكان فيها قد اخترقني بقوة وهزني بعنف وهو يتجلى ويتباهى بين سطور الرواية، ويتماوج على صفحاتها قابضاً على عناصر التشويق كافة، سواء من خلال تنقلات البطل (قصيل) أو وصف الساردة ومبدعة الرواية الأستاذة عائشة إبراهيم وهي تخوض غمار تجربتها الروائية الأولى بعد مشوارها مع عدة نصوص قصصية أبانت فيها عن موهبة إبداعية في تطريز الحدث وإدارته بتقنية معتبرة.
ويعد المكان في العمل السردي عنصراً مُلهِماً للمبدع في تأثيت نصه، وتحريك شخصياته، ينعكس تأثيرُه الواضح وبصمتُه المميزة من خلال ظلاله وامتداداته المتعددة سواء في ثنايا النص أو خارجه. وقد أطلق النقادُ تسميةَ الفضاء الروائي على المكان في الرواية، مثلما أطلقوا الزمن الروائي على زمن الأحداث التي تدور فيها وتنسجها شخصيات الرواية، ثم جمعوا الاثنين في كلمة اصطلاحية سمّاها “ميخائيل باختين” (الفضاء الزمكاني) وصف فيها علاقة الزمان والمكان في الرواية بعلاقة الجزء بالكل، وصعوبة الفصل بين هذين العنصرين رغم تباين أهميتهما وتأثيرهما في العمل الروائي(1).
فصور المكان المادية الواقعية أو الافتراضية التخيلية تختلف وتتفاوت بحسب رؤية المؤلف لمسارات النص ومنعطفاته، مع الاتفاق على أن المكان الجغرافي حسب خطوط الطول والعرض هو ثابت لا يتغير على الدوام فوق سطح الكرة الأرضية، بينما الفضاء المكاني في العمل الروائي فهو متحرك بفعل تتابع التاريخ وأحداثه، وشواهده وعناصره المتبدلة، التي تشكل وتفرّخ بيئات تتفاوت في طبيعتها التكوينية وتأثيراتها الحسيّة.
فالبحر كفضاء روائي في رواية “مرسي ديله”(2) للأستاذ عبدالفتاح البشتي برز خلال تأملات “سوف” بطل الرواية أثناء زياراته لكوخ “بن عيسي” على شاطيء المرسى، مغايراً كلياً للبحر كما استنقطته رواية “أسطورة البحر”(3) للدكتورة فريدة المصري حين جعلته رمزاً وشاهداً فاعلاً من خلال أساطيره التاريخية على جمال المدينة بطلة الرواية وموطن سحرها. كما أن فضاء مدينة طرابلس الروائي بشوارعها وشخصياتها وأحداثها في رواية “ليالي نجمة”(4) للأديب الراحل خليفة حسين مصطفى الذي وثّق فيها ما يدور بشارع “سيدي عمران” سيء السمعة، ظهر مختلفاً في رواية “العلكة”(5)للأديب منصور بوشناف الذي جعل من حديقة شارع البلدية وسط مدينة طرابلس مسرحاً يبث الروح في ثمتال روايته، لإذابة الجليد وتحريك العلاقة الزمنية بين “مختار” و”فاطمة”. أما الصحراء كفضاء مكاني مكتظ بالعديد من الصور والأمكنة الثانوية، فقد امتد في رواية “حقول الرماد”(6) للأديب الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه متجاوزا أفق صحراء البدوي الضيق، فصار شاسعاً منفتحاً يتسع لمقارنات الأغراب بين صحراء القيظ والعطش والغزلان والنفط، وصور حضور سيوف رمالها وكثبانها وأغبرتها في مخيلتهم المغايرة، وهو فضاء مختلف تماماً عن تلك الصحراء القاتمة المنغلقة، التي تقوقعت وغاصت في ذاتها وكهوفها المخيفة العميقة، كما صورها الروائي إبراهيم الكوني في روايته “المجوس”(7) التي سيطرت عليها طقوس وعادات وأساطير المكان، وطلاسمه وأحاجيه وأسماؤه الغريبة.
إن المكان في العمل الروائي ليس مجرد لوحة ديكور أو خلفية مسرحية جامدة لا تتفاعل مع النص، بل في تصوري هو العنصر الأكثرُ جاذبيةً وتشويقاً لاستشفاف مكونات النص المكتوب، وذلك لتعدد الايحاءات والصور التي يبوح بها ويبرزها، لدعم ومساندة مضمون الرسالة أو الحبكة الروائية النصّية، سواء بحضوره الشكلي الراهن، أو بأزمنته الماضوية أو أحداثه التاريخية أو شواهده المتعددة، وفي كل الأحوال فالمكان لابد أن يتفاعل مع مضمون النص لكي يستريح بكل أريحية في ذهن وخيال القاريء، ويفجر فيه العديد من الأسئلة المحفزة، وإيقاظ رغبته لاكتشافٍ أعمق للرواية.
وتأسيساً على ذلك اهتم النقاد بدراسة المكان حيث اعتبر (إدوين موير) في كتابه “بناء الرواية”(8) أن الزمن يصنع العالم الخيالي لحبكة أو مضمون الرواية، بينما المكان يحتضن الفضاء الخيالي الشامل في كل بيئات النص المتنوعة وحركته داخل الفضاء المكاني بشقيه الوصفي المنقول من الواقع أو الافتراضي الملهم من الخيال أو كليهما.
بعضُ صور الفضاء المكاني في “قصيل”:
برز المكان في “قصيل” فضاءً متماسكاً ومترابط الأركان، متوحداً ومتتابعاً عبر فصول الرواية، وله عناصره التي توطنه كجزء من الهوية الشخصية، ودلالاته المباشرة، وأبعاده وصداه الجمالي الذي جعل له رونقاً وحُسناً وبهاءً، فصار يتفاعل بأكمله في ذهن القاريء، ليُسبغ عليه بدوره من لدُن خيالاته المزيد من التشويق والتعلق والإعجاب. إن الفضاء المكاني في الرواية اتسم بلغته الشاعرية القوية العذبة، الموغلة في البلاغة، والقادرة على اختيار المفردات الدقيقة في وصف الواقع ونقله، وقابلية هذه اللغة ومفرداتِها للإستزادة والإضافة والتماهي في حركة الحبكة النصيّة البليغة، لتتداخل فيها الصور الحياتية المعاشة فعلياً، مع غيرها المستوحاة من رحم الخيال المكتظ بالكثير من التصويرات الجميلة.
ورغم أن مكان ومسرح الرواية هو مدينة “بني وليد” في ليبيا فإن أصداءه امتدت وتوسعت لتغوص داخلياً بشكل عميق في أركان المدينة، وتؤسس فضاءً يشملُ السيل والرصافة والزاوية والملهاد والنخيخ ومسوجّي وسوق الظهرة والعرس والقفة والحكم والأمثال والكواغط والمأثور والصراع الفكري، وغير ذلك مما يحتضنه الفضاء المكاني مزداناً بالسير الذاتية والعادات والتقاليد وغيرها من الصور العامرة بالبهجة والعذوبة، التي ترتبها سياقات سرد العمل الروائي وتصوغها في بوتقة متمازجة كلوحة فسيفساء جميلة تبهر الأبصار وترفع درجة التلهف عند القاريء.
وظهرت أولُ مصافحة للمكان في الرواية كتعريف قصير موجز تُلمّحُ إليه الساردة على لسان بطلها “قصيل” منذ الفصل الأول (السيل) فيقول (.. جلستُ خلف المقود وانطلقتُ بأقصى سرعة متاحة لي على الطريق الترابي المتعرج حول الوادي..) وهنا عرفنا أن المكان هو طريق مترب ملتوي يفضي إلى أحد أودية “بني وليد”، ثم يتواصل التعمق في وصف المكان بشكل أوسع لتهيئة المتلقي للفضاء الروائي (.. تتراصف أشجار الزيتون والنخيل في وادٍ ذي زرعٍ، تتكئ على ضفافِه “بني وليد” المدينةُ المترامية الأطراف، تتداخلُ مبانيها الحديثة مع بيوتها الطينية القديمة المصرّة على البقاء لكأنما ذويها يخشون فراقها..). هكذا هو الفضاء الذي تمتزج فيه العناصر المتنوعة وتتشكلُ لوحةَ محاكاةٍ تصرّحُ بالشجر العتيق المبارك، وتفوحُ بسير التاريخ بكل عبقها، وتفاعلاتِ إيحاءاتِها الماضوية في نفوس البشر. كما أن تسمية المكان نفسه “بني وليد” تحيلنا إليه في الواقع، ومن ثم مقارنته مع صورة الفضاء المحاكى، وهنا تتأسس المفارقة.
ولكي تتميزَ صورةُ الوادي كفضاءٍ روائي وليس مجرد منخفضٍ جغرافي جامد تساعدنا الساردة فتقول (..الوادي ليس هو الوادي، الوادي عالمٌ من الفزع والوحشة والظلام السحيق، تبرقُ فيه عيونٌ غاضبةٌ وفوّهاتٌ مترصدة.. ألمحُها بين جذوع الأشجار. الأشجار التي كانت شديدة الخضرة أصبحت رمادية باهتة.. ذؤابات النخل تغرق في ضباب أسود.. صفيق المطر على ورق الشجر ينشد ترنيمة مخيفة يكسرها البرق ويصفعها الرعد.. يلقى بها رعباً وترويعاً على أضلعي المرتجفة تحت قميصى فترتعش مفاصلي .. تصطك أسناني.. تنحرني آلام مفاجئة بالحلق).
هنا يتجسد فعلاً الفرق البيّن بين الوادي كمكان فحسب، ونفسه كفضاء روائي له عناصره الطبيعية المتفاعلة بين ذواتها أولاً وفي الآخر ثانياً سواء كان الساردة أو الراوي بطل القصة أو القاريء المتلقي. هذا التفاعل أو الاختراق المادي لعناصر الفضاء كالأشجار والمطر والعيون والنخيل، واللوني كالأخضرار والرمادي والسواد، والحسي كالغضب والخوف والترويع والصفيق هو ما يخلق عالماً مشتركاً يقتبس من الواقع الكائن، ويضيف إليه خيالاً خلاّباً بلغة تتراقص مفرداتها الرقيقة لتوقظ جميعُها أحاسيسَ مدفونةً، وتبعثَ أحلاماً وطموحاتٍ مسكونة، لتؤكد بأن الفضاء الروائي ليس هو مكانُ الواقعِ ذاته بل هو فضاء محاكى يتشارك الجميع في نسج خيوطه وبناء أركانه. وحتى وإن صاحب ذلك الفضاء تداخل في السرد بين الراوي والساردة كاتبة الرواية فإن ذلك ليس غريباً، فالعلاقة الوثيقة والمتينة بين المحاكاة والسرد هي رابطة قديمة تناولها العديد من الفلاسفة من بينهم أفلاطون الذي أكد بأن مفهوم المحاكاة هو تمثيل الواقع فنياً، بينما تقنية السرد هي نقل الراوي أقوال شخصياته بلسانه(9).
وصور الفضاء الروائي التي التقطتُها من رواية “قصيل” تؤكد أن الكاتبة استطاعت أن تستنطق العديد من الجماليات المكانية، وتحيك لها ثياباً جميلةً لافتة، وتطرّز بها أجواءً من البهجة والحبور، لتتداعى كلها بثقة قوية وتنساب برشاقة في خيال القاريء. ويمكننا أن نعتبر أن هذا البناء والتأسيس للفضاء الروائي أمرٌ عاديٌ حين تغوص بنا الكاتبة في أجواء الاحتفال النسائي البهية، ومهرجان فتح “القفة” أو “العلاقة” وهو أحد أيام العرس الليبي التقليدي في بيت العروس، لأنها تنهل من معين ذاكرة طفولية وشبابية ونسائية فاعلة في مثل هذه الطقوس والتي قد تكون مارستها فعلاً (.. تقتربُ أكبرُ النساء سناً وتضع يدها في قاع القفة، وتتناول أول قرطاس يصادفها، ثم تفتحه على مرأى الحاضرات، وتسمِّي محتواه بصوتٍ عال: (هذا فاسوخ) .. (هذا سكر نبات)… (هذا كحل) .. (هذا كسبر)… (هذه إخللة)… (هذه إيباري)… (هذا كمون) … ثم يطاف بكل قرطاس على الجالسات فتقتسمُ منه مَنْ لها به حاجة، ومَنْ لم تكن ذات حاجة أيضاً عليها أن تغرس أصابعها في القرطاس تأدباً، ثم يوضع جانباً، وتعاد الكَرّة، فإذا خرج قرطاس اللوبان تتسابق إليه الفتيات اليافعات، وإن كان قرطاس السواك تمد يدها إليه العرائس وحديثات الزواج، أما قراطيس الأعشاب الدوائية كالزعتر والإكليل وحب الرشاد فتطلبها النساء الأكبر سناً؛ إلى أن يأتي دور قرطاس الحلوى وهو من نصيبنا نحن الأطفال المرافقين للأمهات، وقد حضرنا خصيصاً للظفر بحلوى (الشاكار) ذات الخطوط الملونة بالأحمر والأصفر، تسيل ألوانها مع لعابنا وتلتصق بأصابعنا وثيابنا..).
جاءت هذه الصورة التعبيرية التسلسلية المتحركة زاخرة بالموروث الشعبي الذي نقلته لنا الساردة بكل حيادية كشاهدة على ما يجري، دون أن تناصره أو تبغضه، وهي ربما استوحته من وحي مشاركتها في بعض جزئياته والإلمام بتفاصيله، ولكنها تمكنت من انتقاء مفردات لغة رشيقة فاحت بعطور الفاسوخ والجاوي، ولاكت ومضغت حبّات اللوبان وتذوقت قطع حلوى الشاكار، وتعرّفت حتى على تقاسيم وجه المرأة الأكبر سناً، وتبادلت الحكايا ولامست بعض الهدايا، بروح تهفو إلى تلك الحلقة النسوية الدائرية الغامرة بالفرح، والضاجة بالزغاريد والتعليقات الجميلة المتطايرة في سماء تلك الجلسة.
إن هذا الفضاء الروائي انتشت وتراقصت فيه الصورة اللفظية على ألحان أغاني الأعراس الليبية الشعبية الرقيقة، وشذت برياحين فوّاحة عبقة، وتزيّنت بخيوط الحناء المشكلة كرسومات الخطيفة الخفيفة على الأكف والأنامل الرقيقة الناعمة.
وتتواصل جماليات استنطاق المكان في رواية “قصيل” حين نقترب من سباق الفرسان في الملهاد، ونعترف بأن الساردة قد برعت في نقله وتحويله إلى فضاء روائي، ربما لثراء خزانة ذاكرتها الشخصية، وما رصدته في مرحلة الطفولة من صور هذا الحدث الذكوري، ومن ثم استحضرتها في مشاهد نصية مكتوبة، كشف عنها قصيل في الجزء التاسع (القفة) من الرواية بمناسبة زواج أحد أبناء الحي عند وصفه “رضوان” قائلاً (… قبل انطلاق السباق بقليل شاهدتُه وهو يرتدي الفرملة وفوقها الزبون، ثم تدثر في جرد “اللانة” ناصع البياض ووضع الكبوس الأحمر القاني على رأسه، تتدلى منه “شنوارة” اختفى جزء منها عندما تنقب بالجرد، انتعل “البوط” ثم وضع قدمه في “الركاب”، وابتسم واثقا كعادته، قبل أن تغمره جوقة من زغاريد النساء. أعتقدُ أن الملهاد تواصل سبع جولات ذهاباً ومثلهن إيابا،ً وفي كل مرة يستبدلون تشكيلة العقد، فيظهر رضوان تارةً في أقصى اليمين وتارة في الوسط أو أقصى الشمال، ويزداد العقد ويتناقص، ويتخلل الميز حركات رشيقة يؤديها الفرسان واقفين فوق ظهور الجياد، أو باستخدام بنادق قديمة يحملونها للاستعراض ولتجسيد نضال الأجداد ضد الغزاة والأعداء…).
لم تقتصر هذه الصورة الوصفية الجميلة على التعريف بقطع لباس الزي الوطني الجميل ومكوناته وألوانه بل ارتبط سرده وتعداده بالعلاقة الذهنية بين شخصية الفارس القوية وطلته الواثقة، وهيبته التي تمثل المهارة والنبوغ في استعراض إمكانيته وقدراته في التألف مع جواده، وفعل المشاركة في الركض ضمن جوقة الفرسان في الملهاد أو سباق العرس. وكما في صور الفضاءات الروائية الأخرى في قصيل، ظل قاموس الساردة ثرياً بمفرداته المميزة والخاصة بلكل فضاء، والتي نراها هنا في “الركاب” و”العقد” و”الميز” واستطاعت باستحضار هذه المسميات أن توثقها في النص، وتستنطق بها جماليات الفضاء الذي اختلطت فيه زغاريد النساء المتابعات للملهاد بنظرات عيونهن المكحلة الجميلة، المحجوبة وراء السواتر القماشية، مع صهيل الخيول الراكضة وأنفاس الفرسان المتحفزة، فأحسستُ في هذا الفضاء بأغبرة كثيفة متطايرة، وزغاريد بهيجة مدوية، ودعوات صادقة بالمغفرة والرحمة للشهداء من الأجداد، سابحةً في السماء. إن جماليات هذا الفضاء الروائي، وإن افتقد بعضَ جوانبه مثل مشهد هدايا “الرمي” وصوت “البرّاح” الذي يعلن عنها متبوعاً بزعاريد النساء، لا تجعل الأحاسيس المتوثبة والذكريات المستيقظة تظل واقفة عند الأعتاب، بل تنعشها وتحنو عليها، وتطلقها تتسربل في وقائع المشهد، وتنصهر بكل أريحية بفعل بلاغة التصوير وإيحاءات اللغة، لتبث الحياة في الوجدان، والحركة في الأبدان.
وبعد صور المشاركة النسوية الفعلية والمشاهدة الطفولية تأتي الصورة المبهرة والخلابة، التي بالتأكيد لا تمت بأية صلة للعالم التجريبي أو ممارسات حياة الكاتبة الشخصية، ولا يمكن أن تكون قد شاركت فيها، سواء في مرحلة الطفولة أو ما بعدها، لأنها مناسبة ذات صبغة دينية تخص الذكور دون غيرهم، أطفالاً صغاراً، وشباباً يافعين، ورجالاً مدركين، ولا يمكن أن تكون قد ولجت فضاءها الدوري الموسمي، الذي يتعاقب تنظيمه داخل الزوايا العيساوية أثناء المناسبات الدينية خاصة ذكرى المولد النبوي الشريف، وبالتالي فإن كل ما نقلته وصورته في هذا الفضاء المكاني، الذي كان مرتعاً لي في فترة من الفترات السنيّة المبكرة وكنتُ فاعلاً فيه بالمشاركة في قراءة حزب البغدادي ومولد البرزنجي، كما استمتعتُ بنقر “الباز” وتلذذتُ بخلطة “الخمرة” ومشروب اللوز وغيرها، لذلك فهو بلا شك قد اخترقني بعمق، وحملني وأعادني إلى تلك الفترة العمرية، وأبهرني بوصفه الدقيق وتفاصيله المحببة، والتي ليس من السهل تناولها لغير العارفين بها، وذلك حين روت على لسان بطلها قصيل (… بحلول ذكرى المولد ارتدت الزاوية حلتها الجديدة بعد أن طلينا جدرانها بالجير ودهنّا نوافذها وبابها بالطلاء الأخضر الزاهي، وغسلنا الحصران والمنادير ونشرناها في الشمس، وبدّلنا السناجق البائدة بأخرى جديدة ترفرف فوق القبة الصغيرة التي تأخذ شكل هرم رباعي، وكان الصغار من الصبيان قد رشّوا الباحة الخارجية بالماء لتهدئة ما قد يتصاعد من غبار، وملأوا جرار الماء وأضافوا إليها روح الورد، وأشعلوا مواقد الفحم. مع المغيب فاح عطرُ الجاوي يغمرُ الشارعَ القريب من الزاوية، وتوافد الرجالُ حالقين متعطرين لابسين ثياباً جديدة، وبعد أصطفافهم في صفين أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، طاف عليهم الصبيان بالمشروبات والكعك والمقروض الذي أرسلته النساء، وبدأت حلقةُ الذكر بعد صلاة العشاء، أُستفتحت بتلاوةِ القرآن ثم قراءة الحزب الكبير، وبدأنا بترديد “لا إله إلا الله” ببطءٍ في البداية، ثم بالإسراع..).
إن براعة وقدرة الساردة في نقل وتطريز جمالية هذا الفضاء الذكوري المسكون بالروحانيات الدينية العميقة أحالتني إلى مقالة للدكتور غالي شكري أستاذ النقد الأدبي في الجامعات المصرية حين تناول رواية الأديب الليبي صالح السنوسي (متى يفيض الوادي؟)(10) التي تدور حول أحداث وأجواء حرب أكتوبر 1973 في مصر وما كتبه عنها قائلاً (… صالح السنوسي يدري عن الحياة المصرية، بشقيها العسكري والمدني، ما قد لا يدريه الكثيرون من الكتاب المصريين أنفسهم.. وفؤجئتُ حقاً حين علمتُ أنه لم يشارك في الحرب، ولم يذهب قطٌ إلى مصر..)(11). وهنا أيضاً فالساردة تدري عن تفاصيل طقوس الزاوية العيساوية وترتيبات واستعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فيها، أكثر مما يدريه العديد من الليبيين الذكور الذين يعشقون متابعة مشاهد خروج الزوايا في المولد النبوي الشريف “يوم الطلوع”، مما شكل لي مفاجأة مماثلة لتلك التي عبّر عنها الدكتور غالي شكري، وهو ما يؤكد أن الكاتبة تملكُ حساً ورؤية امتدت وتوغلت بعيداً، وغاصت في أعماق الحدث، فأمتلأت به ومنه، بروحانيات الفضاء المكاني ثم تهاطلت غزيرة، وفاضت بمدادها وصورها التعبيرية والوصفية الجميلة، مما يجعلنا نؤمن بأن الإحاسيس الواعية والمشاعر المتعمقة، قد تتحول إلى إرادةٍ فعليةٍ إبداعيةٍ تتجاوز جميع أسئلة التعجب التي تُبعثُ في عقولنا وتظل تطوقنا بتقريعها المحير.
وكما كان لتقاليد العادات الشعبية الإحتفالية، وطقوس التراث الديني، حضورٌ مكثفٌ وغزيرٌ في فضاء “قصيل” الروائي، سجل التاريخُ الليبي المجيد للمكانِ العتيق، بروزه ومشاركته وتضمينه في هذا العمل الروائي الممتع، حين نفضت الساردة الغبار عن بعض صفحاته المطوية، واستحضرت أسطورة “قرزة” مملكة التخوم التليدة في مدينة “بني وليد”، وكأنها جرسٌ يدق على جدران ذاكرتنا الصدئة، ويضيف للنص الكثير من التوثيق والبهاء والإمتاع، واستنهاض الهمم، للإيمان بفاعلية ذواتنا الإنسانية، ووطنيتنا وهويتنا الليبية، ورصيدها التاريخي الزاخر، وإضافاتها الجليلة للموروث والحضارة البشرية كافة، حين تحدث الورّاق عن تلك الحقبة التاريخية قائلاً(..وأصبحت مدينة قرزة في “بني وليد” خلال القرن الثالث للميلاد عاصمةً للتخوم، وتمتعت رغم الوجود الروماني بحكم محلي حكمته أعرافُ سكانِها المحليين وتقاليدُهم، حيث عبدوا “قورزيل” أو “آمون الليبي”، وبنوا آلاف “المسلات” وبرعوا في المنحوتات التي تصور حياتهم اليومية، وطقوسهم الاجتماعية، وأعمال الحرث والرعي والحصاد، ومازال سكان “بني وليد” مصرين على سرد تلك الأسطورة حول خسف “قرزة” وتحويل كلِّ ما فيها إلى حجرٍ جامدٍ، الناس والشجر والدّواب، متوهمين أن الغضب الإلهي قد حل بساكنيها فتحجّرت كلُّ تفاصيلِ حياتِهم لتصبح مسخوطاتٍ حجريةً، تتناثر في الجبال والوديان والشعاب الجافة المهجورة…).
إن الساردة لم تعرض الأسطورة المكانية القديمة مجردة ومنعزلة أو منفصلة زمنياً عن محيطها البيئي، بل مترابطة في تواصل مستمر زمنياً بين تراث وأمجاد الماضي، وحكايات وتأويلات واعتقادات سكان الزمن الحاضر في “بني وليد” ودور تلك الأسطورة فيما حل بالمدينة من نكبات وآلت إليه من مصير بائس.
وليس هذا فحسب بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حين أضافت من حاضرنا الراهن لهذه الأسطورة بعض أسماء الأكلات الليبية الفريدة المعاصرة، ومفردات الأمثال الشعبية الموروثة حين تناولت حكاية زواجِ أحدِ ملوك “قرزة” من ابنته التي تميزت عن جميع نساء “قرزة” بطول شعرها، وعُدت بذلك الأجمل بينهن، فقرر الملك الزواج بها وتنظيم حفل عرس بالمناسبة كما تصفه الرواية (..في يوم العرس المشهود سيقت الذبائح إلى القصر، وجاء المهنؤون وامتطى الفرسان الخيل مظهرين الزينة والابتهاج، وحفلت النساء بحلي الفضة، وملأت القدور باللحم ووضعته على النار، وعصّدت البازين استعداداً لوليمة الزفاف. كانت العروس تبكي على ركبة أمها فترد عليها الأم مطمئنة: يا بنيتي، ما طاب اللحم لين ربي رحم….).
وكأن الكاتبة تريد التأكيد هنا بأن أكلة البازين الشعبية ضاربة جذور أصولها في القدم إلى تلك العهود الليبية البعيدة، وترسيخ ذلك في أذهاننا كدليل على صمودها وتواصلها عبر التاريخ، ووجود الأكلة الآن بصمةً من بصمات الهوية التي انصبغ بها ذاك المكان، مثلما تُرجع اللهجة والمثل الشعبي الليبي السائد إلى تلك الحقبة القديمة. وكل هذا بالتأكيد يشكلُ إثراءً باذخاً ومثيراً للفضاء الروائي الشيق، ومحفزاً للإبحار في الكثير من التساؤلات الفكرية والتجاذبات غير المحدودة.
كما تستعرض الرواية بعض الأفكار المتضاربة والصراع بين مناصري الحداثة والأصالة والقديم والجديد ومعارضيها، في مشهد إزالة الجرافات للمريقب أو الرُصافة وهدم المسجد القديم، جراء الطمع والجشع الذي أفرز سلوكيات التحايل والتزوير، وتزييف وثائق تبوث الملكية التي تولاها الورّاق. وتسجل الساردة بكل صراحة موقف “قصيل” العاجز عن حماية مكانه وإرثه التاريخي، واعترافه بذلك بكل حرقة وألم، حين ظل واقفاً حزيناً يشاهدُ الجرافات الثقيلة وهي تتحرك لجريمة الهدم ومحو التاريخ (..كانت الجدران تنظر نحوي بأسى وعتب، تقترب من لحظة النهاية مثل جديٍّ يساق إلى المذبح، وكنت أعرفُ أنني لن استطيع أن أنقذها، ولا أن أنقذ المعصرة من جبل الفولاذ القاسي الذي يجثم بين عجلاتها، ولا أن أخلص الرُصافة ورُكحَها الباردَ الظليل من غاشمٍ يوشكُ أن يقتلعها من مربضها الذي نبتت فيه منذ أن قامت الدنيا..).
ويواصل “قصيل” بلغة الدهشة والاستغراب والحيرة (.. حين اقتربت الجرافات من مزار الشيخ سمعتُ صوت البندير الضخم ينقر بيد قوية نقراً يجلجل الأرجاء، لكن أحداً لم يستطع فهم الجواب، وكانت مئذنة الجامع تهتز مستنجدةً، وترفع أذاناً بصوت مجهول، ينطلق مرتعشا في بدايته ثم سرعان ما تعلو وتيرته فيتدفقُ على إثرها المصلون الذين هبّوا مسرعين، ينفضون عنهم غبار القبر، ويُبعثون في صيحة واحدة أجيالاً تمتدُ خمسمائة عام. بعضُهم كان متنقباً في جرده، وبعضهم متدثراً في إزار فضفاض، ويعتمرون قبعاتٍ وبرانيسَ مختلفةَ الأشكال، سمعتهم يكبرون تكبيراتِ العيد وهم يتقدمون بخطوات وئيدة نحو باب الجامع. حين دخلوا رتبوا صفوفهم فوق السجاد، وأقاموا الصلاة…).
ونلاحظ في تفاصيل هذا الفضاء السردي الاستعجال الذي وقع فيه “قصيل” عند وصفه حالة الهلع والارتباك التي اجتاحتهم، وانتفاضتهم المفاجئة لحماية الجامع العتيق من الهدم والاحتماء فيه، حيث تسرع “قصيل” وشبّه تكبيراتهم بتكبيرات العيد مع أنهم غارقون في الآسى والحزن والخوف، بينما تكبيراتُ الأعياد تتجلجلُ في السماء، وتصدحُ بها نفوسٌ فرحة، تغمرها البهجة والمسرة احتفالاً بقدوم المناسبة الدينية العظيمة، ولو تجاوزنا هذا التفسير إلى آخر، يقول إن تلك الفرحة قد غمرتهم وهم يستفيقون من سُباتهم، ويهبّون هبّة رجلٍ واحدٍ، يتعزز ويتقوّى باللجوء إلى الله بالتكبير والصلاة لإنقاذ تاريخهم وإرثهم، فإننا لن نَبخسَ النصَّ روعةَ وصفهِ، وسعةَ أفقهِ، وقابليتَه للتأويل.
ولم يغب المونولوج الداخلي الغارق في الألم والأنين، والمصبوغ بالقتامة والسواد، المنبعثِ من وخزات السؤال الفكري العميق والمباغث والجريء، الذي ظل مكبوتاً في الخارج، لكنه انتفض في أعماق “قصيل” دون أي صدى فعلي، حين همس إلى نفسه في آخر الرواية بكل مرارة (… استغربُ كيف وصل بنا الغرورُ ليس فقط إلى حدِ إلغاء أثر وشواهد الآباء والأجداد، بل إلى حدِ إلغاءِ حقِ الأجيالِ القادمة في أن يكون لهم امتدادٌ، صريحُ الملامح والتفاصيل.. وباغتني تساؤل منْ نحنُ لنعتقدَ أنَّ هذا الإرثَ الإنساني بمبانيه، وحجيراته العلوية وسلالمه الحجرية، ومسجده العتيق، هو ملكٌ لنا وحدنا، نتصرفُ به كيف نشاء، ونقررُ هدمَه متى نشاء .. وكيف يصلُ بنا الغرورُ حدَّ الاعتقاد بأننا نملكُ زِمام التحكم بسجلِ التاريخ، فنمحوُ صفحاتٍ ونمزقُ صفحاتٍ أخرى، ونحيله إلى مادةٍ مشوهةٍ مبتورة، مفرّغةِ الروح، تائهةِ العبق.. وكيف ننصبُ أنفسنَا قُضاةً نُصدر أحكامنا على متهمٍ بالشيخوخة في غياب الدفاع، وفي غياب وثيقة القانون…).
أسئلةٌ عميقة ومشروعة لم تلقى أية إجابات صريحة في متن هذه الرواية التي مثلما استهلت فصولَ أحداثِها بجماليات المكان ووصفه ودلالاته، تختتم فصلها الأخير بالتأسي على ما آل إليه الوادي، مسرح مجرياتها ووقائعها، بعد أن استوطنه الخراب والفناء وجرفه الموت من الذاكرة كما أشار إليه “قصيل” وهو يغرق في الحزن (… حين استوت الأرضُ تشابهت حدودُها وأصبحت مثل قطعة من الخلاء، أو مثل جنينٍ مشوّهٍ سقط فجأة من رحم أمه ومات، ولم أستطع تمييز المكان الذي أقفُ عليه.. لم يكن الرصافة، ولا قواعد الجامع العتيق. أحزنني أنني لم أتعرف على المكان الذي انعزل فجأة عن الذاكرة…).
إن الفضاء الروائي في “قصيل” لا ينكفيء أو ينغلق وينحصر في موقع معين أو مكان واحد ثابت، بل ظل متعدداً متنوعاً، ومتشابكاً متداخلاً في نسيجه الشامل متضمناً الوادي والقرية والبيت والزقاق والمسجد والخلوة والرصافة والدهليز ومسوّجي وزمزم والمقبرة والحوريات والجن والسوق وغيرها. وقد ظلت كل هذه العناصر متعاضدة ومترابطة في سياق مضمون النص، ولا غرابة في ذلك فهي تخلّقت جميعُها من رحمِ الواقع، وذاكرةِ وخيالِ الكاتبة، فحملت صفاتِها الجينية الخاصة، وبصمةَ هويتِها المتفردة والمميزة.
وهذه القراءة الانطباعية العاشقة البسيطة لا يمكنها الغوص في كل جماليات الأمكنة الواردة في العمل الروائي “قصيل” الذي سجل شهادة ميلاده مؤخراً في المشهد الأدبي الليبي، مع اليقين الكامل بأن المولود الأول يحملُ غالباً العديد من الهنّات والخلل والقصور الذي أحياناً يحيد بالنص عن الالتزام بأسلوبية وبنائية الجنس الإبداعي وما يتطلبه من مهارةٍ وتقنية، تُكتسب كلُّها بفعل التجريب والاستمرارية الموفقة التي نأمل أن تؤتي إسهامات أخرى للكاتبة والمشهد الإبداعي.
وأخيراً يظل “قصيل” مولوداً باراً وبرهاناً دامغاً على مسيرة الإبداع السردي النسوي الليبي التي عبّدتها الراحلة زعيمة الباروني بإصدارها أول مجموعة قصصية نسوية في ليبيا سنة 1958 بعنوان (القصص القومي)، وتلتها الأستاذة مرضية النعاس بإصدارها سنة 1972 (شيء من الدفء) كأول رواية ليبية نسوية(12)، وها هو يتواصل المشوار الطويل ويثمر عبر مسيرته الثرية بالعطاء، والزاخرة بالابداع، وسيستمر بإذن الله حتى نرى العديد من الإبداعات التي تتبع “قصيل” وتثبت بأن المرأة الليبية مبدعةٌ وولاّدةٌ للنجباء الأبطال والبطلات على الدوام.
_______________________________________________
(1) الخطاب الروائي، ميخائيل باختين، دار الفكر، ط1، القاهرة، 1987، ترجمة محمد برادة.
(2) مرسى ديله، عبدالفتاح البشتي، مركز الحضارة العربية، القاهرة، 2003.
(3) أسطورة البحر، فريدة المصري، دار الفرجاني، طرابلس، 2015.
(4) ليالي نجمة، خليفة حسين مصطفى، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، 1999.
(5) العلكة سراب الليل، منصور بوشناف، ليبيا للنشر، القاهرة، 2008.
(6) حقول الرماد، د. أحمد إبراهيم الفقيه، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، 1985.
(7) المجوس، إبراهيم الكوني، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، 1428 ميلادية.
(8) بناء الرواية، إدوين موير، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 1965، ترجمة إبراهيم الصيرفي.
(9) معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني، مكتبة بنان ناشرون، دار النّهار للنشر، ط1، بيروت، 2002، ص143.
(10) متى يفيض الوادي؟، صالح السنوسي، دار الآفاق الجديدة، القاهرة، 1980.
(11) قصتي مع القصة، د. غالي شكري، مجلة الفصول الأربعة، ليبيا، السنة الثالثة، العدد 10، يوليو 1980، ص ص 68-77.
(12) معجم المؤلفات الليبية المطبوعة في الأدب الحديث، أ.د. الصيد أبوديب، مجلس الثقافة العام، طرابلس، ليبيا، 2006.
نشر بموقع ليبيا المستقبل