حاوره: عذاب الركابي

الكتابة ُ لديهِ حياة ٌ، رُغمَ أنّها مجبولة ٌ بالمعاناة..، ولأنّهُ يُحبُّ الكتابة َ، فهوَ يراها بمثابةِ الهواء النقيّ الذي يدخلُ إلى رئتيه، فيطهر جسده من أعباء واقع ٍ، لا خلاص منهُ إلا بهذا النزيف – الكتابة..، لهذا أجدهُ يتفرد في صنعتهِ التي يُحبّ، ورُغم أنّهُ بطيء في الكتابة.. ومُقل لكنّهُ مُتميز في إنجازهِ الروائيّ،.. يرى أنّهُ مظلوم نقديا، لكنّهُ لا يعبأ بهذا، ما دامَ الذينَ يتصدرون المنابر الإعلامية ويحظون بالاحتفاء والاهتمام – برأيه-همُ أغلبهم يخطّ حروفا بلا معنى على الورق..، وأنّهم تتوافر لديهم) معايير وشروط لا علاقة لها بالإبداع(..، وهوَ ينتمي فقط إلى نصّهِ.. ولا يُفاخر إلا بإبداعهِ..!!
في مقالي عن روايتهِ «حلق الريح» الصادرة عن «دار الهلال» المصرية.. وهوَ المقال الوحيد الذي كتِبَ عن روايتهِ في ليبيا،كما أخبرني قلتُ: (الروائيّ د. صالح السنوسي يعلو عنده النبض القومي،ويبرز الهمّ العروبيّ بوضوح ٍ، بلْ هوَ الرؤيا والنسيج الذي تبنى عليهِ أعماله الروائية التي أثارت، عندَ صدورها الكثير من الأسئلة والنقاشات على امتداد الساحة الثقافية الليبية والعربية)- كتابي: «العزف بالكلمات»-ص167. هذا النبض القومي جعلهُ يستهجن الرواية العربية التي تكتبُ خصيصا لذهن المتلقي الغربي، فاضحا الروائيين العرب الذينَ يكتبون بهذا الأسلوب كيْ يتبناهم الغرب فقط، ولعابهم يسيل على جوائزه التي يلونها حبر حقدهِ على قيمنا.. ومقدساتنا.. وفكرنا.. وأخلاقنا وحتّى أحلامنا..!!
تتعدد لديه فنون الكتابة، وهو الأستاذ، والباحث الأكاديمي في الاقتصاد،.. وعلم الاجتماع السياسي وكاتب مقال ناجح.. وهادف،.. هادئ الرأي.. صافي الفكرة.. شديد الوضوح، ولأن مادتهُ التاريخ، اختار الرواية كمتنفس، ويعترف بأنّ: (عواطفهُ مشدودة للرواية)، لأنّها: (نصٌ تعبرهُ كلّ الأجناس الأدبية دونَ أنْ يفقدَ هويته).
عن روايتهِ الأولى «متى يفيض الوادي» الصادرة عام 1980 كتب الناقد الكبير الراحل د. غالي شكري يقول: (وكأنّي بصالح السنوسي على صعيد البناء الروائي هوَ أحد الامتدادات الحية لتراث نجيب محفوظ ويوسف إدريس معا .. إنّ صالح السنوسي من أبناء الواقعية الجديدة إذا شئت.. وأنهُ ابنٌ لتراث الرواية العربية الحديثة إذا شئت أيضا، غير أنه قبلَ ذلكَ وبعده، قبل الأبوة وبعد البنوة هوَ صوت فنّي متميزٌ، لهَ شخصيته الأدبية المستقلة، ولهُ قدرة ٌ على العطاء السخيّ)- قصتي مع القصّة – د. غالي شكري- دمشق 30-يناير-1980م.
صدرَ للروائي د. صالح السنوسي:
– متى يفيض الوادي-رواية 1980
-غدا تزورنا الخيول – قصص 1984
– لقاء على الجسر القديم – رواية 1992
– سيرة آخر بني هلال – رواية1999
– حلق الريح- رواية 2002
لهُ أعمال قصصية وروائية تحت الطبع.. كما صدر له ثلاثة كتب في الفكرو الاجتماع والسياسة:
» العرب من الحداثة إلى العولمة»-2000
«العولمة أفق مفتوح وإرث يثير المخاوف»- 2003 و
«المأزق العربي غياب الفعل الجماعي وعنف الأقلية» –2004 جميعها صدرت في القاهرة.
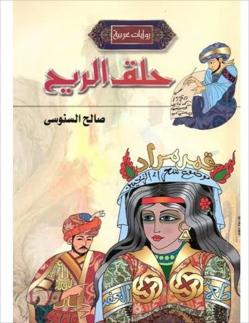
لذة الكتابةِ مجبولة ٌ بالمعاناة
– يرى البعضُ أنّ الكاتبة َمتنفسٌ .. والبديل لعالم ٍ أكثرَ حرية .. وهدوءا .. وأمانا .. وآخرونَ يرونها الهواء َ.. واللذة والمتعة الكبرى.. قل لي لماذا الكتابة؟ بلْ لماذا تكتب؟
– أعتقدُ أنّ الكتابة فيها بعض من هذا الذي قلتهُ، فهي متنفس بالنسبة للكاتب، مثلما هي القراءة متعة بالنسبةِ للمتلقي، غير أنّ لذة الكاتبةِ بالنسبة للكاتب هي لذة مجبولة بالمعاناة، وبينَ لذة المعاناة ومتعة التلقي يتخلق جسر من الوقائع والأوهام تعبرهُ المشاعر والانثيالات والحقائق والتوقعات المتبادلة بينَ الطرفين، فلعل هذا الجسر الذي يضع لبنته الأولى المبدع وليس المتلقي، هوَ الذي يصبح في ما بعد أحد الدوافع الحقيقية للكتابةِ. بالنسبة إليّ ليسَ صحيحا القول أنّ الكاتب يكتب دون أن يفكر في المتلقي، فبالرغم من أنّ المبدع يظل في وحدتهِ منشغلا بالنص وبعوالمه، ويبدو وكأنّه وحيد إلا أنّ المتلقي يظل دائما حاضرا في نهاية المشهد، فأنت عندما تشطب كلمة أو بيتا من قصيدتك، أو يشطب الروائي عدة جمل من النص وهوَ جالس وحده، فأنه يعترف بوعي أو بدون وعي بانّ هناك شريكا قد لا يرى في هذا البيت أو هذهِ الجملة قيمة إبداعية، ورغم أن قرار الشطب أو الإضافة يتخذه المبدع في خلوته، إلا أنّ ذلك التقييم يجري حسب معايير ذوقية وجمالية ومفاهيم وتصورات أفرزتها الثقافة المشتركة بينه وبين المتلقي الافتراضي الذي يجلس في نهاية المشهد منتظرا ما يتدفق بهِ جسر الحقائق والأوهام. فهذا الجسر التواصلي هو الذي يغذي الكتابة، فلا تصبح مجرد فعل ٍ عبثي يدور في الفراغ، بل يجعلها فعلا يشارك في خلق العالم والتأثير فيه.
أنا رجلٌ لا تتوافر فيه إلا معايير وشروط الإبداع
– اقتصاد.. مقال سياسي.. قصص قصيرة.. روايات، صخب ضروريّ بلا انتهاء.. أينَ أنتَ في كلّ هذا؟ ومنْ الأقرب إليك؟؟
-أظنّ انك تبالغ، فالقصص القصيرة لمْ أعدْ أكتبها منذ الثمانينات، وكان ذلك خلال مرحلة حياتي في باريس التي كانت يومها تعجّ بالصحف والمجلات العربية، أما المقالات فأنا لستُ صاحب عمود، ولا رئيس تحرير لصفحة في أيّ مطبوعة ليبية ولا عربية، وكل ما هناك أنني أكتب مقالا شهريا بالاتفاق مع الجزيرة – نت، ولكن ما أدهشني هوَ حديثك عن الصخب الضروري بلا انتهاء، وكأنك لا تعرفني، فأنا لا يكاد يعرفني جاري القاطن في البيت المقابل لبيتي في مدينة بنغازي، فليس حولي صخب وأيّ أضواء على الساحة الثقافية الليبية. أما المشهد الثقافي العربي، فأنا رجلٌ لا تتوافر فيهِ الشروط والمعايير غير الإبداعية التي تتطلبها الأضواء والصخب والمزامير على مسرح هذا المشهد.. كنت أقول أنّ المشهد الثقافي العربي هوَ إعادة إنتاج للمشهد السياسي بكل مرجعياته التي من بينها العصبة والغنيمة، فيلزمك أن تكونَ جزءا من إحدى شلل أوعصائب هذا المشهد، ولكي تكون عضوا في هذهِ العصبة فيجب أن تكون من الذين أصابهم شيء من فيض غنيمة السلطة حتّى تستطيع أن تتبادل المنافع والمصالح في سوق هذا المشهد الثقافي العربي، وأن تستكب النقاد وتؤجر الطبالين والمترجمين، ولكي يصيبك شيء من هذا فلابد أن تكون منخرطا في رتل السلطات العربية أو منافقا معها، وهذه أمور لا أصلح لها ولستُ من رجالها، ولهذا فأنا أقع خارج صخب وأضواء هذا المشهد.. فهل سبق لكَ أن علمت أو قرأت أنني مدعوٌ لأيّ معرض كتاب عربي، رغم أنني لديّ كتب ليست سيئة معروضة في هذهِ المعارض التي ألتقي فيها بأناس، الكثير منهم ليسوا أقلّ مني سوءا، ومع ذلك فهم ضيوف مُبجلون.. هلْ سمعت أنني شاركت في ندوة من ندوات هذا المشهد، رغم أنني باحث أكاديمي أيضا؟ هلْ تمّت استضافتي في ما بات يعرف بعواصم الثقافة العربية؟ وأنني أجزم بأنك لا تستطيع أن تثبت أنني دُعيت في أيّ من مُؤتمرات الرواية العربية، رغم أنني أكتب الرواية، وصدرت لي عدة روايات، مهما تدنت قيمتها فلن تكون أقلّ قيمة من روايات آخرين تتبناها عصائب المشهد الثقافي العربي، وتدق حولها الطبول والمزامير، وتترجم إلى لغات الجن والأنس.
يا صديقي هناك طرفان هما مصدر الضوء والصخب والدعاية بالنسبة للمشهد الثقافي العربي، وهذا الطرفان هما السلطة والغرب، أي ينبغي أن تعمّدك السلطة العربية، أو يتبناك الغرب الثقافي لأسباب سياسية، ولا أحد من هذين الطرفين يعتبرني صديقا لهُ ولا من رجالهِ، وهما محقانِ في ذلك.
غياب الفعل الجماعي أدّى إلى انقسام المثقفين
– الفعل الثقافي لمْ يعُد مقنعا للمواطن العربيّ.. وهوَ يعيش الكوارث المتلاحقة – كما يعبر جبرا إبراهيم جبرا.. قل لي لماذا؟وكيف ننتج؟
ثقافة هادفة.. ومقنعة؟ ماذا تقترح؟ ألا ترى أنّ العديد من مثقفينا يظهرون سلبية مقيتة.. ولا مبالاة جارحة جرّاء ما يحدث على أرض الواقع.. هيمنة أجنبية.. تبعية.. احتلال.. وغياب مدن بكاملها.. ما أسباب هذهِ السلبية؟ وما أهدافها؟ ماذا تسمّي هذا النوع من المثقفين؟
– الإجابة على هذا السؤال تعيدني إلى ما سبق ذكرتهُ في كتابي الذي صدر منذ أربع سنوات عن مركز دراسات الأهرام – القاهرة بعنوان «المأزق العربي.. غياب الفعل الجماعي وعنف الأقلية»، فغياب روح الفعل الجماعي لدى الأغلبية الساحقة في المجتمع العربي لأسباب لا يسمح سياق حديثنا هنا لشرحها وتحليلها، أدّت إلى انقسام المثقفين الذين تتساءل عن دورهم إلى خمس فئات، الأولى تلوذ بالصمت تحاشيا منها للصدام مع سلطات باغية في مجتمع فاقد لروح الفعل الجماعي.أما الفئة الثانية فقد اختارت المنفى والهروب من أوطانٍها ولها أسبابها، أما الفئة الثالثة وهي الأغلبية فقد اختارت طريقا يوائم بين مصالحها ومصالح النظام من ناحية ومحاولة إحداث تغيير من داخل النظام، أي أنها انخرطت مع النظام السياسي بعد أن يئست من قدرة الجماعة على فرض إرادتها، بينما رأت الفئة الرابعة، في ظل عجز الجماعة عن أداء دورها أنه يحقّ لها أن تحاول الاستفادة من حماية الفضاء الإعلامي والسياسي الغربي في عصر العولمة باعتباره فضاء ضاغطا – متى أراد- على السلطات العربية أكثر من مجتمعها العاجز، غير أن ثمن ذلك هوَ أن يراعي هذا المثقف في خطابه جملة من المواقف والالتزامات التي تتناغم مع مصالح ومواقف الغرب من أمثال ما تسمّيه أنت الهيمنة والتبعية والاحتلال وضياع الأمصار والمدن. أما الفئة الخامسة وهي الأقلية فقد اختارت الوقوف في وجه السلطة والدفاع عما تعتقدهُ رأيها ورأي الأغلبية العاجزة، وذلك بقبولها التضحية ودفع الثمن اعتقادا منها أن ذلك سيدفع غالبية الجماعة إلى الانخراط في الفعل الجماعي غير أن أحداث الواقع العربي أثبتت عدم صحة هذهِ التوقعات، فبدا حال هؤلاء الذين ذهبوا إلى حد التضحية، شبيها بحال شخص يخالف نظام السير فتدهسه سيارة مسرعة في منطقة مظلمة من الطريق العام.
أظن أنني – ياصديقي – قد حاولت، بصرف النظر عن التوفيق من عدمه، أن أجيب على تساؤلاتك حول نوعية المثقفين العرب وما تراهُ من سلبية مقيتة ولا مبالاة، وأكرر أبحث عن غياب روح الفعل الجماعي لدى غالبية الجماعة، فهو خلف كل هذهِ الظواهر وتلك الكوارث.. لا شك أنّ القارئ سيتساءل عن الأسباب الكامنة خلف فقدان هذهِ الروح، وهوَ تساؤل منطقي ومشروع ولكنني لا أستطيع أن أعيد رواية كتاب بكامله، وهو الكتاب الذي لا أظن قد سمع به معظم القراء العرب، لأنه لم تحتف به عصائب المشهد الثقافي العربي،وبالتالي لم يسمع بهِ المتلقي العربي ضحية الطبول والمزامير.

الثقافة هي المسؤولة عن كثير ٍمن كوارث السياسة
– يقولُ الروائيّ الأمريكي – هنري ميللر: (إنني أعدّ السياسة عالما خبيثا .. متعفنا إلى أبعد حدّ.. إننا لا نصلُ إلى أيّ تقدم عن طريق السياسة.. إنّها تفسدُ كلّ شيء..) لماذا برأيك؟وأيهما الأصح: ثقافة السياسة أمْ سياسة الثقافة؟
– ثقافة السياسة وسياسة الثقافة كلها تعبيرات تدور حول موضوع واحد بصرف النظر عن التأخير والتقديم والمضاف والمضاف إليه، فالمقصود حسب ظني هو الاختيار بين توظيف السياسة في الثقافة أو العكس،وعلينا ان نسلم بان هناك علاقات سببية بين الثقافة والسياسة، فالاثنان يشتركان في ما نسمّيه في العلوم السياسية بالبعد الاستراتيجي لتوظيف الظاهرة، على الأغلب أن هنري ميللر قد شتم السياسة ولكنه لمْ يتطرق إلى الثقافة، ولكن الثقافة هي أيضا ليست بريئة، وقد تكون هي المسؤولة عن كثير ما نسميه كوارث السياسة، لأن أي حراك سياسي يلزمه تأويل ثقافي، فاطلاق صفة الشرير والإرهابي والمتعصب والمتخلف ضمن مشروع سياسي يلزمه إرثا ثقافيا ثاويا في الضمير الجمعي، لكي يعطي المصداقية الضرورية لتحريك آليات هذا المشروع. فالاستعمار الغربي العسكري والسياسي كان يتوكأ أيضا على عصا ثقافية، بل العنصرية هي ظاهرة ثقافية احتضنتها السياسة، فمعظم منظري العرقية يتوسلون الثقافة في الدفاع عن رؤيتهم التي تبنتها السياسة فسيرج جوبينو، وبوفون، وأرنست رينان وغيرهم هم أبناء ثقافة وليسوا أبناء سياسة، والهوية والقومية والدين والأيديولوجيا كلها أحصنة ثقافية يمتطيها فرسان السياسة، صحيح أن السياسة كعلم حديث النشأة، ولكنها كأفعال وسلوكيات هي قديمة غير أنها كانت ولا تزال تحتاج إلى عون الثقافة.. وأخالك تخالفني حول أثر الثقافة في تردي أوضاعنا السياسية العربية، فغياب روح الفعل الجماعي بكلّ ما يمثله من خراب سياسي، يجد الكثير من أسبابه في ثقافة العجز والتواكل والصبر والخضوع والخلاص الفردي التي لها جميعها مرجعياتها في الثقافة العالمة والثقافة الشعبية. واخيرا أقول لك إذا كانَ ثمة تغير فلا بد أن يحدث في الثقافة أولا !!
الرواية نصٌ تعبرهُ كلّ الأجناس الأدبية دون أن يفقد هويته
– الرواية تاريخ.. وذاكرة.. ومخزون.. وتراكم فكري وحياتي؟كيف تعّرف الرواية وأنت الروائي الكبير!؟
– بإمكاني أن أتحدث عن الرواية ولا أعرّفها، فالتعريف بالنسبة إلى أكاديمي مثلي يحصر ويقيد المعنى، ولكن سؤالك يحاصرني ويحاصر الرواية ويطلب إجابة محددة ولهذا سأقول لك ما تعتبرهُ أنت تعريفا، وما أعتبرهُ أنا خلاصا من السؤال، فالرواية: «هي النص الذي تعبرهُ كلّ الأجناس الأدبية دون أن يفقدَ هويته»..فهي فضاء تعبره السياسة والشعر والتاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع والشر والخير والحبّ والكراهية والواقع والخيال، ومع ذلك فإنك تقبل عليها باعتبارها رواية ولا تتوقع أنك تقرأ كتابا في علم النفس أو في السياسة، بل تظل ذلك النص الذي يجتر في داخله كلّ تلك الخلطة دون أن يفقد بنيته السردية وأنساق عوالمه، ودون أن ينفلت ويسقط في المبتذل المُمل ودون أن تفارقه لذة التواصل..، ولهذا فإن النص الذي يفقد هويته ويصبح مجرد احتطاب لموضوعات ومعانٍ مرصوصة ومتجاورة، هو عندي – ولعله عند الغالبية العظمى- ليس برواية وإنما ينطبق عليه المثل الليبي الدارج «كلام لا رأس لهُ ولا ذيل».. حتّى وإن فازَ بالجوائز على اعتبار أنه رواية لأسباب سياسية وليست إبداعية، ومهما نال من تقريض من قبل نقاد وكتبة مؤجرين، ويعانون من عقد نقص تجاه كلّ ما يتبناهُ الغرب..!!
إنّ عواطفي مشدودة إلى الرواية
– تقولُ – سانت بيف: (ولسوفَ تكتسحُ الرواية ُ كلّ شيء)..ويقول ميلان كونديرا في كتابه – فنّ الرواية: (إنّ السبب الوحيد لوجود الرواية لأنّها تقول شيئا لا يمكن أنْ تقوله سوى الرواية).. لماذا الرواية دون غيرها من بقية الفنون؟
– أنا لا أفضل تعابير من قبيل الاكتساح لأنّ هذا التعبير في لغتنا العربية يعني ظهوره هيمنة شيء واحد واختفاء ما عداه، ونحن في عالمنا العربي نعاني من ثقافة الاكتساح.. فعلى صعيد السياسة يكتسح الحاكم مسرح السياسة، فتختفي الشعوب .. وكذلك الأمر بالنسبة للفن والأدب وغيرها، فهنا دائما مكتسح، والبقية مكتسَحيِن(بفتح السين والحاء)..إنني ما أزال في معرض الإجابة عن سؤالك وإن استخدمت تسميات ليس من بينها الرواية، وأنا شخصيا أكتب الرواية ومعظم مَن يعرفونني يطلقون علّي صفة الروائي رغم أنني لديّ مؤلفات في علم الاجتماع السياسي والبحث الأكاديمي، ولهذا فأنني أجد عواطفي مشدودة إلى الرواية، ولعل ذلك يرجع أيضا إلى كوني عشقت الرواية وكتبتها قبل أن اعرف أجناس الكتابة الأخرى.. ورغم ذلك فأنني لا أريد أن تكتسح الرواية كلّ شيء، فالإنسان في حاجةٍ إلى الشعر والموسيقى والرسم والفلسفة والنقد، وأنا لا أريد للرواية أن تتربع وحدها على مسرح الإبداع الإنساني لأن ذلك يعني نهايتها، فالرواية في نظري لا يمكن أن تحافظ على هويتها وتميزها إلا في وجود كلّ تلك الضروب الأخرى من الإبداع التي تتغذي ويغذي كلّ منهما الآخر. أقولُ لك – وأنت الشاعر- إنني أحيانا اظل أبحث عن إشباع نفسي وذوقي وجمالي لحالة وجدانية تنتابني، ولا أجد ذلك إلا في بيتٍ أو بيتين من الشعر وليس في أعظم رواية..!! ما أريد أن أكرر قوله بصيغةٍ أخرى هوَ أن فكرة ألأحادية أمر يخيفني، ولا يدعوني إلى الفرح حتّى لو كان موضوعها هو اللذة والجمال، فالوحدانية يمكن أن تستوعبها الألوهية باعتبارها فكرة مجردة ومتعالية، أما أن تنزل إلى الأرض في شكل مادي، فإن ذلك لا أظن أنّه يدعو إلى البهجةِ والسرور..!!
الرواية ُ العربية تمتلك كلّ مقومات الرواية العالمية
– وكيف تقيم الرواية العربية؟ مَن مِنَ الأسماء تقرأ؟ ولِمنْ تنجذب؟ وتشعر أنه يضيف شيئا لهذا الفن العظيم؟ وما تأثير الرواية الغربية على الرواية العربية وعلى أسلوب روائيينا؟؟
– أعتقدُ أنّ الرواية العربية لا ينقصها شيء من مقومات الرواية في بقية أجزاء العالم الأخرى، ولكنّها تعاني من ظرف شديد الوطأة، وهو غياب حرية التعبير، فالكبت السياسي والاجتماعي والممنوعات والمحرمات كلها تمثل عوائق أمام مسيرتها، وتؤثر بشكل أو بآخر في انطلاقتها، باعتبار ذلك يضعُ محددات تؤدي إلى تضييق الفضاء الممتد أمامَ المبدع. وقد يقولُ البعض أن الكبت أيضا يولد الإبداع، وهذا صحيح إلى حدٍّ ما، ولكن في حالة الأوضاع العربية فإن الخروج على هذهِ المحرمات ولا سيما السياسي منها، باهظ الثمن ومهلك، ولا تستطيع أن تطلب من كل الروائيين أن يتحولوا إلى أبطال وشهداء، وهم أصلا أبناء ثقافة العجز، وينتمون إلى مجتمعات فاقدة لروح الفعل الجماعي، فأنت قد تكتب رواية ولكنك تخاف أن تنشرها، لأنك قد تفقد حياتك، وهذا لا شك يشكل أزمة للمبدع العربي.
نعم قد يستطيع البعض من الذين يعيشون خارج العالم العربي أن يكتبوا بحرية أكثر، ولكن ذلك يظل عمل أفراد قليلين، وقد تكون قدراتهم الإبداعية متواضعة مقارنة بقدرات الخائفين المترددين، فهذا الظرف، أقصد حرية الكتابة دنَ خوف، يمنح هؤلاء ميزات قد يكون غيرهم من الرهائن في الوطن أجدر منهم بها.. في ظل ظروف متكافئة. هكذا أرى الرواية العربية وغيرها من ضروب الإبداع ضمن هذه الاعتبارات والمحاذير. أما من الناحية الإبداعية، فليست هناك رواية عربية واحدة، بلْ هناك تعدد، وهناك نصوص يحسبها البعض روايات،.. وهناك مأخذان – في نظري – على الرواية العربية، وهما يسيئان إليها ولعلها أكثر خطرا من فقدان حرية التعبير. أول هذين المأخذين هو أنّ هناك عددا متزايدا من الروائيين العرب يكتبون وفي ذهنهم المتلقي الغربي، وليسَ العربي، وبالتالي فهم يكتبون عن موضوعات يأملون أن يتبناها الغرب السياسي، فيؤدي ذلك إلى تبنيهم من قبل الغرب الثقافي بأضوائه وجوائزه ومظلته الإعلامية، ولهذا فهناك ظاهرة تدافع في هذا الاتجاه، وكلّ يحدوه الأمل بأن يقع معه ما وقع مع قلة عمدهم الغرب كروائيين كبار وعالميين، ورغم أن تبني الغرب لهؤلاء هوَ لأسباب سياسية وليست إبداعية، إلا أنهم يفرضون أنفسهم على الساحة الثقافية العربية التي تعاني من عقدة نقص مزمنة تجاه كلّ ما يأتي من جهة الغرب، وهي عقدة لا شك لها أسبابها الحقيقية والموضوعية، ولهذا فان الغالبية العظمى من النقاد العرب والمؤسسات الثقافية العربية لا يملكون إلا تبني هؤلاء باعتبارهم عالميين، وهي بالمناسبة صفة لا تطلق على الروائيين في الآداب الأخرى مهما بلغت قمة إبداعهم، بلْ يذكرون بأسمائهم دون اقترانها بصفة العالمي. أما مَن يشككون في القيمة الإبداعية لهؤلاء العالميين العرب فانهم أقلية تغني خارج السرب حسودة وهامشية.إن البحث عن موضوعات قد تلاقي قبولا لدى الغرب يجعل هذا النوع من الرواية العربية لا تلتقط هذه الموضوعات إلا من أجل متلق ٍ آخر وليسَ المتلقي العربي..!!
أما المأخذ الثاني على الرواية العربية هوَ محاولة الاتكاء على مشروعية ومصداقية مستمدة من الأدب الغربي لتعضيد نصوص يريدها أصحابها رواياتٍ، وهي في نظري ليست كذلك. ولكن كلّ هذهِ الإشكاليات والمآخذ لا يمكن أن تختصر الرواية العربية، فهناك إبداع وعطاء والتزام ونبض حياة..!!
مستقبل الرواية والإبداع الليبي مرهون بمستقبل الإبداع العربي
– والرواية الليبية التي أصبحت أكثر أنواع الإبداع الليبي نفوذا.. وانتشارا .. ورواجا للقارئ الليبي والعربي.. كيف تقرأ مستقبلها؟ هل تذكر بعض الأسماء الهامة !؟؟
-الرواية الليبية ليست استثناء من الرواية العربية، فهي تلاقي العوائق نفسها من ممنوعات ومحرمات، كذلك الأمر بالنسبة لمستقبلها، فأنا لا أستشرف لها مستقبلا خاصا بها معزولا عن مستقبل الإبداع في المنطقة العربية. أما مسألة الانتشار والرواج عربيا، فأعتقد – ولعلني مخطئ- بأن المبدعين الليبيين بعضهم ظلمته الجغرافيا ولمْ تظلمهُ قدراته، ولكن بعد ثورة الاتصالات التي شهدها العالم في نهاية الألفية الثانية، يبدو لي أن هناك تقلصا في المسافة التي كانت تفصل بين ما كان يسمى مركز العالم العربي وأطرافه. أعتقد أنني قرأت كلّ مَنْ كتبوا الرواية في ليبيا، ومعظمهم،ولهذا فأنا لا بد أن أذكر لك أسماء من قرأت لهم دونَ ترتيب، ودون حكم لأن ذلك مهمة المتلقي وليست مهمة روائي يتعامل بنفس البضاعة. لقد قرأت لأحمد إبراهيم الفقيه، وخليفة حسين مصطفى، ومحمد الأصفر، وسالم الهنداوي، وعبد الرسول العريبي، ومحمد عقيلة العمامي، ونجوى بن شتوان، وأحمد الفيتوري، ويوسف إبراهيم. لقد قرأت لهؤلاء جميعا واستفدت مما قرأت لهم.
أنا مع اللغة الشعرية في الكتابة الروائية
– فازت رواية «ليلة القدر» للطاهر بن جلون بجائزة «غونكور» الفرنسية لكونها الشعري.. قل لي ماذا يضيف الشعر للرواية؟ وما مدى تأثير الشعر على روايات صالح السنوسي؟
– أعتقدُ أن موضوع الرواية هو الذي يفرض أسلوب كتابته، وانا مع اللغة الشعرية في الكتابة الروائية، ولكنني لست مع الشعر في الرواية (أعني الشعر تحديدا)، وليس لغته، فاستخدام الشعر أو إقحامه في سياق النص الروائي من أجل التغطية على عجز الراوي في الاحتفاظ بخيط الحدث الروائي، فذلك في رأيي مجرد احتطاب أعواد خشب من غابة الشعر لإنقاذ مشروع بيت متهاو ٍ. عندما كتبت رواية «سيرة آخر بني هلال» ولعلك لاحظت ذلك،فإن موضوعها فرض لغة شعرية، ولكنني لم استنجد بقوافي الشعر لكي أخفي عجزي عن الاحتفاظ بمسار تدفق الحدث الروائي. أعود إلى رواية «ليلة القدر»، أنا أشك كثيرا في أن تكون جائزة «الغونكور» قد مُنحت للرواية بسبب كونها الشعري، وهذا ليس تبخيسا للغة الشعر التي كتبت بها، فأنا أناقش سبب منح الجائزة، وليسَ شعرية الرواية، فالطاهر بن جلون بدأ الكتابة شاعرا باللغة الفرنسية، فهي لغته حتى أنه ترك قسم الفلسفة بكلية الآداب في المغرب احتجاجا على تعريب الدراسة بالقسم، وبالتالي فان لغته الشعرية أمر متحقق، ولكن الرواية تحتاج إلى موضوع أو حدث روائي وإلا أصبحت ديوان شعر. وموضوع «ليلة القدر» يتناول إحدى قضايا العادات والتقاليد السيئة في الثقافة العربية، فالرواية استكمال لرواية «طفل الرمال»، وهي قصة الأنثى التي أراد أبوها أن تكون ذكرا لأنه لديه ثماني بنات، وبالتالي أعطاها اسم «احمد» ثم أصبح أحمد في رواية «ليلة القدر» زهور أي عادت إلى أنوثتها، ووقعت في حبّ ذكر إلى آخر الرواية.لا شك أن مثل هذه الموضوعات تعتبر أكثر جاذبية بالنسبة للمتلقي الغربي عموما نظرا لما فيها من غرابة وتعارض مطلق مع مفاهيم وقيم ثقافتهم، وهي أيضا تؤكد الصورة المتلقاة من إرثهم الثقافي عن هؤلاء القوم، وبالتالي فلا تصدم أحكامهم المسبقة ولا تستفز عقولهم، بل تثير فضولهم وسخريتهم وتعطي مصداقية لكل ما تلقوه عن ثقافتهم، فليس هناك عمل إبداعي عربي معرض للفشل في الغرب أكثر من ذلك العمل الذي يصدم مفاهيم وتصورات وأحكام المتلقي الغربي عن العرب. سأذكر لك حادثة طريفة لعلها لها علاقة بهذا الموضوع، فقد أخرج المخرج اليوناني الأصل «كوستا كافراس» في الثمانينات شريطا سينمائيا عن الفلسطينيين في إسرائيل وكان بطل الفيلم فلسطينيا. كان عنوان الفيلم(حنا.ك)، وقد سنحت لي الفرصة أن ألتقي بهذا المخرج ضمن عدد من الطلبة من زملائي في معهد الإخراج السينمائي في باريس، وبعد أن انتهى اللقاء ذهبت لأسأله على انفراد: لماذا جعل البطل الفلسطيني يحمل ندبة كبيرة تشوه وجهه بشكل ٍ ملفتٍ للنظر، فضحك ممازحا، وهو يرد عليّ: أتريدني أن أجعل البطل فلسطينيا ووسيما أيضا؟ فنجاح الفيلم قد لا يتحمل كل ذلك !! لقد لخص «كوستا كافراس» المسألة في جملتين. فالعرب بالنسبة للمتلقي الغربي لايزالون قوما أكثر ما يثيرون لديه هو الشفقة وليس الإعجاب. أعود فأقول لك أن شعرية الطاهر بن جلون التي ليست محل شك ٍ عندي لم تكن في نظري خلف أية جائزة حصل عليها، أو سيحصل عليها، فلو فرضنا أنه كتب رواية عن مأساة فتاة فلسطينية أثناء مشهد الدم والنار الذي صنعته إسرائيل في غزة فأنني على يقين من أنه لن تحتفي بها مؤسسات الغرب الثقافي، ولن يمنحه الرؤساء الأوسمة عن هذه الرواية مهما أوغل الطاهر بن جلون في شعريته وتجاوز مالارميه، وبودلير، ورونسار.
– متى نقرأ لك عملا صادرا عن دار نشر ٍ ليبية؟ كيف قرأ النقاد الليبيون والعرب رواياتك؟ هلْ أخذت حقّك من النقد؟ أعني هلْ أنصفك النقاد في روايتك الخمس الصادرة عن دور نشر ٍ عربية؟ كيف استقبلها القاريء الليبي والصحافة الثقافية؟
– هذا في الحقيقة ليس بسؤال ولكنه دعوة غير بريئة منك للشكوى من جانبي أظن انني أجبت عن جزء من هذا السؤال في معرض إجابتي عن السؤال الثاني بخصوص الصخب.
إنا لا أطالب أحدا من النقاد أن ينصفني شخصيا، بل يلتفت إلى النصوص وليس إلى الأسماء، فما يجري في المشهد الثقافي العربي الآن هو الدوران حول أسماء معينة رغم أن الكثير منها إبداعيا شحمها ورم.
اعترف بأنني لا أمتلك الشروط غير الإبداعية التي تجعل هذا المشهد يولي اهتماما بكتاباتي، فأنا كما قلت لك شخص غير مفيد بمفهوم سوق المنافع والمصالح المتبادلة في المشهد الثقافي العربي، أما النص وحده ليس هو السلعة القابلة للتداول في هذا السوق.
هناك بالطبع نفر قليل من النقاد الذين أولوا اهتماما بكتابتي ولكن معظمهم يقع خارج صخب المشهد الثقافي العصبوي العربي ولهذا فقد ظل المتلقي العربي الذي هو ضحية الدعاية والبروباقاندا والإشهار – كحال المتلقي في كثير من أنحاء العالم – مشدودا إلى ما يجري على المسرح المضيء ماعدا أقلية قد تلتفت من حين لآخر إلى الأماكن المحرومة من الضوء، ولكنهم في النهاية أقلية تضيع أصواتهم وسط صخب الدفوف العالية والمزامير حتى إن البعض منهم قد يساوره الشك بأنه قد اكتشف شيئا قيما في عتمة الزاوية المنسية.
ففي ليبيا – على سبيل المثال- لم يكتب عن رواية حلق الريح سوى مقال واحد وفي الوطن العربي – حسب علمي- لم يكتب عنها سوى مقالين، وهى رواية ميثولوجيا الرعاة والقبيلة التي تصبح دولة وهو النموذج الذي يتماهى مع التاريخ السياسي العربي، فلو حملت هذه الرواية اسم أحد أولئك المعتمدين في المشهد الثقافي العربي بشروطه ومواصفاتها التي لا أمتلكها، لجعلوا منها نموذجا ومرجعية ولنالت الاهتمام الذي تستحقه بين الروايات العربية.
عندما صدرت رواية سيرة آخر بني هلال عن دار الهلال المصرية، منع الرقيب الليبي تداول الرواية- أول صدورها- ومع ذلك لم أقفز على هذه الفرصة التي يتربص بمثلها غيري من الكتاب العرب مستغلين جهل وتسلط الرقيب العربي ليجعلوا من نصوص متواضعة إبداعيا، موضوعا إعلاميا يلهث خلفه المتلقي ويبحث عنه، فانا دائما أتوقع من القارئ أن يبحث عن رواياتي لأنها جديرة بالقراءة وليس فقط لأنها ممنوعة.
رواية سيرة آخر بني هلال هي رواية اللغة الشعرية ولكنها أيضا رواية اللاجئ السياسي العربي في باريس، أي رواية المنفي، فبطل الرواية ليست له جنسية واسمه عدنان ولا يمكن نسبته إلى أي بلد عربي فأي متلق عربي سيحسبه ذلك الرجل الذي فرّ من قريتهم أو مدينتهم ذات يوم قبل القبض عليه، وهو أيضا الشاعر الذي يرفض أن يعاملوه في الغرب بالتعالي والدونية ولكنه في الوقت نفسه مهزوم حضاريا وسياسيا ولم يستطع فوق كل ذلك أن يعوض هذه الهزائم بغزوات جنسية في بلاد الغرب كما يفعل أبطال روايات المنفى العربية جميعها.
ولو قيض لهذه الرواية أن تحمل اسم بهاء الطاهر أو يوسف إدريس أو الطيب صالح – على سيبل المثال – لما اخطأ الكثيرون ممن قرأوها في عنوانها وأسموها «سيرة بني هلال» بدلا من سيرة آخر بني هلال، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سطوة المشهد الثقافي العصبوي العربي على ذاكرتنا، فيجعلنا ننسى حتى الذي نعرفه جيدا طالما لم تتبنه عصائب المشهد الثقافي العربي، فأنا لا أتوقع أن تقع مثل هذه الأخطاء مع «الحب في المنفي «أو «الحي اللاتيني» رغم أنهما لا يتميزان بشيء عن سيرة آخر بني هلال.


