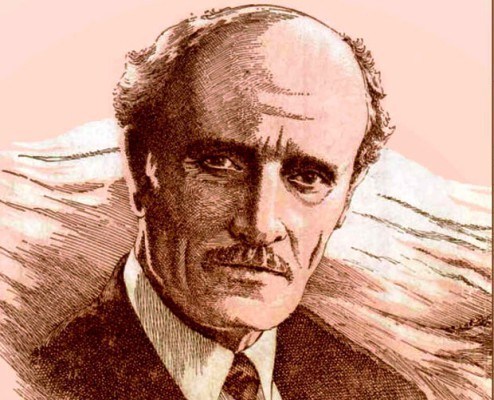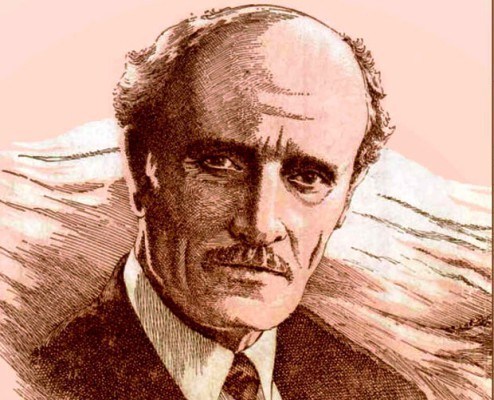
يعتبر الأديب والكاتب والناقد والشاعر اللبناني ميخائيل نعيمة حالة فريدة في دنيا الأدب والثقافة العربية الحديثة ليس لغزارة إنتاجه فحسب، وإنما لعوامل شتى جعلت منه مثالا نادرا للأديب الفذ والمثقف الواعي والشاعر الحي الوجدان والإنسان الطافح بالمودة والتسامح والإخاء، ولكأنه وعى في صدر شبابه مقولة أبي حيان التوحيدي: “الإنسان أشكل عليه الإنسان” فاستبطن ذاته ونزل إلى قرارة نفسه بمبضع الفكر والضمير، فاستأصل منها بذور الأنانية والحسد والشره المادي والغرور والكبرياء الزائف، وتعهد فيها بذور التضحية والشرف وصدق القول والفعل والتواضع والزهد في متاع الدنيا، فأينعت تلك البذور دوحة استظل بها في صحراء الحياة القاحلة ودعا إلى ذلك الظل من تاقت نفسه إلى الحقيقة والجمال وكمال الخلق .
وفي حياة ميخائيل نعيمة هدوء وسلاسة وانسياب تلقائي فهو أشبه بالنهر يجري إلى المصب بلا ضوضاء ولا تيه، وقد أدرك مصبه منذ فجر شبابه أنه مصب الوجود حيث تتوحد الموجودات وتتناغم فتكون وحدة في كثرة، ولونا موحدا في أطياف شتى وحياة، واحدة في حيوات متعددة، وما الإنسان والدودة والحجر والودق إلا مظاهر للوجود الواحد الحي الفاعل .
وبلا شك فمولده في بلد الأديان والتسامح “بسكنتا” بلبنان ودراسته في الناصرة ثم في روسيا القيصرية، وأخيرا في أميركا كانت تلك الرحلة منافذ للروح والعقل والضمير حررته من عصبية الدين والقومية الرعناء بلا رقيب من الفكر والشعور، وأدخلته في رحاب الإنسانية الخالدة، فجاء أدبه صورة لفكره ولوجدانه بلا تزويق أو أصباغ، فهو الأديب المسئول، والشاعر الهامس، على حد وصف الدكتور محمد مندور لجماعته، ليس في حياته الخصام والنقد الجارح والكلام النابي على عادة كتابنا في ذلك العهد أو ليس هو القائل: “عجبت لمن يغسل وجهه كل يوم، ولا يغسل قلبه مرة في السنة”؟ بلى وأهميته الشعرية تكمن في تحرير الشعر العربي من الخطابية والحماسة الزائفة والرياء الماكر.
صحيح ففي النصف الأول من القرن العشرين ظهرت مدارس شعرية جددت الشعر العربي شكلا ومضمونا وتخلت عن طرائقه القديمة وقصرته على الوجدان وهموم الحياة الحديثة فجماعة “أبولو”، و”جماعة الديوان”، ولفيف آخر من الشعراء حقق هذا الإنجاز.
أما النتاج الشعري لجماعة “أبولو” فغلبت عليه الغنائية الحزينة وكثر فيه النحيب وطغت عليه السوداوية والاندفاع الصارخ وأما النتاج الشعري لجماعة الديوان – وأخص العقاد بالتحديد – فجاء في معظمه فلسفة وعمارة منطقية، وغير هاتين المدرستين ممن جرى مجرى حافظ وشوقي فوقع بين مطرقة التصنع والتحذلق البياني وسندان المناسبات.
أما شعر ميخائيل نعيمة فقد تخلص من هذا كله، كان كالمنهل أو كانت نفسه غورا مسها بعصاه فانبجست منها عيون رقراقة سلسة تغذي العقل والوجدان، توحي إليك كلماتها دون أن ينضب معينها، ويهمس لك شاعرها في أذنك حتى يكون قريبا من وجدانك وقلبك دون أن تذهب الكلمات أدراج الرياح إن اعتلى المنابر.
اقرأ معي هذا المقطع من قصيدته “أخي” تجده يقول:
أخي إن ضج بعد الحرب غربي بأعماله
وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله
فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت بمن دانا
بل اركع صامتا مثلي بقلب خاشع دام
لنبكي حظ موتانا.
فهذا المقطع يستعلي على المنابر ويتجافى عن المجامع، لا تجد فيه أثرا للخطابية، إنه مقطع يخلو فيه الإنسان إلى نفسه ويقرؤه لنفسه يغذي به وجدانه وعقله، وفي هذا المقطع دلائل شتى لعل أهمها منزعها الإنساني المتجلي في كلمة “أخي” ونزوعها السلمي وعهدنا بشعرائنا القدامى يتحمسون لساحات الوغى ويهيبون بالمهند والرديني وقراع الكتائب.
إنه شعر يلج من الأذن ليستقر في القلب فيغير ما به وليس بالشعر الذي يردد في المناسبات بالتفخيم ومد الصوت فيلج إلى الأذن الأولى ليخرج من الأذن الثانية وفي قصيدته “صدى الأجراس” هنا نقبض على الخصائص الفنية التي تميز شعر ميخائيل نعيمة، فالتصنع والتكلف وانتقاء اللفظ البراق والتفتيش في لسان العرب والقاموس المحيط عن اللفظ الدال على الملكة اللغوية أو كدّ الذهن في البحث عن استعارات رائعة أو تشبيهات غير مسبوقة والنزوع إلى الأبحر الطويلة النفس (الطويل، الكامل، البسيط) وحشد الشعر بالإحالات العلمية والفلسفية ليست من الخصائص الفنية لشعره.
فالشعر عنده سليقة والسليقة بنت الطبيعة والطبيعة أطياف وأحياء ومشاعر وأفكار قدد. اقرأ معي هذا المقطع من قصيدته “صدى الأجراس” لتقع على صحة هذا الرأي:
بالأمـس جلست وأفكـاري
سرحت تستفسـر آثاري
وترود الحاضر والمـاضي
أملا أن تدرك أســــراري
وأفـاق الشك وأنصـاره
آلام العيـش وأوزاره
بالله شــكوكي خلـني
وحدي ذا الصوت يناديني
ذا صوت صباي يـردده
الـوادي وشـواهق صنـيني
العـــالم مملكتي وأنا
سلـطان العــالم والدهــر
الــزهر يعطـر أنفــاسي
والـزهر يولد في رأسـي
أشبــاحا راقصـة لخرير
المـاء وصوت الأجـراس
ما بال سكينتي اضطــربت
وجحـافل أشبـاحي هـربت؟
قد عاد الشـك وأنــصاره
آلام العيـش وأوزاره
وقد تصرفنا في هذه القصيدة الطويلة لندلل على صحة رأينا في شعره؛ إنه الشعر الهادئ الذي يجد مصبه في وجدان القارئ، لا في أذن السامع والشاعر هنا يتعبد في محراب الطبيعة بفرح طفولي ويستذكر شوامخ صنين ويعابث الزهر ويناغي النهر لولا تباريح الشك وتصاريف الحياة ونكد الفكر. وقد كان شعرنا العربي بحاجة إلى هذا النوع من الشعر – شعر القلب والعقل – شعر الاندغام في الطبيعة والوجدان، فتصير الطبيعة والشاعر واحدا بعد أن كانت موضوعا.
فميخائيل نعيمة ليس الشعر عنده معرفة (أي علما) وليس الشاعر هو الذي يعدد لك الأشياء ويتلاعب بتشبيهاتها، ويقول لك ما هو ذلك الشيء بل الشعر عنده قبسة من نور الوجود ورشفة من محيط الحياة وحبل سري موصول بمشيمة الكون، يحس من خلاله قارئ شعره بإنسانيته تفيض على الوجود وبأخوته حتى للدودة وقد خاطبها مرة في إحدى قصائده بـ “ياأختاه”.
ومازلت أذكر أيام الصبا وأيام الدراسة الابتدائية حين كنا تلامذة في الصفوف الابتدائية كيف كنا نحفظ قصيدته “لست أخشى” ونرددها في الأزقة بل ويرددها كل لنفسه وأنا واحد منهم.
كيف استطاع هذا الرجل أن ينفذ إلى قلب الطفولة العميق الغامض وإلى نفسها العجيبة المتقلبة، فتأبى الطفولة أن تنسى تلك القصيدة التي منها هذه الأبيات:
سقـف بيتي حـديد
ركن بيتي حجــر
فاعصفي يا رياح
وانتحـب يا شجـر
واسبحي يا غيـوم
واهطلي بالمطـر
واقصفي يا رعــود
لست أخشى خطر
من سراجي الضئيل
أستـمد البـصر
كلما الليل طال
والظلام انتــشر
وإذا الفـجر مات
والنهار انتحـر
فاختــفي يا نجوم
وانطفئ يـا قمـر
باب قلبـي حصــين
من صنـوف الكدر
وازحفي يا نحوس
بالشقا والضــجــر
لست أخشى العذاب
لسـت أخـشى الضرر
وحلـيفي القـضاء
ورفيقي القـدر
وقد استخدم الشاعر مجزوء المتدارك، والشاعر معروف باستخدامه الأبحر النادرة لأنها تحقق مأربه في التجديد.
فلما كبرنا واتسعت مداركنا ودرسنا نظريات الفن والشعر، وألممنا بالمذاهب الأدبية وبمستويات الدلالة وحفظنا عشرات القصائد القديمة والمحدثة، أدركنا ما في هذه القصيدة من جمال فني، ففي عهد الطفولة الغض فهمنا مظاهر الطبيعة على حقيقتها المطر، الليل، الفجر، القمر، ركن البيت، سقف البيت، وهذه الدلالات تناسب عهد الطفولة، وأما دلالاتها الأخرى فهي فلسفية عميقة إنها الحلولية الكونية، حيث تتماهى ذات الشاعر مع الموجودات الموحدة في كثرتها فتستمد من ذلك الوجود السكينة، والوداعة والرضا بالقدر وتتنعم بإنسانيتها الواعية الخلاقة بلا كبرياء أو جبروت زائف، إنها النهر يجري منسابا ثابت الخطى إلى مصب الوجود العظيم.
لهذا نفهم لماذا أعرض ميخائيل نعيمة عن الزواج والنسل والإغراق في المتع الحسية وتعبد في “الشخروب”، فلقد وجد هناك بهجة الروح وسلوى الخاطر وتناغمت خفقات قلبه مع حفيف الشجر وانسجمت أنفاسه مع خرير الماء وجاء شعره تعبيرا عن هذا الموقف الفذ والحالة الإنسانية الفريدة التي أضافت إلى شعرنا ما كان ينقصه وسدت ثغرة كان من حق الغير أن يعتبرها مثلبة ونقيصة في أدبنا، فتحية إلى ناسك “الشخروب” في رقدته الأبدية، ولنا في شعره الغذاء للروح والفرح الطفولي والموقف الصوفي النبيل.