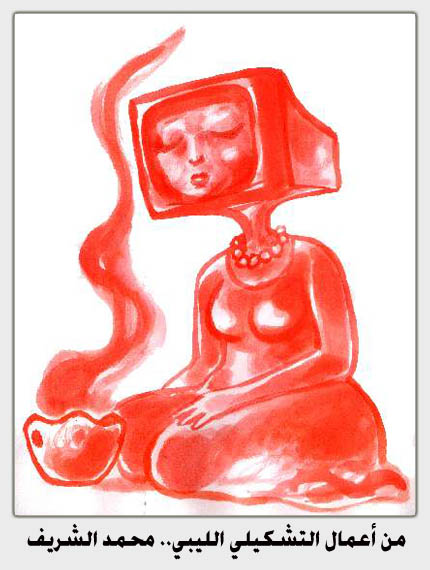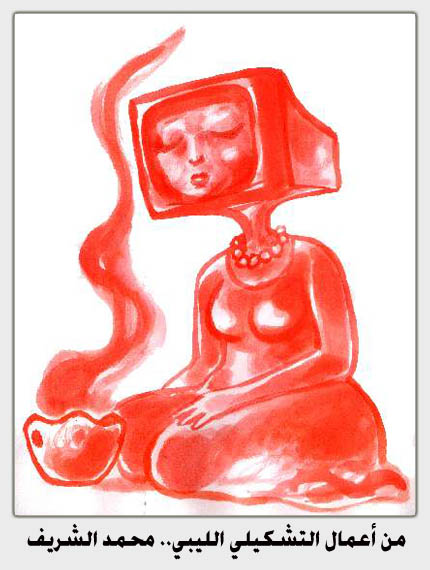نجوى وهيبة
هي أطول مدةٍ أمضيها بعيدة عن بيتنا وأمي وأبي منذُ ولادتي وحتى الآن، اليوم تمُر مائة يوم بعيدة أنا عن بيتنا، بعيدةٌ عن شارعٍ كل من فيه يعرفني ابنةَ من وشقيقةَ من وكم عمري، وقد كان بعض الجيران أيضاً يعرفون حتى متى أخرجُ ومتى أعود كل يوم وربما أشياء أخرى.
لستُ أتحدث هنا في سياق الشكوى والسخرية من مراقبتهم، فهي عاداتٌ وبيئةٌ متكاملة كنتُ أنا نفسي جزءاً منها، أراقب الجار الذي يراقبني حتى إذا غاب عن مراقبتي افترضتُ أن هناك خطباً ما، وأراقبُ أنا أيضاً؛ لأنني جزءٌ من كل شيء في ذلك المجتمع ولو لم يُعجبنِ في بعض الأشياء.
أما هنا فلا جيران يعرفونك أو يعرفون اسمك، لا أحد يلاحظ غيابك أو اختفاءك حتى لو متّ في فراشك، باستثناء مكان عملك؛ ليس لأهميتك كشخصٍ بقدر أهمية ما تُنجزُه من عمل.
أنسى نفسي أحياناً وأنا شاردةٌ وسط هذه المدينة الجديدة المزدحمة بأناسٍ من كل الملل والأعراق، فأجدني أتفرّج على سلوك الناس وأراقبُهم، ليس فضولاً ولا تدخلاً، بل هي عادات التجمعات البشرية الاجتماعيّة التي تتسمُ بالتواصل والارتباط الشديدين. في طرابلس بدأت هذه السمات تتغير عن قبل وتدخل عليها سمات الحداثة وانزواء الناس عن بعضها وتقديس الخصوصية، ونظراً لعدم توفر الظروف الملائمة لم تتحول تلك السمات تماماً كما حدث في دولٍ أخرى، لذلك ربما مازلتُ أنا أحملها في داخلي.
تغيرت من حولي أشياء كثيرة خلال المائة اليوم، وكم مضى من قبل مئات الايام دون ان يتغير فيّ شيء. أحدُ هذه التغيرات تعريفي لنفسي لدى سؤال الناس لي: من أنتِ؟
في طرابلس كنت عندما أعرّفُ بنفسي أكتفي باسمي واسم عائلتي، وإن تطلب الأمرُ عمري ومهنتي أو الكلية التي درستُ بها، أذكر الحي الذي يقعُ فيه بيتنا لكي يحدد من هو قبالتي فئتي الاجتماعية ووضعي المادي حسب المنطقة التي أنا منها.
أما هنا فهُويتي هي اسمي دون الحاجة لاسم عائلتي لأنه لن يضيف شيئاً لتحديد من أنا، هُنا يسألون عن جنسيّتي ومهنتي ومع أي جهةٍ أعمل ومنذ متى حللتُ على البلاد، ومع من أقيم، كم عُمري وهل لديّ سيارة.
تتغيرُ زوايا نظرة الناس لنا، وكنتيجة لذلك يصيرُ تركيزك على هذه الزوايا أكبر. جعلتني تخميناتُ بعض الناس في جنسيات كنتُ أعتقد أنني لا أشبهها، أعيد النظر إلى ملامح وجهي بشكل مختلف، فلاحظتُ أنّ ملامحي تطرح أكثر من احتمال عن هويتي، برغم أنها من قبل نادراً ما شكلت متغيراً فارقاً في هويتي.
دققتُ في ذوقي واختياري للثياب، لماذا أحب أن أرتدي هذه الألوان وهذا النمط من الأحذية؟ لماذا لا أحب المزهّر برغم أني عندما أراه في متجر ما يتحمسُ داخلي له وأتخيّله على قوامي جميلاً ومشرقاً يجعل سمار بشرتي زاهياً.. لماذا لم أكن أرتديه من قبل؟ فأتذكرُ نظرات أبناء الجيران في شارعنا، والطقسَ في مدينتي، وشكل الشوارع، وحكم الناس علينا من ثيابنا. تعرقل الثيابُ سيرنا أحياناً ليس لطول الفستان الذي قد تتعثر خطواتنا به، بل هي نظرات الناس وهمسُهم وتوبيخُهم وتحرشهم هو ما يعرقلنا ويربكنا.
بعد مغادرتي لطرابلس واستقراري في مدينتي الجديدة الذي لا أعرف بعد إن كان سيطُول أم يقصر، صار الناس يُخمنون جنسيتي بناء على مايرونه ويستمعون إليه مني، فإذا لم يعرفُوا من أين أنا، مارستُ عليهم لعبة الاحتمالات ليعرفوا وطني من موقعه أو من حدوده أو من شيء ما يميزنا، وإن عجزوا عن حلّ الأحجية ألقّنهم درساً في الجغرافيا وحدود الدول العربية وكيف أن التاريخ يضيعُ عندما لايدرك الناس بديهيات الجغرافيا في منطقتهم، ألقنهم هذه الدروس بشكل مرحٍ وظريف ، فأتورط أحياناً في سؤال أحدهم: “لماذا يتقاتل الناس في ليبيا؟”.
يخطرُ ببالي بعض الرفاق من العراق أو فلسطين في زمن ليس ببعيد، كيف كنتُ أتعاطفُ معهم؛ لأن الناس لا يسألون شيئاً سوى عن الحرب وموقفهم من صدام “ألم تكن البلادُ أفضل عندما كان؟”… يسألوننا دون أن يلاحظوا كم سئمنا من الحديث عن الحرب، دون أن يلاحظوا أننا لا نريد التورط في أي إجابة، يحاسبُوننا وكأننا نحن جلبنا دكتاتوراً أو كأننا نحن أزحناه حقاً وحدنا!
لماذا لا يسألون الدول الأخرى التي لا حروب فيها عن معدلات البطالة والفقر والإقصاء والأمهات العازبات وأوضاع السجون، أليس هذا أيضاً أمراً مؤسفاً حقاً ومثيراً للاهتمام؟
وتعلّمتُ خلال وحدتي ونومي واستيقاظي وحيدة مشوّشة مذعورة خاصة في أيامي الأولى، أنّ الأحلام التي نراها ليلا ليست هي التي تحتاج لمفسّر أحلام، بل هي التفسيرُ ذاته والانعكاسُ لكل الأفكار التي نؤجلها نهاراً أو لا نجد وقتاً للتحدث فيها مع أحدهم، كثيراً ما بدّدت الأحلام الجميلةُ ليلاً ضعفي وخوفي ومنحتني قوةً وصلابةً لأواجه مخاوفي وقلقي، حد رغبتي في عدم الاستيقاظ منها.
تأتي الأحلامُ ليلاً لتلخّص أشواقنا لمن نُحب، وخوفنا من القادم؛ من أن تخفق مخططاتنا المؤقتة التي رسمناها على ورق مرقّع هش كالورق المبلل المتماسك بشكل مُرهف.
إنّ الهواتف والإنترنت ينقلان الكلام والصوت والصور صحيح، لكنّهما لا ينقلان من المشاعر والأشواق سوى القليل.
اكتشفتُ بعد وصولي هنا مدى قدرتي على تكوين صداقات، وعلى المحافظة على هذه الصداقات، مدى قدرتي على اللهو والمرح مع أشخاص مختلفين تماماً عني، بالاستقرار في مكان جديد ووسط جديد تتضح قابليّتنا للانسجام والقبول من عدمها، هذا إلى جانب اكتشاف قدرتنا على الانسجام دون ذوبانٍ في زحام الاختلاف، دون أن نسمح لما نحمله من قيم بأن يتشوه أو لهويتنا بأن تذوب وسط الجموع.
تصوّر أنك عندما تبدأ العملَ في مكان جديد في مدينة جديدة بمعارف جدد، ستضطرُ لمعاودة بناء كل شبكات الثقة والمصالح والحذر التي بنيتها لسنوات، تعاود تحديد الشخصية الطيبة والليئمة والساذجة، والذكية التي ينبغي الاعتماد عليها في العمل فقط، والأخرى التي تصلُح للمرح فقط، والمُتعِب أن تحديد هذه التعريفات والتحالفات قد يحتاج صبرا ووقتاً.
تدخل لمكان عملك نهاراً وتخرجُ لتجد المصابيح مفتوحة والعتمة قد حلّت والشمس فاتتكَ، شعور متناقض بين الرضا والسعادة أن يومك مضى وقد أنتجتَ شيئاً وعملتَ بكد وتعلّمت شيئاً، وبين خوفك من الانغماس في العمل حد البلادة.
وقد يغبطك كثيرون على سفرك، وآخرون يعيبون عليك ذلك ويعدّونه فراراً، وبعضهم يعيب عليك لشوقه وحاجته لك، وفي كل الأحوال، تُعلّمك التجربةُ أن أحداً لن يشعر حقاً بما تشعر به لذلك ليس عليك تحمل عناء التبرير والشرح طالما أنّ في داخلك شعور بالرضا لما أقدمتَ عليه.
لا كلام يكفي هُنا لتلخيص الاحاسيس الوليدة، وقد يكون من السهل هُنا إحصاء الأيام، أما المشاعر فنحتاجُ مئات الايام الأخرى لكي نبوح بها كما هي.. ربما نلتقي بعد مائتي يوم في بوح آخر.
______________
نشر بموقع ليبيا المستقبل