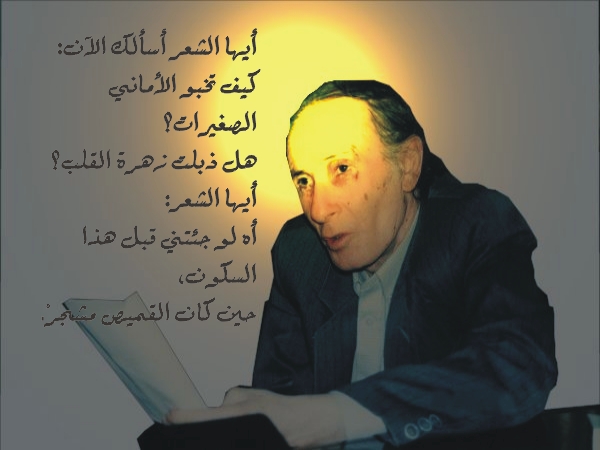عن التعلق بالأمكنة يشير علماء النفس إلى أن الأنسان بطبعه الذي يميل إلى عشق مرابع صباه وطفولته لا يحب تلك الأمكنة لذاتها أو لكونها حجارة صماء لا روح فيها بل لذكرياته الجميلة التي تشكلت في أحضانها، فهنا جلس صحبة رفاقه وهنا طالما تناول طعامه وهنا نام وهنا وقع وهو يركض مشاكسا ومشاركا أترابه اللعب ووراء هذا السور لطالما اختبأ عن أعين رفاقه، ويحب الأنسان هذه الأماكن على بساطتها أحيانا، كأن تكون كوخاً أو حجرة مبنية بالطين والقش، لأنها احتضنت في فضاءاتها أُناس يحبهم ويكن لهم مشاعر ود عارمة مثل والديه وإخوته وجيرانه ورِفاق طفولته، وإذا ما خلت الأمكنة من هذين الشرطين الضروريين وهما الذكريات والاحباب أضحت أمكنة عادية لا يوليها المرء أي اهتمام أو عناية ولا تُمثل لهُ شيئاً يُذكر، وثمةّ من يخشى زيارة أمكنة طفولته فقط حتى لا تُثير شجنه وتوقظ أحزانه باعتبار أن أعز من عاش فيها وسكنها قد رحل إلى غير عودة، وأن الزمن الأول لا يمكن استعادته، وبالمقابل يمقت الإنسان تلك الأمكنة التي عاش بداخلها وكانت شاهدة على عذاباته وآلامه مثل المعتقلات والسجون وحتى المستشفيات.
ولا شك في أنَّ الأمكنة في الأدب عامة وفي القصة تحديداً تُلقي بظلالها على النص ولا يكاد يخلو نص سردي من مكان يتم التركيز علي رسمه بوضوح ووصف تفاصيله بعناية وتبيان معالمه، وقليلة هي القصص والروايات التي تدور في الفراغ ولا تحتوي على أمكنة واقعية أو متخيلة أو تدور أحداثها في أمكنة ضبابية غير متجسدة بوضوح لضرورة فنية كما في السرد الذي ينتمي إلى تيارات الحداثة وما بعد الحداثة الذي تخلى عن الاشتراطات التقليدية للسرد، أو لقصور في البناء السردي، ومثلما تم تفتيت الزمن في البناء الحديث والعبث به وتجزئته وكسر تراتبيته ثم العبث بالأمكنة، فلا نكاد نتبين المكان وإنما نقرأ إشارات وتلميحات عنهُ، هذا فيما يخص السرد التجريبي الحديث، ويكاد يُشكل المكان مع الزمان كل قوام القصة أو الرواية بالإضافة إلى الأحداث والوقائع والشخصيات بطبيعة الحال، وأحياناً يأخذ المكان دور البطولة في المتن الحكائي ويتفوق على الزمان والشخوص والاحداث، ولطالما كان المكان أحد أهم المداخل إلى تحليل أو نقد أي أثر سردي ومفتاح مهم لفهم العمل وتفكيك شيفراته بغاية الوقوف عل مراميه ومحمولاته الفنية المختلفة.
وتتسلل الأمكنة إلى الشعر الذي لم ينجو بدوره من تأثيراته الكبيرة في رسم النصوص واجتراح القول الشعري وخطّ الخطاب، واتخذ هذا التوظيف للمكان أشكالاً عدة فأحياناً تكون القصيدة – لاسيما في الشعر العربي القديم – مكرسة بالكامل لمكان محدد عاشَ فيه الشاعر مثل مضارب القبيلة أو قصور الملوك والأمراء، القائِمة والدارِسة والحدائق والبساتين الملحقة بها، وتارة يكون المكان هو الصحراء بكامل اتساعها وتجلياتها اللا متناهية وتشابه مظاهرها، وتارة أُخرى هو مكان الحبيب، أو بقعة لقاء المعشوق ومطارح الغرام حتى أن بعض الشعراء عدَّ الثرى الذي تسير عليه الحبيبة تراب مقدس ومكان مُبجل.
أما في الشعر الحديث فقد توسع الشعراء في توظيف واستلهام الأمكنة وذهبوا بها إلى مناحي لم تكن مُتاحة في السابق وتم ربطها بتوجهات شعرهم الجديد الذي يطبعه الاحتجاج والتمرد وعدم الكف عن طرح أو نزف الأسئلة مع كل خطوة، من هنا تحدث السياب مثلاً عن عراقه وعن مسقط رأسه قرية جيكور في قصائده بكثير من الحب والاحتفاء والتطلع لحياة أفضل له ولأبناء وطنه، وكذلك فعل نزار مع دمشقه القديمة ببيوتها ذات الطراز العربي العتيق بأزهارها وشجيراتها ونوافيرها التي تتوسط باحاتها الواسعة والتي لا تكف عن اجتراح الخرير والرقرقة ببداياته الرومانسية قبل أن ينعرج نحو هجائياته للأنظمة العربية المتخاذلة ويكاد يتفرغ للشعر الحسي والتغني بالأنوثة في أشكالها المتعددة، أما شعراء الأرض المحتلة فلهم قصة طويلة لا تكاد تنتهي مع الأمكنة باعتبارها أمكنة مفقودة وهي المعادل للذكريات والعيش الهنيِّ قبل التهجير القسري، بل أنها المعادل الموضوعي للحياة برمتها ومبرر الوجود بالنسبة لهم، ومن المهجرين من لا يزال يحتفظ بمفتاح بيته حتى الآن رغم أن أثره انمحى من الخارطة.
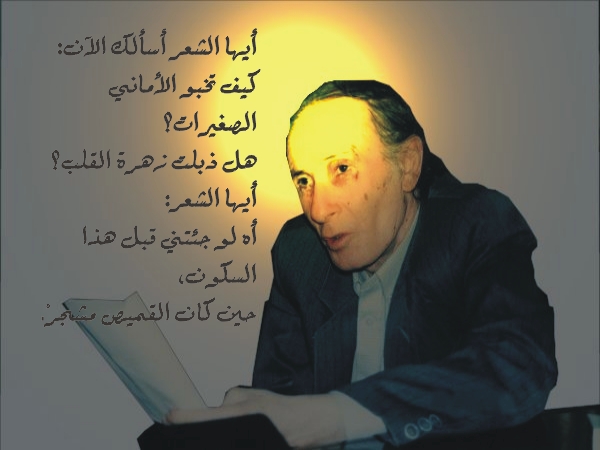
وكذلك فعل الكثير من الشعراء اللاحقون كفعلهم فخلَّدوا أماكنهم الحميمة واستدرجوها إلى قصائدهم، وفيما زادها الشعر حضوراً ووضوحاً ورسوخاً في الذاكرة الجمعية، زادتهُ هي جمالاً وأضفت عليه مسحة صوفية غامرة وأهمية استثنائية وإن كان الشاعر لا يألف مكانا بطبعه القلق والمتمرد، لذلك نجده كما الفراشة في خفة يتنقل من زهرة إلى أُخرى فلا يكاد يستقر ببقعة حتى يغادرها إلى غيرها وذلك قبل أن تخبو شعلة الحب واللمعان والدهشة التي يحملها لها في قلبه ووجدانه كي تظل فتية ومتألقة، ولهذا فهو يحتفظ بذكرى عن كل مكان أقامَ فيه، وهذا ما فعله شاعرنا “جيلاني طريبشان” حينما واتتهُ الفرصة وسمحت لهُ الظروف فأخذ يتنقل من عاصمة إلى عاصمة ومن مدينة إلى غيرها، ولا شك في أنَّ تجربة السفر والترحال تلك، والاغتراب المكاني الذي يبدو أن الشاعر سعى إليه وطلبه كما لو انهُ يهرب من شيء لا مرئي يلاحقه، قد أرهف ملكته الشعرية ورقق ذائقته وشحذ قوله إلى الحد الذي جعله وكنوع من رد الجميل لا يتأخر في استحضار بعض الأمكنة التي احتضنته بكثير من الحنين والرهافة، فعل ذلك في ديوانه ” ابتهال إلى السيدة نون ” الصادر عن الدار الجماهيرية للنسر والتوزيع والإعلان عام 1999 مع الأمكنة التي زارها وأقامَ بها أو عبرها ذات نزوة، كما فعله مع أمكنة وعواصم ومدن أخرى لم تطأها قدماه، بيدَ أنهُ وطأها بقلبه وحلق في أجواءها بجناحي خياله وبشعره، حيثُ افتتح ديوانه بقصيدة ” عن البرنامج اليومي ” التي تتضمن أكثر من مكان أثير استطاع الشاعر أن يستنطقه شعرياً، تبدأ القصيدة بالجُملة التي تُحيل إلى الماضي، كنا خمسة في باريس، وباريس هي الإطار هنا، ثم ينقلنا الشاعر فوق متن شعره إلى أمكنة أخرى، فهو ينشد في ذات القصيدة:
من الباص الهابط من مونمارتر
يفاجئني الأفريقي الهارب من تطوان
يبيع الصمت وأردية النسوة والعادات السمجة.
وغني عن التعريف أن مونمارتر هو عبارة عن شارع أو جادة في باريس الذي زارها الشاعر وانطبعت ملامحها في ذهنه بينما تطوان هي مدين مغربية لا يمتلك الشاعر إلا أن يعشقها كسائر مدن المغرب.
ثم يستطرد الشاعر:
في الشانزليزيه، تصحبني إيزابيل إلى المطعم، لنلاحظ هنا ارتباط الأمكنة بالذكريات التي اختبرها وعاشها الشاعر والقصيدة تمتح من المخزون الشخصي والأرشيف الذاتي، مع العلم بأن الشانزليزيه هو ميدان أو شارع باريسي شهير يبدو أن الشاعر عبره ذاتَ تيه بأقدام الدهشة.
ليواصل بعد ذلك:
أقتات بباقات الورد
وألتهم شطيرة الأوعال
في اللوفر
أعتق ناقات زياد
وأبيع قصائد طرفة بن العبد
وأكتب شعراً في تواليت الصمت
ولنلاحظ هنا أيضا تلك المقارنة المباشرة والربط المتعمد ما بين أكثر الأماكن حداثة وما بين البداوة أو الصحراء الذي جاءَ ذكرها ضمنياً، وما اللوفر أن لم يكن متحف الفن قديمه وحديثه والمكان العصري الذي يمثل آخر ما يمكن تخيله لأمكنة الحاضر أو حتى المستقبل.
ويستمر الشاعر في هذه القصيدة الافتتاحية في سرد تفاصيل يومه الباريسي شعرا فيقول:
أقفل باب الغرفة
أطفئ تبغ الفجر
على منضدة من وجدة
والغرفة في هذه القصيدة مكان أو ملاذ، واستحضار مدينة وجدة المغربية بهذا الشكل إلى متن القصيدة يشكل ملاذا أوسع، وما من أحداً مهما أوتيَ من مهارة يستطيع أن يقنعنا بأن الاستحضار هنا لم يكن مقصوداً وأن الشاعر لا يحتفظ للمغرب ككل ولمدنه بمكانة خاصة في نفسه وأنه لا يعشق هذا البلد، وإلا لما استدعاه كلما سنحت له الفرصة وكأنهُ إذا ما عنَّ لهُ استدعاء مكان لم يجد أمامه إلا المغرب بتنوعه وزخمه.
وتعبق القصيدة ” من قصيدة لم تكتمل لسعدي يوسف ” برائحة الأمكنة وتكتظ بأكثر من عاصمة وبلد بعضها لم يزرها الشاعر وبعضها كان مجالاً لعبوره الهائل بنعال الريح وصوتاً لخطاه الواسعة، حيثُ نجد في البدء العراق ثم مصر مختزلة في القاهرة ثم اليمن ثم بيروت في قصيدة رثائية تنبؤية تتكهن بمصير العواصم العربية الآخذ في الانحدار نحو الهاوية في ظل التشرذم العربي والضعف والهوان، وتختتم هذه القصيدة بأماكن أثيرة وعزيزة على قلوب الشعراء العرب وباعثة على قرض الشعر ورصف القوافي، ولكي يحتفظوا بها طازجة ومُشعة وموحية على الدوام قاموا بإيداعها في أشعارهم المختلفة، ونقصد بهذه الأمكنة التي اختزلتها الأديبة غادة السمان في عبارتها ” العمر حقيبة سفر “، ردهات المطارات وصالات الانتظار الواقعة على تخوم الدول، فها هو الشاعر مخاطِباً سعدي يوسف صديقه ونظيره الاغتراب وشبيهه في القلق والتيه، وفيما يشبه التنديد بعوامل التفرقة والتشتت يقول:
صار بيني وبينك تذكرة للمرور
وجواز سفر
غير أني تذكرت في ردهات المطارات
أن قلبي حجر
أن روحي ملطخة بالأسى
فمتى يا رفيق الضياع
تنبت الأجنحة.
ودعونا لا نغفل عن التعبير القاسي والجارح الذي يبدو وكأنهُ حُفِرَ حفراً بمسمار على الجلد ولم يُكتب على ورقة في جُملة ” ملطخة بالأسى ” فالأسى هنا أكبر من أن يكون حزناً والتياع عابر فهو لطخة قد لا تزول ولا ينمحي أثرها، مثلها مثل لطخة العار أو لطخة الخيانة، وإلى أن تنبت الأجنحة يظل الشاعر يقاسي غربته ويأسه المتوارث.
ويكاد الشاعر أن يُفرد قصيدة كاملة للتغني بالأمكنة الواقعة في الأندلس حين يُنشئ قائِلاً، وهو يقصد أحد القصور الملكية التي كانت عامرة بأطايب الطعام والموسيقى والجواري فها هو ذا يقول:
لن ترى قرطبة
لن ترى الغوطة
لا الحمامات لا بهو السفراء
لن ترى الأندلس
لن ترى المِئذنة
لن ترى الأسد في ساحة الخيلاء يُزاحمهن الغواني
لن ترى الوادي ولا القنطرة
لن ترى الورد يهبط من شرفات الغرام.
ويُشار إلى أنَّ الشاعر كانَ في سبعينيات القرن الماضي قد زار إسبانيا ضمن وفد شبابي ليبي ورأى هذه الأماكن الأثرية التي يتحدث عنها رُأي العين ويظهر تأثيرها عليه واضحاً سيما وأنهُ لا يزال يحفظها ويحفظ أسماءها عن ظهرِ قلب وكأنه زارها بالأمس فقط رغم مرور سنوات عديدة لأن القصيدة كُتبت في الرجبان عام 1992.
مقهى زرياب وسقالة الحلفة بطرابلس ومقهى خان مرجان ببغداد ومقهى صالة الشاي بالقاهرة وبيت الأقنان التي خصهُ السياب بقصيدة مشهورة ونخل الرميثة وهي منطقة ريفية عراقية وساحة البرج وجامع القرويين ودمشق وأعالي جبال الجزائر أو جبال الأوراس وخان السري الذي يؤمه الفقراء من البحارة والعمال بطرابلس القديمة كلها أماكن تخللت القصائد وسكنتها، ذلك لأن الشاعر أحبها ولم يستطع نسيانها بعد زيارته لها، وهو كالمأخوذ بحميميتها وجمالها ودفئها لا يملك إلا أن يضمنها في قصائده سواء وعى ذلك أو لم يعيه، ولأن الشاعر يرى الأماكن من منظور خاص لا يشاركه فيه العامة تظل حاضرة في نفسه متغلغلة في ذاته عصية عن النسيان والانمحاء والسر في هذه النظرة هو أن الشاعر يعيش الشعر على الدوام ولا يقتصر احتكاكه بالشعر على وقت كتابته أو تلقيه بل ان الشاعر يبدو شاعراً على طول الخط سواء كتبه أو لم يكتبه لأنه يفسر الأشياء من حوله بل الحياة برمتها تفسيرا شعرياً ويراها كما لا يراها الآخرون ففي حين يمر الآخرين على بعض الأمور والأحداث مروراً عابراً ولا تلفت انتباههم، تشد انتباه الشاعر وتغير مساره وتجعله عُرضة لعواصف الأفكار والصور التي تجتاحه على حين غفلة ولا يكون مستعدا لاستقبالها أحيانا، إلى هذا الحد تبدو القصائد غنية وغزيرة بالأمكنة التي تتهاطل من سماء النصوص وكأن الشاعر يكتب وهو يمشي مستعجلاً وما أراد تخليده وإدخاله لدائرة الحضور والقفز بهِ خارج خط النسيان كتبهُ في قصيدة واحتواه في شعره.
ويبدو من خلال شهادة صديقه الحميم الذي قامَ بتأليف كتاب عنهُ بعد وفاته أن للشاعر حكاية طويلة مع الأمكنة فها هو الكاتب الأريتيري الذي أقام في ليبيا سنوات طويلة يشير في كتابه (جيلاني طريبشان.. القصيدة الإنسان)، إلى الافتتان بالأمكنة حينما يسرد علينا مروره صحبة الشاعر أمام بعض البيوت التي سكنت ذاكرته مثلما سكنها صغيراً في مقتبل العمر في كل من المدينة القديمة بطرابلس ومنطقة بلخير وزاوية الدهماني، وتحدثَ عن تلك الفرصة التي لم تُتاح لزيارة بيت آخر يقع بمنطقة الهضبة الخضراء بطرابلس، وأشار إلى مقهى زرياب ومقر صحيفة الأسبوع الثقافي وفندق بشارع البلدية والكُتَّاب الذي تلقى فيه تعليمه مبكراً بمدينة الرجبان التي قصدها الشاعر أواخر حياته وتوفيَ فيها ودُفِنَ في ثراها، إلى هذا الحد وأكثر بلغ افتتان الشاعر بالأمكنة الحميمية التي ربما بمروره عليها استعاد بعضاً من تلك الأزمان الجميلة التي قضاها فيها واستعاد بعضا من توازنه النفسي الذي فقده في عالم يسير باتجاه التوحش واللا إنسانية بسرعة قصوى ولا يتلاءم ورهافة الشاعر وحساسيته المفرطة.
وهنا لن نغفل عن أن نشير إلى أن الشاعر مثلما حرَصَ على تأريخ قصائده في هذا الديوان، حرص كذلك على تذييلها بأماكن كتابتها أو ولادتها، ولهذا ظلت الأمكنة تنوس ما بين الرجبان مسقط الرأس وطرابلس وبغداد والرباط والدار البيضاء وأثينا بل ان بعض القصائد كُتبت بأكثر من مكان وكأنها تُحاكي قلق وتنقل كاتبها الذي يبدو كما لو أن الريح تحته. كثيرة هي الأمكنة الواردة بأشعار “جيلاني طريبشان” الذي نكتفي بهذا القدر من الاستشهاد بقصائده على أن يعود إليها في الديوان المذكور كل من ابتغى تعدادها وقراءتها على وقع هذه الإضاءة، وتظل الأمكنة قادرة على استنطاق الشاعر – أي شاعر – الذي هو وبخلاف الأشخاص العاديين نظراً لحساسيته العالية تجاه الأشياء لا بد أن تمثل له الأمكنة قيمة خاصة تحفزه وتثيره شعرياً على الدوام.